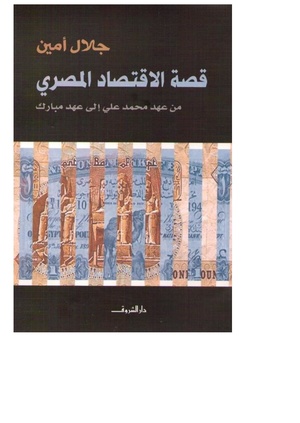التاريخ الاقتصادي لمصر
يعتبر اقتصاد مصر من أكثر اقتصاديات تنوعا في منطقة الشرق الأوسط، حيث تساهم قطاعات السياحة والزراعة والصناعة والخدمات بنسب شبه متساوية في الناتج القومى. ونتيجة لمراحل الإصلاح الهيكلى الذى يطبق الجيل الثالث منه حالياً، فإن اقتصاد مصر يحقق نمواً بنسب متزايدة مستنداً إلى مناخ جاذب للإستثمار من حيث البيئة التشريعية والسياسية الملائمة، والاستقرار الداخلى وتحرير التجارة والسوق، وما تمتلكه مصر من بنية اساسية قوية للنقل والمواصلات والاتصالات ومصادر الطاقة، والأيدى العاملة الماهرة، والمدن الصناعية الحديثة، والمناطق الحرة، والنظام المصرفي، وسوق الأوراق المالية. [1]
الإقتصاد المصري القديم
 مقالة مفصلة: الاقتصاد المصري القديم
مقالة مفصلة: الاقتصاد المصري القديم
كان الاقتصاد في مصر القديمة يعد اقتصاد دولة ، حيث كانت الدولة أو مؤسسات المعابد هي المسئولة عن تلقى المنتجات وتوزيعها بعد ذلك على الشعب حسب الحاجة. وفى العصر اليوناني الروماني، أهتم البطالمة بزيادة إنتاج وجودة الصناعات المصرية. أما المسلمون فقد اعتمدوا على التصدير للبلاد الأخرى، وقد ركزوا بصفة خاصة على تجارة التوابل. [2]
كانت المنتجات في مصر القديمة تسلم إلي مؤسسات الدولة أو المعابد ؛ والتي كانت بدورها تقوم بتوزيع الطعام والبضائع التموينية الأخرى على السكان.
الإقتصاد اليوناني الروماني
 مقالة مفصلة: الاقتصاد اليوناني الروماني
مقالة مفصلة: الاقتصاد اليوناني الروماني
أنشأ البطالمة المصانع، واشرفوا على إنتاج وبيع المنتجات الرئيسية. كما عملوا على تحسين المنتجات المصرية، التى أصبحت مطلوبة في الأسواق.
الإقتصاد في العصر الإسلامي
 مقالة مفصلة: الإقتصاد في العصر الإسلامي
مقالة مفصلة: الإقتصاد في العصر الإسلامي
كان لتجارة المنسوجات والتوابل دوراً مباشراً في الإقتصاد المصرى خلال العصر الإسلامي.
محمد علي: 1805–1848
 مقالات مفصلة: التجارة في عصر محمد علي
مقالات مفصلة: التجارة في عصر محمد علي- الصناعة في عصر محمد علي
اتسع نطاق تجارة مصر الخارجية في عهد محمد علي باشا لازدياد حاصلاتها وخاصة القطن، وقد ربحت الحكومة منها ارباحا وفيرة لانها كانت تحتكر التجارة الخارجية باجمعها.
وقد ساعد انشاء الاسطول في البحر الاحمر والبحر الابيض المتوسط على توسيع نطاق المواصلات البحرية بين مصر والبلدان الاخرى، وكان لاصلاح ميناء الاسكندرية فضل كبير في هذا الصدد، فنشطت التجارة الخارجية نشاطا عظيما، ومنذ انشئ اسطول مصر في البحر الاحمر فكر محمد علي في اعادة طريق التجارة بين الهند واوروبا عن طريق مصر عبد ان تعطلت زمنا طويلا لاكتشاف طريق راس الرجاء الصالح، فبسط سيادة مصر في البحر الاحمر وطهره من القرصان الذين كانوا يتهددون السفن التجارية فيه، ومد طريقا لسير قوافل التجارة بين السويس والقاهرة وانشا به المحطات وبسط الامن في مراحله لتامين القوافل على متاجرها، وانشا لذلك ديوانا سمي بديوان المرور كان مقره بالازبكية، وكانت المتاجر القادمة من البحر الاحمر ترسل من السويس الى النيل ثم الى الاسكندرية فاعاد جهد المستطاع سبيل المواصلات القديم بين الشرق واوروبا عن طريق مصر.
وقد لفت هذا الطريق انظار الشركة الهندية الانجليزية وراته امن واقصر من طريق راس الرجاء الصالح وطريق البصرة والفرات وحلب والاسكندرونة، فاتفقت مع الحكومة المصرية على نقل طرود البريد للمسافرين عن طريق السويس وكان المستر توماس واجهورن احد كبار موظفيها واسطة هذا الاتفاق، وقد لقى من محمد علي باشا تعضيدا كبيرا فكانت السفن التجارية تسير من بمباي الى السويس ثم ينتقل منها البريد والسياح الى الاسكندرية عن طريق القاهرة ومن الاسكندرية الى مرسيليا بحرا ومنها الى انجلترا.
التجارة في عصر محمد علي
اتسع نطاق تجارة مصر الخارجية في عهد محمد علي لازدياد حاصلاتها وخاصة القطن، وقد ربحت الحكومة منها ارباحا وفيرة لانها كانت تحتكر التجارة الخارجية باجمعها.[3]
وقد ساعد انشاء الاسطول في البحر الاحمر والبحر الابيض المتوسط على توسيع نطاق المواصلات البحرية بين مصر والبلدان الاخرى، وكان لاصلاح ميناء الاسكندرية فضل كبير في هذا الصدد، فنشطت التجارة الخارجية نشاطا عظيما، ومنذ انشئ اسطول مصر في البحر الاحمر فكر محمد علي في اعادة طريق التجارة بين الهند واوروبا عن طريق مصر عبد ان تعطلت زمنا طويلا لاكتشاف طريق راس الرجاء الصالح، فبسط سيادة مصر في البحر الاحمر وطهره من القرصان الذين كانوا يتهددون السفن التجارية فيه، ومد طريقا لسير قوافل التجارة بين السويس والقاهرة وانشا به المحطات وبسط الامن في مراحله لتامين القوافل على متاجرها، وانشا لذلك ديوانا سمي بديوان المرور كان مقره بالازبكية، وكانت المتاجر القادمة من البحر الاحمر ترسل من السويس الى النيل ثم الى الاسكندرية فاعاد جهد المستطاع سبيل المواصلات القديم بين الشرق واوروبا عن طريق مصر.
وقد لفت هذا الطريق انظار الشركة الهندية الانجليزية وراته امن واقصر من طريق راس الرجاء الصالح وطريق البصرة والفرات وحلب والاسكندرونة، فاتفقت مع الحكومة المصرية على نقل طرود البريد للمسافرين عن طريق السويس وكان المستر توماس واجهورن احد كبار موظفيها واسطة هذا الاتفاق، وقد لقى من محمد علي باشا تعضيدا كبيرا فكانت السفن التجارية تسير من بمباي الى السويس ثم ينتقل منها البريد والسياح الى الاسكندرية عن طريق القاهرة ومن الاسكندرية الى مرسيليا بحرا ومنها الى انجلترا.
الصادرات والواردات
تتالف صادرات مصر في ذلك العهد من القطن، والارز، والحبوب، والصمغ والانسجة الكتانية، والصودا، والتمر، والخضر الجافة، والافيون، والحناء وغير ذلك.
وكانت تستورد من الخارج الانسجة القطنية، والاجواخ، والطرابيش، والانسجة الصوفية، والاثواب الحريرية، والاخشاب، والحديد ، والاواني، والخردوات، والنحاس، والسكاكين، والورق، والعقاقير، واصناف العطارة، والفحم، والقرمز، والسكر، والزجاج، والمرايا، والزيوت، والانبذة، والمشروبات الروحية، وغير ذلك، وأحصى الدكتور كلوت بك تجارة مصر الخارجية مع اوروبا وتركيا سنة 1836 فبلغت بحسب احصائه:
2196000 جنيه للصادرات، و2679000 للواردات.
واورد علي باشا مبارك احصاء عن صادرات وواردات الاسكندرية دون سواها من سنة 1823 إلى سنة 1842 استخلصنا منه البيان الاتي:
| السنة | الصادرات | الواردات (بالجنيه المصري) |
|---|---|---|
| 1823 | 1585764 | 804519 |
| 1842 | 1806880 | 2470920 |
عباس باشا: 1848 – 1854
لا يقف المؤرخون الاقتصاديون عادة وقفة طويلة عند عباس الأول الذي انتقل بمصر من النصف الأول إلى النصف الثاني من القرن الماضي (1848-1854)، إذ لم تشهد مصر في عهده من الأحداث الاقتصادية كثيراً مما يستحق الذكر. فهم لا يكادون يذكرون له إلا إدخال أول خط للسكك الحديدية في مصر، وصل الإسكندرية بكفر الزيات. قد تكون ضآلة أثره وقلة الأحداث في عصره راجعين إلى غرابة أطواره وانطائه وقلة طموحه، فضلاً عن كراهيته للحضارة الأوروبية وللأوروبيين جملة، فلجأ إلى حماية نفسه من تملق قناصل أوروبا وتهديداتهم على السواء، على حد تعبير مؤرخ بريطاني "باتباع سياسة محسوبة ومتعمدة هي أن يبتعد تماماً عن أنظارهم". وقد يكون الأمر على العكس، راجعاً إلى أن الأوروبيين لم يكونوا مستعدين للانقضاض على مصر بعد، فلما تهيأوا لهذا الانقضاض لم يعد الأمر يتحمل والياً بهذا الانطواء، ولم تعد تفلح سياسة "الابتعاد تماماً عن أنظارهم"، وأصبح المطلوب والياً "متفتحاً" يحسن الفرنسية، ويجيد الإنفاق والاقتراض مثل سعيد أو إسماعيل.
وبينما تولى إسماعيل العرش بدلاً من أخيه الذي كان صاحب الحق في العرض، ومات بدوره في ظروف لا تقل غموضاً عن ظروف مقتل عباس، استقبل الأوروبيون إسماعيل بالثناء واستمروا يمجدونه طالما ظل قادراً على الاقتراض وتسديد ديونه، وانهالوا عليه بالنقد والتجريح حتى نجحوا في عزله بمجرد أن توقف عن الدفع.
سعيد باشا: 1854-1863
لم يكن عباس الأول على دراية بلغة أوربية واحدة، ولم ير أوروبا قط في حياته، وطرد الموظفين الأوروبيين من خدمته، ورفض أن يستمع إلى ديليسبس وهو يعرض علي مشروع حفر قناة السويس، بل حاول محاولة يائسة أن يعيد مصر إلى صورة من صور نظام الاحتكار الذي فرضه محمد علي وأجبره الأوروبيون على التخلي عنه.[4]
تأمل الفارق بين عباس الأول وهذه الصورة التي يرسمها مارلو لخليفته سعيد باشا التي تذكرنا بشدة بالسادات:
"كان (سعيد باشا) في أحواله العادية رجلاً طيب المعشر متساهلاً، وإن كان يتعرض أحياناً لنوبات من العنف والغضب الشديد التي تستحيل تهدئتها. كان يكره الرذالة، سواء صدرت من أحد أقربائه أو من بعض القناصل، أو من الباب العالي، أو من قناصي الفرص الباحثين عن الامتيازات، ولكنه كان أيضاً على استعداد دائماً لإنفاق المال كوسيلة للخروج من مأزق.. لم يكن لديه لا الصبر ولا القدرة على أن يعكف على تفاصيل الإدارة والحكم.. كما أنه أزال كل حاجز يقوم بينه وبين أفواج الأوروبيين المتدفقين على بابه، من قناصي الفرص والامتيازات والطفيليين الذين سرعان ما اكتظ بهم قصره.. لم يكن سعير يفتقر إلى الذكاء، فقد كان في معظم المواقف واعياً لأغراض هؤلاء الذين أحاطوا به والتفوا من حوله. ولكنه كان أكثر جبناً من أن يحاول التصدي لضغوط القناصل عليه، وأشد كسلاً وتقاعساً من أن يرفض طلباتهم التي لا تستند إلى أي أساس معقول، كما كان له من طيب المعشر ومن التساهل ما يمنعه من إغضاء هؤلاء الذين تخصصوا في التودد إليه". بينما يروي مؤرخ آخر عن سعيد أنه كثيراً ما كان يوقع ما يقدم إليه من وثائق دون أن يقرأه، بما في ذلك اتفاقية قناة السويس، التي قدمها ديليسبس، بل وحتى دون أن يستشير مستشاريه القانونيين أو الماليين، مرتكزاً إلى أن ديليسبس صديقه ولا يمكن أن يخدعه. لم يمض وقت طويل على اعتلاء سعيد العرش (1854) حتى بدأ يتورط في الديون. فبعد أقل من ثلاث سنوات من بداية حكمه بدأ يتأخر عن دفع مرتبات موظفيه وعن دفع الجزية للسلطان. لجأ سعيد في البداية إلى الاقتراض من بعض البنوك الأوروبية التي كانت قد أنشئت حديثاً في الإسكندرية، ثم استجاب لنصيحة ديلسبس بأن يصدر أذونات على الخزانة، تتراوح مددها بين ستة أشهر وثلاث سنوات، ويتراوح سعر فائدتها بين 15% و18%، بينما كان السعر السائد على القروض التجارية لا يزيد عن 7%. كان سعيد أحياناً يستخدم هذه الأذونات في دفع مرتبات الموظفين، ومن ثم كان يحدث أن يتجمع على أبواب وزارة المالية دائنو الموظفين من الخبازين والجزارين ومن إليهم، ليطالبوا بقيمة الأذونات التي في أيديهم. وإذ لم تكفه القروض المحلية وأذونات الخزانة لجأ سعيد في 1860 لعقد أول قرض خارجي مع أحد المصارف الفرنسية، ولكنه كان قرضاً باسمه لا باسم الحكومة المصرية، قيمته الرسمية 1.2 مليون جنيه استرليني، وبسعر فائدة 6%، ولكن لم يتسلم سعيد من قيمة القرض، بعد خصم العمولات والأتعاب والمصروفات، إلا أقل من ثلاثة أرباعه، وخصصت لضمانه حصيلة جمارك ميناء الإسكندرية. ومع هذا فلم يمض أكثر من عام حتى أصبحت خزانته خاوية من جديد، فلجأ في 1862 إلى عقد أول قرض خارجي تعقده الدولة المصرية في تاريخها الحديث، قدمه لها مصرف أوبناهيم الألماني بمبلغ 2.5 مليون جنيه إسترليني، بسعر فائدة 11% ومضموناً بحصيلة ضريبة الأطيان على أراضي الدلتا. من هذا القرض أيضاً لم يحصل سعيد، بعد خصم العمولات والمصاريف، إلا على 84% من القيمة الاسمية. وكان عليه أن يدفع لسداده عبر ثلاثين عاماً، بعد إضافة الفوائد والرسوم السنوية، 8.2 مليون جنيه، أي نحو أربعة أمثال المبلغ الذي تسلمه بالفعل.
عدما مات سعيد في 1863، كانت مصر إذن مدينة بنحو 8 مليون جنيه إسترليني، مستحقة السداد عبر ثلاثين عاماً، بالإضافة إلى مليون آخر واجب الدفع عبر ثلاث سنوات، وديون قصيرة الأجل تبلغ نحو 9 مليون جنيه. كان إجمالي حجم الدين المصري إذن، عائماً وثابتاً (أي قصر الأجل وطويله)، نحو 18 مليون جنيه عند وفاة سعيد، أو ما يعادل نحو خمسة أمثال إيرادات الحكومة المصرية في السنة السابقة على وفاته. من أين جاء هذا التورط المفاجئ في الديون؟ من المؤكد أنه لا يمكن تفسيره بجهود سعيد في التنمية. فباستثناء بدء العمل في قناة السويس وقيامه بتطهير ترعة المحمودية، واستكمال خط السكك الحديدية من كفر الزيات إلى القاهرة، ومد خط حديدي آخر بين القاهرة والسويس، وكلها مشروعات تخدم التجارة الدولية أكثر مما تزيد القدرة الإنتاجية لبلد، لا يجد المرء في سجل سعيد في تنمية الاقتصاد المصري ما يستحق الذكر. ففي الصناعة لم يضف سعيد مصنعاً واحداً. وكانت مصر عندما تسلم حكمها تصدر 28 ألف قنطار من السكر فتركها وهي تصدر أقل من نصف هذا القدر. وفي الزراعة لم يبذل أي جهد لتطوير نظام الري، وكانت مساحة الأرض المزروعة عند وفاته أقل مما كانت عليه قبل بداية حكمه. أما إطلاق وصف "العصر الذهبي للفلاح" عل عهده، فلم يكن بسبب زيادة الإنتاج أو إنتاجية الفدان، وإنما بسبب تخفيض عبء الضريبة على الفلاح، على حساب إهمال مشروعات الري، وبسبب إعطائه الفلاح حق التصرف في الأرض التي يزرعها بالبيع والرهن والتوريث، الأمر الذي فتح الباب أمام نمو الملكيات الزراعية الكبيرة على حساب الفلاح الصغير الذي كثيراً ما اضطر إلى التنازل عن ملكيته لصالح المرابين من المصريين والأجانب.
وليس بالإمكان أيضاً تفسير مديونية سعيد بزيادة الإنفاق على الحرب والجيش، فلم يعرف عصره حروباً طويلة ولا توسيعاً لرقعة بلاده، بل خفض سعيد حجم جيشه وخفض مدة الخدمة العسكرية ليوجه المجندين لحفر قناة السويس، وأصدر أوامره بالكف عن إصلاح سفن الأسطول، بل وتكسير بعضها وبيعه أخشابها. لم يشترك سعيد إلا في حربين لا ناقة لمصر في أي منهما ولا جمل، حرب القرم لمناصرة السلطان، والتي انتهت على أي حال بعد استلامه الحكم بعامين، وحرب المكسيك لمناصرة صديقه نابليون الثالث، التي أرسل إليها كتيبة صغيرة من السودانيين ولقي معظمهم حتفه.
كان جل مشروعات سعيد في التنمية، إن لم تكن كلها، بنصيحة الأجنب ولخدمتهم، من حفر قناة السويس التي أدى فتحها إلى فقدان مصر لما كان يعود عليها من عوائد من مرور التجارة في وسط الدلتا، إلى مد الخط الحديدي من القاهرة إلى السويس، الذي تم بإلحاح الحكومة الإنجليزية لتسهيل نقل جنودها إلى الهند ولصالح الشركة البريطانية التي تبيع المعدات، والذي سرعان ما أصبح عديم النفع بمجرد فتح قناة السويس وتم هجره نهائياً. وكذلك كان موقفه من التعليم، فبينما كان يغدق الإعانات على مدارس الراهبات الفرنسية وعلى مدرسة إيطالية بالإسكندرية، كان يغلق مدرسة المهندسخانة ببولاق ثم يحولها إلى مدرسة حربية، ويغلق مدرسة الطلب بقصر العيني فترة ويفتها فترة، ويلغي ديوان المدارس (وزارة المعارف). إن معظم مؤرخي عصر سعيد يميلون إلى إلقاء المسئولية عن توريط مصر في الديون في عهده إلى "ما جبل عليه من سخاء وعدم التدقيق في حسابه" وإلى كونه "متلافاً للنقود" على حد قول الرافعي "وكثرة نفقاته على قصوره ومعيشته الخاصة"، والكتب حافلة يذكر تبديده للنقود على أسرة فضية كهربائية بمناسبة زواج ابنه، وعلى أوان للشرب يصفها أحد الكتاب بأنها لابد أن كانت، من فرط ارتفاع سعرها، أواني سحرية تظل مملوءة على الدوام، وعلى استيراده نظارات معظمة بأحجام هائلة من باريس، وتزيين أكتاف ضباطه بالفضة الخالصة، ومده لخط حديدي بين الإسكندرية ومريوط لنزهاته الخاصة... إلخ. على أننا نلاحظ أن هذا الميل إلى إلقاء اللوم على الوالي نفسه كان أشد وضوحاً لدى من كانوا أقرب عهداً به، وأنه كلما مر الزمن وبعد عهدنا بهذه الحقبة، كلما زاد الميل عند المؤرخين إلى رؤية مصر كجزء صغير من العالم، بعلاقاته الاقتصادية والمالية المتشابكة. وإذا بهم يميلون أكثر فأكثر إلى إهمال دور النزعات الشخصية والنفسية، ويبدون اهتماماً أكبر باتجاهات رأس المال الدولي والتطورات الاقتصادية في العالم، الأبعد غوراً والأطول مدى. هكذا نجد مؤرخين اقتصاديين مثل كراوشلي، الذي كان يكتب في الثلاثينيات من القرن العشرين، ولهيطة، الذي كان يكتب في الأربعينيات، لا يكادون يذكرون شيئاً عن مسئولية العوامل الخارجية في توريط مصر في الديون في عهد سعيد، بينما نجد لاندز، الذي كان يكتب في الخمسينيات، ومارلو الذي كتب في السبعينيات، يجعلان محور قصتهما المصالح المالية الأوروبية الكامنة وراء محنة مصر الاقتصادية في ذلك العصر.
أهم بكثير من شخصية سعيد وكونه "متلافاً للنقود" حقيقة كالحقيقة الآتية: وهي أن الفائض السنوي في ميزان المدفوعات البريطاني ظل يتراوح بين 5 و6 مليون جنيه خلال الربع الثاني من القرن التاسع عشر، ثم قفز إلى 6 و7 مليون جنيه خلال السنوات الخمس السابقة على اعتلاء سعيد العرش، ثم تضاعف إلى أكثر من ثلاثة أمثاله خلال السنوات الخمس التالية (1855-1860). هذه الزيادة الكبيرة في الفائض الباحث عن فرص للاستثمار بالخارج يؤيدها ما بدأ يظهر من إعلانات في الجرائد البريطانية لإغراء أصحاب الأموال بفرص الربح المجزية المتاحة أمام الإقراض في بلاد كمصر، فنشرت إحدى الشركات البريطانية إعلاناً في بريطانيا مؤداه أن: "ميدان العمليات المالية ليس له حدود" وأن: "المزارعين والتجار في مصر العليا والسودان يستطيعون أن يقترضوا بسعر 4% و5% في الشهر".
كانت الفرصة التي تتيحها مصر لرأس المال الأوروبي والتجار الأوروبيين في عهد سعيد تتمثل في انفتاح مصر على العالم بعد زوال نظام الاحتكار الذي فرضه محمد علي، ونمو الاقتصاد النقدي، وما أصبح متاحاً لهم من الاتصال المباشر بالفلاحين دون وساطة الوالي. وسرعان ما بدأت البنوك الأوروبية تفتح لها فروعاً في مصر، خاصة في الإسكندرية، لتمويل التجارة الخارجية ورهونات الأراضي ولتقديم القروض للوالي الجديد. كان المرابون والأفاقون من الصيارفة والتجار بد بدأ يسيل لعابهم حتى قبل مقتل عباس الأول، فإذا بهم بمجرد سماع خبر مقتله يتدفقون على مصر بأعداد هائلة، كما لو كانت مصر كاليفورنيا جديدة، فدخل مصر فيما بين عامي 1857 و1861 ما يقرب من 20 ألف أجنبي سنوياً. يصف لاندز الإسكندرية في عهد سعيد بأنها كانت "مدينة قبيحة مليئة بالعشش والمساكن الحقيرة... وفي كل مكان توجد الرائحة الكريهة للقاذورات ومخلفات الإنسان التي تكوم أمام المنازل حتى تملأ الطريق... إن الإسكندرية لم تكن بالمكان الذي يجذب الزائر الحساس القادم من دولة أكثر تحضراً، ولكن الإسكندرية هي البلد الذي فيه المال، وقليلون هم الذين يرغبون في التضحية بجيوبهم بسبب ما تشمه أنوفهم. لم يكن النجاح في الحصول على امتياز من الحكومة المصرية أو في عقد صفقة ما من نصيب الأرخص أو الأسرع في الإنجاز أو الأنسب في شروطه، وإنما كان من نصيب من يعرف الوالي منذ الطفولة، أو من نصيب التاجر الذي يتناول الطعام مع وزير الأشغال العمومية، أو المقاول الذي ينام مع عشيقة الوزير.. أما بالنسبة للموظفين الصغار فقد كانت الرشاوي المكشوفة تؤدي نفس المهمة".
في مناخ كهذا يكاد يستحيل على المرء أن يتصور والياً مهما أوتي من بعد النظر وقوة الإرادة، يستطيع الصمود أمام مختلف أساليب الضغط والإغراء والتهديد، سواء كان تهديداً بسحب التمثيل القنصلي، أو بإثارة المتاعب للوالي لدى السلطان، أو حتى بالتلويح بالهجوم العسكري، اللهم إلا إذا دفع الوالي حياته ثمناً لهذا الصمود. لم يكن سعيد في الواقع يشتري ما يحتاج إليه أو حتى ما يرغب فيه، بل ما كان يفرض عليه شراؤه، وكان يقترض لا لتمويل مشروع اقتنع بفائدته، بل لشراء ما يحتاج البائع لتصريفه، أو لملء جيوب المرابين بالفوائد، أو لتمويل مشروع يعود على الأجانب بالربح. كان بدء إصدار سعيد لأذونات الخزانة بناء على نصيحة ديليسبس لكي يمكن سعيداً من الحصول على الأموال اللازمة للإنفاق على قناة السويس، وكان عقده لأول قرض خارجي مع مصرف فرنسي بتأييد بل وتشجيع وزير الخارجية الفرنسية. ثم تأتي بالطبع عمليات النهب من جانب قناصل الدول الأوروبية. فإذا بقنصل بلجيكا يضطر سعيد لدفع 3 ملايين فرنك تعويضاً له عن امتياز زعم أن محمد علي أعطاه له بكلمة شفوية منذ عشر سنوات لنقل البضائع إلى خليج السويس، وإذا بقنصل هولندا يضغط عليه ليحصل منه على امتياز بتشغيل قاطرات لجر حاملات البضائع في النيل، على أن يكون لهذه الشركة احتكار هذا الحق، فإذا ما احتج قناصل الدول الأخرى على حرمان رعاياهم من هذا الحق، وجد سعيد نفسه مضطراً لدفع تعويض إما لرعايا هذه الدول المحتجة، إذا أصر على إعطاء الامتياز للهولنديين، أو للهولنديين إذا سحب منهم الامتياز. فإذا به يلجأ إلى حل ثالث لا يقل سوءاً، وهو قيامه بشراء كافة أسهم الشركة الهولندية بسعر باهظ ثم يهجر المشروع بأكمله.
لم يكن وضع مصر الاقتصادي خلال عهد سعيد ليضطرها قط إلى الاستدانة، بل كان لديها من فائض الإيرادات ما يكفي، على حد تعبير القنصل الإنجليزي في ذلك الوقت "لتوظيف كل ما تحوزه من أيد عاملة، ولو كانت هذه الإيرادات قد وجهت إلى مشروعات مختارة بحكمة لاستطاعت مصر أن تلبي كل احتياجاتها". ولكن هذا الوالي الذي اعتلى عرش مصر في عصر الأفاقين، لم يكن في وضع يسمح له بتوجيه إيرادات مصر إلى "مشروعات مختارة بحكمة"، بل كان المقصود هو العكس بالضبط.
الخديوي إسماعيل: 1863-1879
لا يمكن لأحد أن يعيش في الثمانينيات من القرن العشرين، إذا شرع في قراءة تجربة مصر في التورط في الديون في عهد الخديوي إسماعيل، ألا يصاب بالدهشة إذ يرى أوجه الشبه الصارخة بين تجربة الستينيات والسبعينيات من القرن التاسع عشر، وتجربة السبعينيات من القرن العشرين. إن التاريخ بالطبع لا يمكن أن يعيد نفسه بالضبط، وهناك بالطبع من أوجه الاختلاف ما لا يمكن إنكاره أو التغاضي عنه، ولكن ما معنى الكلام عن "دروس التاريخ" و"الإفادة من معرفة الماضي" بل ما فائدة قراءة التاريخ أصلاً، إن لم يكن هناك بعض الصدق في القول بأن التاريخ يعيد نفسه؟
انظر أولاً إلى تغير لهجة المعلقين الغربيين والصحافة الأوروبية والأمريكية في الحديث عن السادات، أثناء حياته وبعد مقتله في 1981، واستعدادهم المدهش للتغاضي عن أخطائه ونقائصه طالما كان يمشي في ركاب الغرب ويحقق مآربه، ثم استعدادهم المدهش أيضاً للحديث عن نقائصه بعد أن بدا وكأنه قد حقق المطلوب منه وأدى مهمته. هكذا كان تغير موقف الأوروبيين من إسماعي، فقط كالوا له الثناء طالما كان قادراً على الاستدانة والشراء وتسديد القروض، ووصفوه بالحاكم العظيم البالغ الاستنارة والنشاط حتى وهو يطبق نظام السخرة لتنفيذ مشروعاته، أو وهو يعرض الفلاحين للموت جوعاً تحت وطأة ضرائبه. بل عمل القناصل الأوروبيون على الحصول له على قسط أكبر من الاستقلال عن السلطان العثماني في إدارة مصر، كانوا قد بخلوا به على محمد علي نفسه. على أنه ما إن فرغت جعبته، وظهر عجزه عن سداد ديونه، وأبدى مقاومة لما أرادوا فرضه من مشروعات التسوية، حتى بدأوا يوجهون إليه سهام النقد والسباب، وإذا بالجرائد الأوروبية تتحدث فجأة عن استبداده وظلمه، ووحشيته في معاملة عشيقاته، ويتهمونه بترتيب موت أخيه غرقاً ليستولي على العرش.
أو فلتنظر إلى تورط مصر في الاستدانة في السبعينيات من القرن العشرين في وقت لم تعرف مصر مثله، قبله أو بعده، من حيث تدفق العملات الأجنبية عليها من مختلف المصادر، ومن حيث ارتفاع معدل نمو الدخل، ومن حيث القدرة على الاستغناء عن القروض بل وتسديد ما سبق اقتراضه، على النحو الذي سنتناوله تفصيلاً فيما بعد، وقارن ذلك ببداية تورط إسماعيل في الديون في ظل رخاء لم تكن مصر قد عرفت مثل لعشرات من السنين، وفي ظروف هي أبعد ما تكون عن ظروف العوز والحاجة إلى الاستدانة.
كانت الحرب الأهلية الأمريكية (61-1864) قد بدأت قبل تولي إسماعيل العرش بنحو عامين وترتب عليها انخفاض شديد في المعروض من القطن الأمريكي، ومن ثم زيادة الطلب بشدة على القطن المصري، فارتفع سعر القطن المصري بنحو 100% في السنتين الأوليين من حكمه (63-1865)، وزاد حجم الصادرات بنفس النسبة، ومن ثم زادت قيمة صادرات القطن المصري خلال هاتين السنتين إلى أكثر من ثلاثة أمثالها (من 27 مليون ريال إلى 90 مليوناً)، ومع ذلك لجأ إسماعيل إلى الاستدانة حتى خلال هذين العامين، فعقد قرضاً خارجياً بمبلغ 5.7 مليون جنيه ف 1864 وآخر بمبلغ 2.4 مليون في السنة التالية.
كان إسماعيل قد ورث بالطبع تركة سعيد من الديون، كما ورث عنه أخطاء أخرى لم يكن من الممكن التخلص منها إلا بالمزيد من الإنفاق، كما ورث السادات من عبد الناصر بعض الديون وبعض الأخطاء التي احتاج تصحيحها إلى تحمل أعباء مالية، كما سيأتي بيانه في حينه. ولكن الأمر في الحالتين لم يكن قط مما يستعصي على الخزانة المصرية مواجهته، ولم يكن قط مما يفرض على مصر التورط في مزيد من الديون لو ووجهت الأمور بحكمة، بل وأهم من ذلك، لو لم يتعرض الحاكم الجديد لإغراء الأجانب له بالاستدانة.
كان سعيد قد ترك لمصر ديوناً قدرها كما رأينا نحو 18 مليوناً من الجنيهات، كما أنه قد ورط مصر في شرطين بالغي القسوة وردا في امتياز شركة قناة السويس وأراد إسماعيل التخلص منهما: أحدهما شرط توفير عمال السخرة في حفر القناة وفي حفر ترعة تزود منطقة القناة بالمياه العذبة، الأمر الذي كان من شأنه سحب نحو 60 ألف عامل من الزراعة، والثاني هو التنازل لشركة قناة السويس عن الأراضي المتاخمة لقناة المياه العذبة وتستخدم هذه القناة في ريها. وكان على إسماعيل تعويض الشركة عن إلغاء هذين الشرطين بمبلغ 4 ملايين من الجنيهات، طبقاً لقرار التحكيم الذي قضى به الإمبراطور نابليون الثالث. ولكن علينا أن نلاحظ أن الجزء الأكبر من الديون التي تركها سعيد، والتعويضات التي تحمل بها إسماعيل، كان مستحق الدفع عبر فترة ممتدة من الزمن. فكان نحو نصف ديون سعيد مستحق الدفع عبر ثلاثين عاماً، والتعويضات المستحقة لشركة القناة كانت مستحقة الدف بأقساط سنوية عبر ستة عشر عاماً. كان القسط السنوي الواجب الدفع من هذين الدينين لا يزيد عن نحو نصف مليون من الجنيهات، أي ما لا يزيد عن 9% من إيرادات الحكومة السنوية في السنوات الأربع الأولى من عهد إسماعيل، وأقل من 7% من متوسط إيراداتها السنوية حتى نهاية عهده. أما الجزء الباقي من الديون، وقدره نحو عشرة ملايين من الجنيهات، ويشمل ديون سعيد قصيرة الأجل، فقد كان يكفي لسدادها كلها تخفيض الإنفاق الحكومي بأقل من 20% خلال السنوات الخمس الأولى من حكم إسماعيل.
ولكن إسماعيل، كما يعرف الجميع، لم يفعل هذا، كما لم يفعل السادات ذلك فيما بعد، بل زاد الإنفاق بدلاً من أن يضغطه، وإذا بنا نجد، بعد ثلاثة عشر عاماً من حكم إسماعيل، أي في 1876، وهي السنة التي خرجت إدارة المالية المصرية عن سيطرته وأصبحت في يد المراقبين الماليين من الأجانب، أن ديون مصر الخارجية (بما في ذلك ديون الخديوي الخاصة) قد بلغت نحو 91 مليون جنيه، يبلغ حجم خدمتها السنوية (أي حجم الأقساط السنوية والفوائد) أكثر من ستة ملايين جنيه، أو ما يمثل نحو 80% من إجمالي إيرادات الدولة في تلك السنة، وذلك بالمقارنة بعبء خدمة الديون في آخر عهد سعيد الذي لم يزد عن 260 ألف جنيه أو ما يمثل أقل من 5% من إجمالي إيرادات الدولة في 1863.
مما يلفت النظر بشدة أيضاً، أوجه الشبه بين نمط البيئة في عهد إسماعيل ونمطها في عهد السادات. ففي كلا الحالين كان جل الاهتمام منصباً على مشروعات البنية الأساسية دون إحداث أي تغيير يذكر في هيكل الاقتصاد المصري لصالح التصنيع. ومع ذلك فمن الخطأ التقليل من شأن ما تم في عصر إسماعيل من تنمية لهذه البنية الأساسية، ولا شك عندي في أن المقارنة بين ما أضافه إسماعيل وما أضافه السادات في هذا المجال، بالنسبة لما ورثه كل منهما عن سلفه، هي في صالح إسماعيل.
إن ما يذكر به عهد إسماعيل عادة من بناء القصور الشامخة وإقامة دار فخمة للأوبرا وتوسيع الشوارع والميادين وتجميل القاهرة، ليس في الحقيقة أهم ما أضافه الرجل من عمران. فقد أضاف إسماعيل إلى شبكة الري ما لا يقل عن 8400 من الأميال من الترع وقنوات الري الجديدة، فزادت المساحة الزراعية في عهده بنحو 750 ألف فدان بعد أن ظلت ثابتة تقريباً في السنوات العشر السابقة على حكمه. كذلك أضاف إسماعيل 910 ميلاً من السكك الحديدية ربطت بين كافة مدن الدلتا الأساسية ووصلت إلى أسيوط والفيوم، وبنى 340 جسراً، ومد 520 ميلاً من خطوط التلغراف وأصلح ووسع ميناء الإسكندرية، وأضاف 15 فناراً على البحرين المتوسط والأحمر. كان إسماعيل قد ورثت عن سعيد 185 مدرسة من المدارس الحديثة فأصبح عددها عندما ترك الحكم 4817 مدرسة. أما في مجال التصنيع فتكاد تقتصر مساهمة عصر إسماعيل على التوسع الكبير في مصانع السكر، وفيما عدا ذلك لا نكاد نجد ما يذكر لإسماعيل إلا أنه أعاد فتح بعض مصانع النسيج والطرابيش والأسلحة التي كان قد أنشأها محمد علي وأغلقت في عهد عباس.
فلنلاحظ أيضاً ما شهده عصر إسماعيل مثلما شهد عصر السادات، من تغير واضح في أنماط الاستهلاك، والزيادة الواضحة في الاعتماد على الاستيراد لتلبية حاجات هذه الأنماط الاستهلاكية الجديدة. كانت القوة المحركة لهذا التغير هي في الأساس تزايد عدد الأجانب المقيمين في مصر، الذي بلغ في نهاية عهد إسماعيل نحو ستة أمثال عددهم في 1836، وتزايد عدد حديثي الثراء من المصريين الذين بدأوا يقطنون الأحياء الأوروبية في القاهرة والإسكندرية، ويقلدون الأجانب في نمط معيشتهم ونوع مساكنهم، ويستوردون مثلهم معظم حاجياتهم من الخارج، بما في ذلك مواد البناء، بل وأحياناً قطع الحجارة التي ترصف بها شوارعهم.
لا يمكن مع هذا، تفسير تورط مصر في الديون في عصر إسماعيل بما أنفق على مشروعات البنية الأساسية أو مشروعات التنمية عموماً، وسوف نرى نفس الملاحظة فيما يتعلق بمصر السادات أيضاً. إن كراوشلي يقدر ما أنفق في عصر إسماعيل على المشروعات العامة، من قنوات الري والجسور والسكك الحديدية وخطوط التلغراف، وعلى توسيع الموانئ وإنشاء مصانع السكر، بنحو 39 مليوناً من الجنيهات، أو نحو 51 مليوناً إذا أضفنا ما كان على إسماعيل دفعه لمواجهة التزامات مصر قبل شركة قناة السويس، ولكن بعد أن نخصم من قيمة هذه الالتزامات ما حصل عليه إسماعيل من قيمة بيع أسهم مصر في شركة القناة. من الممكن إذن أن نعتبر هذا المبلغ (51 مليون جنيه) هو بالتقريب قيمة ما أنفق في عصر إسماعيل على مشروعات التنمية. ولكن ديون مصر الخارجية زادت في عهده كما رأينا، بنحو 73 مليوناً. هناك إذن ما لا يقل عن 22 مليوناً من الجنيهات أو نحو 30% مما أضافه إسماعيل إلى ديون مصر الخارجية، مما لم تستفد منه التنمية في مصر، حتى بفرض أن كل ما أنفق بالفعل على مشروعات التنمية كان يمثل قيمة الزيادة الحقيقية في رأس المال القومي، وهو فرض بعيد عن الحقيقة بسبب خضوع إسماعيل لمختلف أنواع الغش والتدليس فيما عقده من صفقات لاستيراد المعدات والتجهيزات. يضاف إلى ذلك بالطبع ما تحقق من زيادة في إيرادات مصر الذاتية خلال حكم إسماعيل ولو يوجه إلى مشروعات التنمية. لقد كان المتوسط السنوي لإيرادات الدولة في عصر إسماعيل نحو 6.7 مليون جنيه، أو ما يمثل نحو 290% من المتوسط السنوي لإيراداتها في عصر سعيد (2.3 مليون جنيه). هذه الزيادة في الإيرادات الذاتية للدولة يجب أن تضاف إلى ما يمكن اعتباره تبديداً في غير أغراض التنمية.
من السهل أن نفسر هذا التبديد للموارد، الذاتية والخارجية، بصفات إسماعيل الشخصية، من ميل طبيعي إلى البذخ، سواء في إنفاقه على نفسه وحاشيته أو في ضيافته للأجانب، ومن رغبة لا تقاوم في كسب رضا ومودة الأوروبيين، وفي تحويل مصر إلى "قطعة من أوروبا". ولكن الأقرب إلى الحقيقة هو أن الجزء الأكبر من ذلك الفارق بين ما أنفقه إسماعيل على مشروعات التنمية وبين قيمة الزيادة في ديون مصر الخارجية في عهده، لم يتسلمه إسماعيل في الواقع أصلاً. بعبارة أخرى، إن حجم التبديد الاستهلاكي الذي يرتبط عادة باسم إسماعيل، إنما يبدو ضخماً حقاً إذا قارنا بين ما أنفقه على التنمية وما أضافه من ديون، ولكن يظهر لنا في الحقيقة أقل من ذلك بكثير إذا قارنا بين ما أنفقه على التنمية وما استلمه بالفعل من المقرضين، بعد خصم مختلف أنواع السمسرة والعمولات والمصاريف التي كان المقرضون الأجانب يقتطعونها ابتداءً من القيمة الاسمية للقرض. فطبقاً للأرقام التي يوردها أوين، كانت القيمة الاسمية للقروض الخارجية التي عقدت في الفترة الممتدة بين 1862 (وهي آخر سنة من حكم سعيد) و1873، هي 68.5 مليوناً من الجنيهات، لم يتسلم منها سعيد وإسماعيل إلى 46.6 مليوناً، أي ما يقل بنحو 22 مليوناً عن القيمة الاسمية.
كذلك فإنه طبقاً للأرقام التي يوردها مارلو عن قروض إسماعيل وحده فيما بين سنة اعتلائه للعرش (1863) وسنة 1876، كانت القيمة الاسمية للقروض الخارجية طويلة الأجل التي عقدها إسماعيل هي 53 مليون جنيه لم يتسلم منها بالفعل إلا 32 مليوناً، أي ما يقل عن القيمة الاسمية بمقدار 21 مليون جنيه، وهو يكاد يعادل بالضبط ما اعتبرناه المبلغ "المبدد" من قروض إسماعيل الخارجية. لم تكن خطيئة إسماعيل الأساسية إذن هي "التبديد" بقدر ما كانت هي محض اللجوء إلى الاستدانة في ظل الشروط القاسية التي كانت تقدم بها القروض، ولكن هذه الخطيئة من السهل أيضاً تفسيرها بما سبق أن ذكرناه من قبل من أنه فيما يتعلق بالإقراض والاقتراض يبدو أن ما يحدث هو أن: "العرض يخلق الطلب" أكثر مما يحدث العكس، أي أن تورط المدين في الاستدانة قد لا يرجع إلى حاجته إلى الاقتراض بقدر ما يرجع إلى حاجة الدائن إلى الإقراض.
لم يكن من قبيل المصادفة أن يكون تورط مصر في الديون مصاحباً لتورط الدولة العثمانية فيها، كما حدث بعد ذلك في السبعينيات من القرن العشرين، حيث كان تورط مصر في الديون جزءاً من ظاهرة دولية عامة، أو أن يأتي إفلاس إسماعيل في 1876 بعد سنة واحدة من إفلاس الباب العالي. وإنما جاء تورط الاثنين وإفلاسهما استجابة في الأساس، لا لميل كل منهما إلى التبذير وتبديد الأموال، وإنما لشدة حاجة أوروبا إلى الإقراض. كان هناك أولاً تزايد أهمية التجارة الخارجية بصفة عامة بالنسبة للاقتصاد الأوروبي منذ منتصف القرن، وتزايد أهمية منطقة الشرق الأوسط في هذه التجارة، ومن ثم تزايد الحاجة إلى دفع المزيد من رؤوس الأموال الأوروبية لتمويل هذه التجارة من ناحية، ولتمويل مشروعات البنية الأساسية التي تخدمها، من مد السكك الحديدية إلى توسيع الموانئ إلى إنشاء خطوط التلغراف.. إلخ.
يذكر أوين أن العقدين السادس والسابع من القرن التاسع عشر شهدا معدلاً للنمو الاقتصادي في بريطانيا وفرنسا غير معهود في تاريخ الدولتين، مما انعكس في حجم تجارتهما الخارجية. ففي بريطانيا تضاعف حجم الصادرات فيما بين 1848 و1857 ثم تضاعف مرة أخرى خلال الاثنتي عشرة سنة التالية، كما زادت الواردات والصادرات الفرنسية بما يقرب من 100% فيما بين 1852 و1860، وصاحب ذلك زيادة كبيرة أيضاً في حجم التجارة بين كلتا الدولتين من ناحية وبين مصر وتركيا من ناحية أخرى.
كانت هناك أيضاً الزيادة الكبيرة في حجم رؤوس الأموال الجاهزة للاستثمار الخارجي، وما صحب ذلك من نمو المؤسسات المصرفية الأوروبية التي قامت لتعبئة هذه المدخرات وتوجيهها إلى الخارج، في وقت كانت قد انتهيت فيه فرص الاستثمار في مد السكك الحديدية في داخل بريطانيا وفرنسا، وبدأت تنضب فرص الاستثمار المجزي الأخرى في كلتا الدولتين كما سبق لنا أن أشرنا.
وأخيراً كان هناك محض التنافس بين الدول الأوروبية على كسب موطئ قدم لها فيما وراء البحار وتدعيم وجودها الاقتصادي والسياسي، وخشية كل منها أن تسبقها غيرها في توسيع دائرة نفوذها. كان الشكل المفضل من أشكال الاستثمار الخارجي في ذلك الوقت هو تقديم القروض للحكومات. ففضلاً عن إمكانية الحصول من الوالي على عائد مجز، وما يمكن الحصول عليه من ضمانات وعمولات، كانت قدرة الوالي على استيعاب القروض كالبالوعة التي تتسرب منها المياه بلا نهاية، وكان من أسهل الأمور إخضاعه لمختلف أنواع الإغراء والتهديد، وإذا لزم الأمر استبدال غيره به.
لا أعتقد أن من المفيد الإطالة هنا في تتبع الخطوات التي أدت بها الديون إلى فقدان مصر لاستقلالها الاقتصادي والسياسي في أواخر عهد إسماعيل، فالقصة معروفة ومشهودة. وإنما يكفي فقط أن نروي بسرعة الملامح الرئيسية للتطورات التي صاحبت أزمة الديون في أواخر السبعينيات من القرن التاسع عشر، لكي نلفت النظر إلى أوجه الشبه بينها وبين التطورات التي حدثت في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن العشرين. لقد بدأ التدخل الأجنبي بقبول الخديوي إسماعيل تحت وطأة الديون، أن يضع تحت تصريف "الخبير" البريطاني كيف في 1875، ما يريد جمعه من معلومات عن إيرادات مصر ومصروفاتها، بشرط ألا يعني ذلك، على حد تعبير المذكرات الرسمية المتبادلة حينئذ "أي تدخل أو عدوان على السيادة المصرية"! ثم اضطر إسماعيل في السنة التالية (1876) إلى قبول إنشاء صندوق الدين المكون من مراقبين أوروبيين يمثلون أهم الدول الدائنة، تكون مهمتهم تسلم وتوزيع ما تضعه الحكومة تحت تصرفهم من إيرادات بغرض تسديد الديون، وإلى أن يقبل في نفس السنة شروط التسوية التي فرضها ممثلا الدائنين (جوشين الإنجليزي وجوبير الفرنسي) بإعادة جدولة الديون، لطمأنة الدائنين، ما لم يصحبه الاطمئنان على تنظيم إيرادات ونفقات الحكومة المصرية، بما يوفر فائضاً كافياً لخدمة الديون، مما أدى إلى تكوين لجنة التحقيق في 1878، التي تذكر توصياتها بما يطلبه صندوق النقد الدولي في وقتنا الراهن، تحت مسميات مختلفة، كإصلاح المسار الاقتصادي، أو إجراءات التصحيح والتكيف، أو ترشيد السياسة الاقتصادية.. إلخ.
يقول مارلو في وصف هذه الفترة التي انقضت بين قبول إسماعيل لشروط التسوية أو إعادة الجدولة، في نوفمبر 1876، وبين تشكيل لجنة التحقيق في مارس 1878: "كان هناك ميل متزايد لدى دائني مصر إلى الاعتقاد بأن شيئاً ما يتعين عمله لضمان السيطرة على تصرفات الخديوي.. وحاول إسماعيل أن يستخدم في المعركة الدائرة بينه وبين الدائنين كل وسيلة بإمكانه استخدامها، مهما كانت المحاولة يائسة، كالاعتماد مثلاً على أن الحكومة البريطانية قد لا تهمها مصلحة الدائنين بقدر ما تهمها مصلحتها الاستراتيجية في مصر، باعتبارها واقعة على طريق إنجلترا إلى الهند.. أو مسايرته وانصياعه لرغبات الحكومة البريطانية فيما يتعلق بمصالحها في البحر الأحمر وأفريقيا الوسطى.. أو محاولته الحصول على مساعدة بعض الشخصيات الأوروبية البارزة التي كانت تبدي تعاطفاً معه.. بل وحاول أن يستغل عاطفة الوطنية المصرية الوليدة والشعور الديني لإثارة غضب المصريين على طريقة الأوروبيين في ابتزازه.. ولكن اضطر إسماعيل للخضوع التام والاستسلام في النهاية، كما حدث بالضبط في قبوله لتسوية جوشين وجوبير، نتيجة لاتفاق الحكومتين البريطانية والفرنسية على اتخاذ مسلك واحد إزاءه".
أما محاولة إسماعيل الأخيرة لاستعادة سيطرته، فقد كلفته عرشه. فإذ تجرأ إسماعيل على عزل مجلس الوزراء الذي فرضه عليه الأوروبيون، واستدعى شريف باشا لتشكيل وزارة مصرية خالصة، وإذ حاول أن يطبق مشروعه الخاص للإصلاح المالي وتجاهل المشروع الذي أعدته لجنة التحقيق، أرسلت الحكومتان البريطانية والفرنسية مذكرتين متطابقتين تحملان الخديوي مسئولية ما صنع، وتعتبر محاولته "للتصرف في شئون الدين المصري وفق تصوره الخاص" من قبيل "الاعتداء المباشر والصريح على الاتفاقات الدولية" وسرعان ما سعت الحكومتان لدى الباب العالي لعزله، وهو ما تم بالفعل في 26 يونيه 1879. ولم يكن قد انقضت بعد عشرة أسابيع على قيام إسماعيل بطرد الوزارة الأوروبية.
ولا يجوز مع ذلك أن نختم قصة الديون في عهد إسماعيل دون أن نأتي على ذكر قصة إسماعيل المفتش، ذلك اللغز الذي يكتنفه الغموض ويختلف حوله الرأي. كان إسماعيل صديق، الذي اشتهر بإسماعيل المفتش، صديقاً لإسماعيل منذ الطفولة وأخاه في الرضاعة، ومديراً لمزارعه، قبل أن يعينه إسماعيل وزيراً للمالية في 1868. ولكنه قتل في ظروف غريبة في 1876، وهي نفس السنة التي أنشئ فيها صندوق الدين، والتي جاء فيها جوشين وجوبير إلى مصر كممثلين للدائنين الأوروبيين، وأجبرا الخديوي على وضع إيرادات مصر من السكك الحديدية وميناء الإسكندرية تحت السيطرة الأجنبية كضمان لتسديد ديونه. في نفس هذه السنة كان إسماعيل المفتش قد أجبر أيضاً على الاستقالة كوزير للمالية بناء على إلحاح جوشين الذي يصفه الرافعي بأنه كان "وزيراً سابقاً في الوزارة الإنجليزية، ثم عاد إلى الوزارة في سنة 1887، وهو ابن المالي جوشين أحد أصحاب بنك فرهلنج وجوشين بإنجلترا وهو البنك الذي أقرض مصر قروضها الأولى". ثم أعلن رسمياً عن وفاة إسماعيل المفتش بعد استقالته ببضعة اسابيع.
هناك ثلاثة مواقف مختلفة، على الأقل، في تقييم إسماعيل المفتش وتفسير مقتله، هناك أولاً رواية الرافعي البالغة القسوة والتي يصب فيها جام غضبه على إسماعيل المفتش ويصفه بأنه كان هو نفسه "من الكوارث التي حلت بمصر في عهد إسماعيل" وأن سنوات توليه وزارة المالية "هي التي جرت الخراب المالي على البلاد (وأنها) أتعس فترة في تاريخ مصر المالي"، ويقول إنه "أثرى إثراءً فاحشاً، وقلد مولاه في عيشة البذخ والإسراف والاستكثار من القصور والأملاك والجواري والحظايا، وإليه يرجع السبب في استدانة الحكومة نحو ثمانية ملايين جنيه ضاع معظمها سدى". ويميل الرافعي إلى أن الخديوي إسماعيل هو الذي أمر بقتله خوفاً من أن يكشف أسرار الخديوي وإسرافه، ومن أن يشرك الخديوي معه في المسئولية عن تبديد أموال الدولة "فعهد الخديوي إلى أتباعه بقتله فقتلوه وألقوا جثته في النيل".
ولا تختلف رواية الرافعي كثيراً، سواء في تفاصيل مقتل المفتش أو في إلقاء المسئولية في قتله على الخديوي إسماعيل، عن رواية ويلفرد بلنت في كتابه الشهير "التاريخ السري للاحتلال الإنجليزي لمصر". ولكننا نجد موفقاً مختلفاً بعض الشيء عند مارلو الذي يصف إسماعيل المفتش بالكفاءة والإخلاص التام للخديوي، وإن كان قد "كرس هذه الصفات الشخصية لامتصاص أكبر قدر ممكن من المال من الشعب المصري، ونجح في ذلك أكثر من اللازم.. وأثرى هو نفسه ثراءاً كبيراً". ويذكر مارلو أيضاً أن إسماعيل المفتش هو الذي كان يحرض إسماعيل على رفض اقتراحات جوشين وجوبير الخاصة بتسوية الديون وتخصيص إيرادات السكك الحديدية لخدمتها، ويرجح مارلو وجود اتفاق ضمني بين الخديوي وبين جوشين وجوبير للتخلص من إسماعيل المفتش كطريقة للوصول إلى تسوية مع الدائنين الاوروبيين وكسب رضا الحكومتين البريطانية والفرنسية.
على أننا نجد موقفاً ثالثاً، ومختلفاً إلى حد كبير عن الموقفين المتقدمين، لدى روذشتين مؤلف كتاب "خراب مصر" حيث يبدو الكاتب شديد التعاطف مع إسماعيل المفتش بحيث يكاد يجعله بطلاً قومياً، فيصوره في صورة الرجل الوطني الذي رفض التدخل الأوروبي في شئون مصر وحاول مقاومته، ويصور مقتله على أنه الثمن الذي دفعه الرجل لهذه المقاومة، ويجعل الدائنين الأوروبيين المسئولين الأساسيين، إن لن يكونوا المسئولين الوحيدين عن قتله. يرفض روذشتين الصورة التي رسمها المعلقون الأوروبيون لإسماعيل المفتش على أساس أنهم كلهم "من أصدقاء المستر جوشين وحملة السندات"، حيث صوروا المفتش "كمثال للباشا الشرقي، قالوا إنه كان رجلاً فاقد الضمير، غليظ القلب، خائناً ومتعصباً" لمجرد أنه كان "يقف بينهم وبين تحقيق أغراضهم الحقيرة". والحقيقة في نظر روذشتين أن موقف المفتش "كان هو الموقف الصائب من جميع الوجوه". كان يقول إنه: "إذا وصل الأمر إلى اتفاق مع الدائنين، فإن منتهى السفاهة أن يكون أساس الاتفاق تحميل مصر بسعر فائدة قدره 7% في حين أن 5% هو أقصى سعر تستطيع مصر دفعه دون أن تجر على نفسها الخراب، وأما الرضا بوضع رقابة على المالية المصرية، التي ليست في الواقع إلا رقابة على الإدارة المصرية كلها، فقد كان في رأيه لا يعني إلا تسليم البلد للأجانب، وهو أمر لا يختلف عن الخيانة العظمى في شيء". أما مقتل إسماعيل المفتش فيرى روذشتين أنه: "إذا لم يكن قد تم بناء على التحريض المباشر من جانب الدائنين الأوروبيين وممثليهم في مصر، فهو قد تم على الأقل نتيجة قسوتهم المفرطة في الضغط على الخديوي إلى حد اضطراره لقتله".
ويستند روذشتين في ذلك إلى مقاومة المفتش للتسوية التي كان الدائنون يريدون فرضها على الخديوي، واعتبارهم التخلص منه "مسألة حياة أو موت"، إلى ما كانت تنشره جريدة التايمز البريطانية من اعتبار المفتش "العدو الاول لإصلاح" وابتهاجها الشديد بسقوطه، والرواج المفاجئ الذي أصاب بورصة الإسكندرية بمجرد أن ترددت إشاعة سقوطه، وإلى خطاب القنصل الإنجليزي لحكومته بمجرد حدوث مقتله حيث قال إنه "قد قوي الأمل كثيراً في نجاح بعثة جوشين وجوبير عقب سقوط ناظر الملاية السابق"، وإلى أنه لم يمض أسبوع واحد على مقتله حتى أعلن إسماعيل قبوله لمشروع جوشين وجوبير للتسوية. ويرفض روذشتين رواية لبنت عن مقتل إسماعيل المفتش على أساس أن بلنت قد استقاها مباشرة من السير ريفرز ويلسن، وهو البريطاني الذي تولى وزارة المالية في مصر بعد سقوط المفتش، والذي رأس لجنة التحقيق التي جاءت إلى مصر لفرض إرادة الدائنين، ومن ثم فلديه مصلحة أكيدة في إخفاء الحقيقة. وأخيراً يذكر روذشتين أن قنصل إنجلترا العام في مصر في ذلك الوقت (اللورد فيفيان) نسب جريمة قتل المفتش إلى شخص حدث فيما بعد أن أنعمت عليه الحكومة البريطانية بلقب "سير".
صندوق الدين
 مقالة مفصلة: صندوق الدين بمصر
مقالة مفصلة: صندوق الدين بمصر
صندوق الدين في مصر كان لجنة دولية تأسست بمرسوم من الخديوي إسماعيل في 2 مايو 1876 للاشراف على سداد الحكومة المصرية ديونها للحكومات الاوروبية، التي تراكمت في عصر إسماعيل. وكان الصندوق في البداية يرأسه أمين وثلاثة مفوضون يمثلون حكومات النمسا-المجر، فرنسا وإيطاليا.[5]
ومنذ 1877، المملكة المتحدة. وقد ألغي الصندوق باتفاقية ثنائية بين حكومتين البريطانية والمصرية، في 17 يوليو 1940،[6] بسبب اهتمام الحلفاء بتحسين علاقاتهم بالقاهرة أثناء الحرب العالمية الثانية.
الخديوي توفيق: 1879-1892
إذا كنا قد وصفنا عهد محمد علي بأنه كان عهد التنمية بلا ديون، فإن من الممكن وصف عهد سعيد وإسماعيل بأنه كان عهد الديون بلا تنمية. حقاً لقد شهد الاقتصاد المصري نمواً لا يستهان به في عصر إسماعيل، ولكننا إذا اعتبرنا التغير في بنيان الاقتصاد وفي هيكل الجهاز الإنتاجي شرطاً "للتنمية"، تمييزاً لها عن مجرد النمو، فإننا لا نبعد عن الحقيقة إذا قلنا إن عصر إسماعيل كان بالفعل، كما كان عصر سعيد، عصراً تورطت فيه مصر في الديون دون تنمية. وقد ذكرنا أن شيئاً شبيهاً جداً بذلك قد عانته مصر بعد مائة عام من عصر إسماعيل، حيث اقترنت السبعينيات من القرن العشرين بالتورط في الديون، مع النمو السريع في الدخل، دون أن يحدث أي تقدم يذكر في هيكل الجهاز الإنتاجي بل مع تدهور ملحوظ فيه، كما سنبين تفصيلاً فيما بعد.
وقد تركنا عصر إسماعيل ومصر على أعتاب الاحتلال، ودخلت مصر مع قدوم الاحتلال البريطاني عام 1882 عهداً تختلف سماته الاقتصادية اختلافاً بيناً عن عصر سعيد وإسماعيل. فخلال العقود الثلاثة الأولى للاحتلال البريطاني (1882-1914) كانت السمة الأساسية للاقتصاد المصري هي النمو السريع الموجه لخدمة الدائنين، إذ تحولت مصر إلى دولة مصدرة لرأس المال بدلاً من أن تكون مستوردة له، وأصبح من بين الأهداف الأساسية للإدارة الاقتصادية في ظل الاحتلال توليد الدخل الكافي لخدمة الديون التي تورطت فيها مصر في العقدين السابقين.
كانت أول حجة قدمتها الحكومة البريطانية لتبرير احتلالها لمصر هي حماية حقوق الدائنين الأوروبيين. وبصرف النظر عن الأهمية النسبية لهذا الدافع بالمقارنة بسائر دوافع بريطانيا لاحتلال مصر، فمن المؤكد أنه كان من بين المحددات الأساسية للإدارة البريطانية للاقتصاد المصري خلال العقود الثلاثة الأولى للاحتلال. يصف الدكتور علي الجريتلي أهداف هذه الإدارة بقوله:
"كان الهدف الوحيد للإدارة البريطانية في السنوات التالية لـ1882، هو زيادة مساحة الأراضي المروية رياً دائماً والمساح المزروعة بالقطن، بدافع توليد إيرادات كافية من النقد الأجنبي لخدمة الدين الخارجي الضخم، وكان من المهم أن يتغاضى عن أية اعتبارات أو أهداف أخرى، والتركيز على إعادة ترتيب المالية المصرية من أجل تمكين أصحاب السندات من الحصول على (رطل اللحم) من جسم الاقتصاد المصري"، بالطبع إلى مطالبة شايلوك برطل اللحم من جسم أنطونيو في المسرحية الشهيرة. كما تقتطف وثائق الحكومة البريطانية الرسمية الصادرة في 1898 قولاً للورد كرومر يبرر فيه بناء خزان أسوان بنفس الاعتبار، وهو توليد الإيرادات الكافية لخدمة الديون".
إن من الخطأ الظن بأن مصر لم تشهد خلال الثلاثين عاماً الأولى للاحتلال البريطاني نمواً اقتصادياً يستحق الذكر، فالعكس بالضبط هو الصحيح. لا تتوافر لدينا بالطبع إحصاءات عن نمو الدخل القومي أو الناتج القومي الإجمالي خلال هذه الفترة، ولكن عدداً من المؤشرات الأخرى يدل على نمو الاقتصاد بمعدلات لم تعرف مصر مثلها منذ محمد علي. كان محور الاقتصاد المصري بالطبع هو الزراعة، وإذا كانت المساحة المنزرعة لم تزد بأكثر من نحو 10% طوال تلك العقود الثلاثة، فإن المساحة المحصولية زادت خلالها بنحو 60% (1877-1913)، وزاد إنتاج القطن بنحو ثلاثة أميال، وقيمة صادرات القطن بنحو أربعة أمثال نتيجة زيادة إنتاجه وارتفاع أسعاره معاً. ولكن هذه الزيادة الكبيرة في الدخل لم تقترن بأي تغير يذكر في بنيان الاقتصاد المصري، أو بزيادة درجة التنوع والتوازن بين مختلف عناصر الدخل، ذلك أنه لم يكن يتصور في إدارة اقتصادية تستهدف بدرجة أساسية توليد مصادر للنقد الأجنبي تكفي لخدمة الديون، أن تعطي الأولوية للإنتاج الموجه للسوق المحلي بالمقارنة بالإنتاج للتصدير، أو أن تسمح "بتبديد" النقد الأجنبي في تنمية صناعات جديدة لا تجلب موارد جديدة للدولة إلا في المدى الطويل. وهكذا انحصرت الاستثمارات الموجهة إلى قطاعي الزراعة والبنية الأساسية فيما يخدم صادرات القطن، وانحصر النمو الصناعي في تلك الصناعات التي تتمتع بحماية طبيعية، مثل حلج وكبس القطن وصناعات الزيوت والإسمنت والبيرة، بالإضافة إلى صناعة السجائر التي كانت تعتمد على استيراد الدخان من تركيا، المعفى من الضرائب الجمركية بمقتضى خضوع مصر اسمياً للدولة العثمانية. ولم تسمح سياسة كرومر، كما هو معروف، بأي تحول في هيكل الصناعة، كإقامة صناعة حديثة للمنسوجات تنافس المنسوجات البريطانية المستوردة، متعللاً بانه لم سمح بذلك "لقامت لانكشير بحمل السلاح ضده". وهكذا نجد أن الاستثمار في الصناعة لم يستوعب خلال هذه الفترة إلا نسبة ضئيلة من حصيلة الصادرات لا تزيد على 9%، بالمقارنة بنسبة تزيد على الثلث في عهد محمد علي. أما نصيب الأسد في حصيلة الصادرات فقد ذهب لخدمة الديون.
لقد سبق أن رأينا أن إجمالي ديون مصر الخارجية (بما في ذلك ديون الخديوي الخاصة) قدر بمبلغ 91 مليون جنيه في 1876، وهي السنة التي خرجت فيها إدارة المالية المصرية عن سيطرة الخديوي وأصبحت في يد المراقبين الماليين الأجانب.
على أنه طبقاً لتقرير لجنة التصفية الذي صدر بمقتضاه قانون التصفية في 1880، قدرت ديون مصر الخارجية، بما في ذلك ديون الدائرة السنية والقرض الإضافي الذي عقد مع روتشايلد في 1878، بمبلغ 98.4 مليون جنيه. ثم زادت الديون خلال العشرين سنة التالية بما عقدته إدارة الاحتلال من قروض حتى بلغت 116 مليون جنيه في 1900. خلال هذه الفترة خصصت إدارة الاحتلال نسبة تتراوح بين 24% و40% من إجمالي حصيلة الصادرات لخدمة الدين، أو ما يعادل ما بين 35% و46% من إجمالي الإيرادات الحكومية، واستمرت مصر تدفع لخدمة ديونها (بالإضافة إلى الجزية التي كان عليها دفعها للباب العالي) حتى بداية الحرب العالمية الأولى، وما بين 4.5 و5 ملايين من الجنيهات سنوياً في المتوسط. معنى ذلك أن مصر دفعت لخدمة ديونها خلال الثلاثين عاماً الأولى من الاحتلال نحو 145 مليون جنيه، ومع ذلك كانت ما زالت مدينة في 1914 بمبلغ 86 مليوناً. أي أن مصر دفعت 145 مليون جنيه لإنقاص مديونيتها بمبلغ 30 مليون جنيه فقط وذهب الباقي (115 مليون) في صورة فوائد! يجب ألا يستهين القارئ، الذي تعود في أيامنا هذه على سماع أرقام خدمة الديون الحالية التي تقدر بمئات الملايين، بمبلغ أربعة أو خمسة ملايين كانت تدفع سنوياً لخدمة الدين في أوائل القرن. ذلك أن حجم الدخل القومي في ذلك الوقت لم يكن يتعدى نحو مائة مليون جنيه، ومنى ذلك أن خدمة الدين كانت تستوعب 4 أو 5% من الدخل القومي، وهو يكاد يمثل أقصى قدرة الاقتصاد المصري على الادخار في ذلك الوقت، ولا يكاد يترك لمصر شيئاً يمكن أن تنفقه على النهوض بالتعليم أو الصحة أو التنمية الصناعية. أو فلنقارن هذا المبلغ (4-5 ملايين) بكل ما تكلفه بناء خزان أسوان في 1902، وهو أهم مشروع استثماري قامت به الحكومة في تلك الفترة، إذ لم تزد نفقاته، بما في ذلك ما دفع كتعويض لأصحاب الأراضي، على ثلاثة ملايين من الجنيهات.
اقترن هذا التدفق للموارد إلى خارج مصر، بورود بعض الاستثمارات والقروض الأجنبية الخاصة إليها. ولكن هذه كان يقابلها بدورها تحويلات لأرباح وفوائد على هذه الاستثمارات والقروض الخاصة، بحيث لم يتعد صافي تدفق رأس المال الخاص إلى مصر خلال الفترة (1884-1914) مبلغ 33 مليوناً من الجنيهات، بالمقارنة بنحو 145 ميلوناً خرجت من مصر لخدمة الديون، معنى ذلك أن مصر كانت خلال هذه العقود الثلاثة مصدراً صافياً لرأس المال بنحو 3.4 مليون جنيه سنوياً.
عباس الثاني: 1892-1914
انتشرت البنوك الاجنبية في انحاء مصر، فتهافت عليها اغنياء مصر فاودعوا فيها اموالهم بسخاء وبثقة وبامانة، وكانت هذه الودائع بدون فوائد، وهذه البنوك ترسل الاموال لبلادها وهناك يستثمرونها في خصوصياتهم ومصر عمياء لا ترى صماء لا تسمع. واذا عادت هذه النقود الى مصر فانها انما تعود ليقترض منها المصريون بفوائد عالية، حتى الحكومة فانها اعطت اموالها للبنك الاهلي بفائد 1، 1.5% مع علمها بان هذا البنك يرسل اموالها الى الخارج، وكانت انجلترا اكثر الدول استئثارا بهذه الكنوز حيث كان البنك الاهلي تابعا لها.
كان لنشوب الحرب العالمية الاولى عاملا بارزا في تغيير مجرى الحياة الاقتصادية والمالية في مصر فمنذ ان اعلنت الحرب قام الافراد بسحب ودائعهم من البنوك واقبلوا على الاسواق لشراء ما بها احتياطيا لما تخبئه الايام. وقد نتج عن ذلك ان البنوك لم تقو كلها على استمرار دفع الامانات الى اصحابها فاغلقت في وجوههم ابوابها، واذا سئل احدهم يسمع رد مدير البنك قائلا "نحن لا نقدر ان نعطيك اموالك الآن اذهب، ولا يؤاخذنا المصريون في ان نقول لهم العوض على الله".
وتبع ذلك ان كفت البنوك عن التسليف على المحصولات فتقول صحيفة الوطن: "قد باتت الحالة المالية والاقتصادية في مركز سيئ ، والجمهور لا يفتأ يتزاحم على البنوك لسحب امواله منها وتحويل ما لديه من السندات والاوراق المالية الى ذهب وفضة والغالبية في البيوت المالية منعت معاملتها، واقفلت ابواب التسليف على الاقطان ومختلف الحاصلات".
احست الحكومة بتلك الازمة فاصدرت امرها في 4 اغسطس 1914 باعلان الموراتوريوم – التأجيل الجبري – اي عدم دفع الودائع والامانات والديون لاربابها الى اول نوفمبر 1914 وتبع ذلك ان اجلت المواعيد التي يجب ان تعمل فيها البروتستات وجميع الاجراءات الخاصة بالمطالبة وذلك فيما يتعلق بجميع الاوراق الجائز التداول بها وانه لا يجوز مطالبة الممولين وغيرهم من المتلزمين بالسداد اثناء مدة هذا التاجيل، أما الفوائد فتكون واجبة من تاريخ الاستحقاق الى تاريخ الوفاء.
وهذا الاجراء لم يعد بالنفع على الامة اذ ان التجار من اولى الزمم الواسعة لعبوا بالامر ورفضوا تسليم البضائع الواجب تسليمها الا اذا قبل النصارى ان يزيدهم في الثمن معتدمين في ذلك على الامر السابق بشان التاجيل الجبري. وتوالت اجتماعات مجلس الوزراء وكان يحضرها شيتهام للبحث فيما يختص بالازمة المالية.
وفي 26 اكتوبر 1914 صدر امر بانتهاء التاجيل الجبري فساءت الحالة المالية. حتى انه بلغت البروتستات التي اقيمت على التجار في النصف الاخير من نوفمبر 1914 حوالي 2500 في دائرة محكمة مصر المختلطة، 1500 في دائرة محكمة الاسكندرية المختلطة، 550 في دائرة محكمة المنصورة المختلطة.
وامتنعت الاموال عن التجارة وهذا ادى الى اضطراب في السوق المصرية وكان ذلك بالاضافة الى امتناع كثير من الناس عن شراء كل ما لم يكن ضروريا جدا من الاسباب التي دعت كثيرا من المحلات التجارية الكبرى الى تقليل مصاريفها قدر الامكان ولو برفت مستخدميها. وبناء على ذلك ايضا اجلت الحكومة كل المشروعات التي كانت قد بدات في تنفيذها. وكان هذا وامتناع البنوك عن فتح حسابات جارية داعيا لزيادة الربكة المالية، وبعد ان وقفت حركات البنوك الخاصة بالتسليف على الغلال اصبحت مخزونة في شون البنوك كرأس مال ميت غير قابل للتداول ولا للاستفادة منه. هذا عن المعاملات الداخلية اما الخارجة فقد وقفت وقوفا تاما حتى انه لم يتمكن الناس من دفع ما عليهم الى الخارج او تحصيل ما لهم هناك بينما قلت الاموال المتداولة بين الناس في القطر وقلت بالتالي الثروة التي يملكونها. والنتيجة ان اقبل الناس على بيع حليهم ليدفع بعضهم ديونه التي حلت آجالها وليقتات البعض الاخر باثمانها، وكان من اثر ذلك ان انخفضت اثمانها بزيادة عرضها.
اعتمدت مصر في نظامها النقدي على الذهب لكن ليس معنى هذا انه لم يكن لديها قبل الحرب اوراق نقدية. فقد خول للبنك الاهلي منذ انشائه حق اصدار هذه النقود الورقية لكنها لم تكن الزامية بالرغم من انها كانت قابلة للصرف بالذهب. فان المصريين لم يطمئنوا الى هذه العملة واقتصر استخدامها على فئات قليلة من اهل المدن وعلى الاجانب "لذا ظل تداولها محدودا بحيث لم يزد الموجود منها قبل نشوب الحرب العالمية الاولى عن 3.200.000 ج وقد نص قانون البنك الاهلي على ان يكون غطاء اوراق النقد على اساس النصف من الذهب والنصف الاخر من اوراق مالية تحددها الحكومة المصرية".
وكانت اوراق البنكنوت هذه بمثابة نقود اختيارية وذات اهمية ثانوية. اما نقود الودائع فلم يكن لها اهمية تذكر ويرجع قلة اقبال الشعب على استعمال البنكنوت او نقود الودائع الى وفرة النقود الذهبية. ثم الى قلة خبرة الافراد بالشئون النقدية، وكانت شئون النقد اولى المسائل التي اولتها السلطات اهميتها. فقد كان الذهب النقد القانوني للمدفوعات الت يتزيد عن جنيهين. وكانت الحاجة في بداية الحرب ماسة الى هذا العون اولا لحلول موسم القطن – كانت مصر تستورد النقود الذهبية من انجلترا في الشتاء وتحتفظ بها لتمويل محصول القطن حتى نهاية الموسم ثم تعيد تصدير اغلبها في الصيف. والواقع أن جزءا كبيرا من هذه النقود الذهبية المستوردة لم يكن ثمنا للصادرات وانما بمثابة قروض تمنحها لتمويل محصول القطن – ودفع ثمن المحصول، ثانيا لضرورة وجود مزيد من الذهب بدلا عن البنكنوت خشية الاندفاع على البنوك.
واصبح من الضروري، ومن اللازم النظر في طريقة توفير النقود والتي تتداولها الايدي سواء كان لتمكين البنوك من دفع قيمة ما هو مودع في خزانتها للذين تزاحموا على ابواب البنوك او لتقديم النقود الصغيرة للاهالي. علاوة على ما هو مطروح للتبادل بينهم حتى تسد هذه النقود حاجة البلاد اثناء بيع القطن. وتحل محل الذهب الذي كان يرد لنفس هذا الغرض. والذي اصبح من الصعب استيراد الكميات المطلوبة منه تلك التي كانت تصل اليها كل عام في المواسم التجارية. وكان لابد من مد السوق بالنقد لمواجهة الطوارئ. واتخذت الاوراق التي يصدرها البنك الاهلي اساسا لهذا النقد بشرط عدم تقديم كميات كبيرة منها للصرف حتى لا يستنفد الرصيد الذهبي. وفي 2 اغسطس صدر قرار بجعل اوراق البنكنوت الصادرة من البنك الاهلي لها نفس القيمة الفعلية للنقود الذهبية.
وصرح البنك الاهلي باصدار البنكنوت دون مراعاة ان يكون له الغطاء الذي نص عليه القانون والغى حق حاملها في استبدالها ذهبا، وقد كانت هذه الاوراق النقدية مغطاة الى 50% بالذهب والنصف الاخر بسندات على الخزانة المصرية لغاية 2.350.000 ج.م. أصدرت خصيصا لهذا الغرض وذلك لمعالجة ندرة النقود وقلة الائتمان اللذين نشأ بسبب الحرب.
واصبح الافراد ملزمين بقبول البنكنوت في التعامل باي مقدار دون قيد او شرط. واعفى البنك الاهلي من التزامه بدفع مقابل النقد ذهبا، وصار النقد المصري نقدا الزاميا يسيطر عليه البنك.
تبع ذلك ان اعتمدت الحكومة لتمويل محصول القطن على البنكنوت بعد انقطاع قدوم الجنيهات الذهبية اللازمة لتمويله. ولما كان فرق السعر القانوني لاوراق البنكنوت لم يكن كافيا، وللافراد الحق في مطالبة بنك الاصدار بصرف قيمة اوراق البنكنوت بالذهب، لاجل هذا وذاك فرض السعر الالزامي لاوراق البنكنوت المصرية، وكانت النتيجة هو الانتقال من مرحلة النقود الاختيارية الى المرحلة الالزامية.
زاد النقد المتداول – البنكنوت – في مصر زيادة كبيرة. وقد كان لوجود الجيوش التابعة للامبراطورية البريطانية في مصر عاملا كبيرا في الاقبال على اموال البلاد اقبالات غير معتاد فتقول صحيفة السفير "ان وجود عدد كبير من الجنود البريطانيين في البلاد عاد بالنفقات الكثيرة على مصر ولم تقتصر الفائدة على المدن والجهات التي حشد فيها الجند، بل ان طلبات الجيش العديدة التي تبادلت العمال والعلف والمؤن والنقليات والمهمات على اختلاف انواعها اوجدت حركة رائجة في مصر".
كذلك كان لارتفاع اسعار القطن من 14 ريال سنة 1913 الى 38 ريال في 1916 الى 90 ريال في 1919 عاملا آخر في زيادة البنكنوت، وفي الامكان تقدير الزيادة في الموارد المالية فمثلا كانت تؤخذ ارقام ميزان التجارة من صادر ووارد – وقد زادت الصادرات على الواردات وكان الميزان التجاري في صالح مصر – يضاف اليها المبالغ التي وردت البلاد للحاجات العسكرية فتبين الزيادة الملحوظة في البنكنوت، ايضا زادت المبالغ المودعة في البنوك وفيها استخدم لوفاء الديون ثم في الزيادة في رؤوس الاموال المشغلة في الخارج، وعلى سبيل المثال فقد زادت رؤوس الاموال المصرية بعد اعلان الحرب بسنتين ونصف زيادة تبلغ نحو 30 مليون جنيه. وفي هذا المبلغ زيادة عشرة ملايين في السندات المحفوظة مقابل اصدار اوراق البنكنوت.
من هذا نرى بداية انخفاض قيمة النقد الورقي وازدياد الطلب على العملة المصرية لشراء القطن ثم لارتفاع اسعاره ولتغطية احتياجات القوات البريطانية ثم ازدياد الصادرات على الواردات سبب ذلك كله – وطبقا لقانون جريشام – ان اختفى الذهب من التداول لانه اضحى عملة جيدة واصبح البنكنوت وهو النقود الرديئة الاداة الرئيسية للتعامل.
ولما زاد النقد المتداول ولم يقابله الرصيد الذهبي بل لم تستطع مصر صرف رصيد في الحصول على السلع الاجنبية فاوجد هذا الوضع حالة من التضخم المالي وهو مرض نقدي عبارة عن الزيادة غير الاعتيادية في كمية النقود المتداولة ومن نتيجته ان يعتري الوحدة النقدية انخفاضا في وقتها الشرائية، واصبح البنك الاهلي لا يحول البنكنوت بالذهب، والعملة المصرية غير قابلة بان تستبدل بالذهب، وصار الفلاحون – والمصريون عامة – ملزمين بقبول البنكنوت في التعامل وبدون قيد او شرط وحل الجنيه الانجليزي محل العملات المصرية والاجنبية في التداول.
وقد قاسى الشعب من تداول هذه الاوراق فلم يكن معتادا عليه ان يستبدل العملة التي كان يستعملها هو وآباؤه واجداده بعملة اخرى وكثرت الحوادث التي دلت على جهل المصريين لاستعمال هذه العملة فلم يكن المصري يتصور كيف اختفى الجنيه الذهب من جيبه وحل مكانه قطعة من الورق فاعتبر ان الدنيا قلت خيراتها باختفاء الذهب من يده وبغلاء الاسعار، فالمصريون جميعا لا يودون التعامل بالورق حتى المتمدنين لا يثق الا بالذهب والفضة فما بال الفلاح القروي الذي لم ير في مدة حياته هذا الورق، واذا قيل له ان "الفلوس ابدلت بالورق سخر من قائله وضحك ولا يمكن ان يصدقه" وراحت الحكومة تسن قوانين العقوبات لمن لا يقبل التعامل بهذا الورق.
وتعددت الحوادث وامتلأت بها صحافة الفترة قد حدث ان ثلاثة اشخاص قطعوا ورقة بنكنوت ذات عشرة جنيها الى ثلاثة قطع متساوية لكل واحد منهم قطعة تقول الشعب: "ان اوراق البنكنوت كثرت ويرى الجمهور مصاعب في صرفها ومهم من دفع عشرة قروش عن ورقة ذات خمسة جنيهات". وتذكر الاهرام: "ان الحمار اكل رغيف صاحبه وكان في الرغيف ورقة بعشرة جنيها، وقالوا ان رجلا وضع الورقة ثمن قطنه الى جانبه فاخذتها امرأته واحرقتها تحت ابريق الشاي، وحدث ان وجدت امرأة تحت وسادة زوجها ورقة نقدية فاعتقدت ان احدا يسحر لها ليبعد عنها زوجها فاخذتها وحرقتها ورمتها في الترعة".
واشتد الاقبال على الفضة مما ادى الى ندرة هذه العملة الصغيرة، فتقول الاهرام: "اما الازمة الفضية فيشكو من اشتدادها الخاص والعام في هذه الايام وكثير من التجار يحرمون من اشياء كثيرة لعدم وجود نقود فضية عندهم لاكمال ما يدفع لهم من الاوراق، فاذا اشترى المشتري بضاعة بثلاثين قرشا واعطى التاجر ورقة بقيمة خمسين قرشا لا يجد التاجر في خزاته عشرين قرشا فضية لتسوية الحساب فيضطر الى استرداد المبيع".
ونتيجة لازيداد الطلب ارتفع مقدار ما ضرب من هذه العملة من 2 مليون جنيه عام 1914 الى 7 مليون جنيه في فبراير سنة 1918. وهذا بالرغم من ان العملة الفضية عملة خصوصية وكان من المفروض الا تصيبها الازمة. وقد ارجع السبب في الازمة الفضية هذه الى وجود القوات الانجليزية في مصر، فازداد الطلب عليها، هذا بالاضافة الى اجر العمال الذين استخدمتهم السلطة العسكرية. واخيرا اضطرت الحكومة الى ادخال كميات من الروبيات الهندية.
وطلب بنك انجلترا من البنك الاهلي الموافقة على احلال السندات البريطانية محل الذهب كرصيد لاصدار البنكنوت، وتبع ذلك ان اخذ نظام العملة المصرية ينتمي الى نظام الاسترليني وتحول عن قاعدة الصرف بالذهب.
وهكذا اجازت الحكومة المصرية للبنك الاهلي حق اصدار اوراق البنكنوت من غير ان يكون ملزما بالاحتفاظ في خزائنه بما يعادل نصف قيمتها من الذهب – وبمقتضى هذا تمكن انجلترا من الحصول على النقد المصري اللازم لها لشراء محصول القطن وغيره من الغلات المصرية ثم لسداد نفقات جيوشها بالقطر المصري دون ان تصبح بها حاجة الى التنازل عن جزء من الذهب الذي في حوزتها. ولا ريب ان مثل هذا الوضع جعل في يدها قوة شرائية لا حد لها – وثبت سعر صرف الجنيه المصري الاسترليني رسميا. فالبنك الاهلي اصبح مستعدا للقيام بالتحويلات دون تقاضي تكاليف تزيد عن اجر البرقية والمصاريف الفعلية هذا بالاضافة الى اطلاق حرية تحويل احد النقدين الى الاخر بسعر التعادل 97.5 قرش دون قيد او شرط. كذلك قرر وزير المالية ان "الونيتو" يقبل في المعاملات على ان يكون تداوله اختياريا بسعر 77.15 قرش وان تقبله الخزانة المصرية دون قيد او شرط. وبهذا اصبح هناك فرق بين الجنيه المصري وبين الونيتو اذ اصبح الجنيه الانجليزي له سعر قانوني بينما الونيتو له سعر اختياري، كذلك تقرر تداول الجنيه الانجليزي بقانون بينما الونيتو بقرار وزاري.
وبهذا اصبح اصدار البنكنوت في مصر يتم مقابل تسلم البنك الاهلي اذونات الخزانة البريطانية او ايداع جنيهات استرلينية لحساب البنك في لندن وبذلك انقضت الرقابة على البنكنود المصدر وارتبط بالجنيه المصري بالاسترليني. وتعرض الاقتصاد المصري لاي اضطرابات نقدية في انجلترا فمثلا عندما تدهورت قيمة الجنيه الاسترليني بالنسبة للذهب في نهاية الحرب العالمية الاولى تدهورت بالتالي قيمة الجنيه المصري وحينما صدرت انجلترا مقادير كبيرة من الذهب لسداد ديونها انخفضت الى ابعد مدى قيمة وحدة عملتها. ومن المساوئ ايضا ان بيع القطن كان بسبب هذه القروض مرتبطا مقدما والى حد كبير بالسوق البريطاني، كما ان مصر لم تكن في نهاية اجل هذه القروض تجد غير صادراتها – القطنية في الغالب – لتسدد بها ما عليها.
وهكذا قضى على سوق مصر المالية وتحول عماد التعامل من الوحدة المعدنية الذهبية الى الوحدة الورقية الالزامية، واصبح اساس الثقة والاعتمادات ووثائق الائتمان معتمدا على الوحدة النقدية الاسترلينية بدلا من الذهب ، وبذلك غدت مصر جزءا من الكتلة الاسترلينية وسيطرت انجلترا على المعاملات في داخل مصر وخارجها اذ اصبحت مصر لا تستطيع ان تستورد ما يلزمها الا من منطقة الاسترليني. وكنتيجة للاجراء النقدي السابق ازداد التضخم المالي، فقد ترتب على تثبيت سعر الصرف بين انجلترا ومصر ان ارتبط الجنيه المصري بالانجليزي وبالتالي اصبح البنك الاهلي يشتري الكمبيالات المسحوبة على لندن بسعر التعادل ثم يصدر مقابلها اوراقا نقدية في مصر ويودع ما يعادلها من اذونات الخزانة البريطانية. وقد نجم عن هذا التضخم ارتفاع نفقات المعيشة اذ زادت من 100 سنة 1913 الى 212 سنة 1918.
وقد ارجع كل هذا الى عدم وجود نظام مصرفي مصري مستقل ينظم علاقة المصارف كلها ويجعلها تحت اشراف بنك مركزي.فكان من نتيجة ذلك عدم استقرار سياسة الائتمان كذلك كانت البنوك في مصر متخصصة في تمويل التجارة الخارجية وفي اعمال الرهونات فحرمت الزراعة والصناعة من الحصول على الاموال اللازمة لها باسعار فائدة معقولة.
ظل تفضيل الجمهور للنقود المعدنية ظاهرا باستمرار الطلب عليها – بالذات الفضة والنيكل – وقد لاقت الحكومة مصاعب كبيرة دون الحصول على اللازم من النقود الجديدة لسد الطلبات، فرغم استيرادها للروبيات الهندية ظلت الحاجة لذا ضربت نقود جديدة، ففي اكتوبر 1916 وجه السلطان حسين خطابا الى نائب الملك طالبا التصريح للحكومة المصرية بضرب نقود جديدة ورغم ان كل دولة – من المفروض – ان تكون حرة في اصدار عملتها بالشكل الذي تراه وبالرسم الذي تفضله الا ان انجلترا – ككل اجراء لها – لم تدع لمصر الحرية في ذلك وانما قيدتها في صك هذه العملة وفي رسمها ووزنها وسعر تداولها.
من هذا نرى الى اي حد ساءت حالة السوق المالية. وانتشر مبدا الفرض انتشارا عظيما وقد ارجع ذلك الى ان الاموال التي بالسوق المالي بمصر اجنبية والذين يديرون دفتها اجانب، فليس بين البنوك العديدة في مصر بنك يعتبر وطنيا. فكلها ملك للمساهمين الاجانب او فروع لبنوك اوروبية، فاي ازمة خارجية يكون لها اصداءها القوية في مصر. هذا بالاضافة الى طريقة التقييد الخاصة باصدار الاوراق المصرفية – البنكنوت – ذلك ان الاصدار قاصر على مصرف واحد وهو البنك الاهلي، وبما ان مقدار النقود يتغير في فصول السنة تبعا لحركة الاسواق المالية الاجنبية فكان حقا ان تتبع في اصدار الاوراق المصرفية هذه طريقة وسط بين الاباحية والتقييد حتى يمكن التمكن من زيادة هذه الاوراق او انقاصها حسب ما تقتضي الحالة.
مع بداية الحرب ظهرت دعوة جديدة تهاجم الوضع المالي للبلاد وتطلب الاستقلال المالي والاقتصاد فتقول الجريدة: "الواقع ان علاقتنا المالية بالدول المحاربة علاقة تابع ومتبوع، فاننا في سوقنا المالية لسنا الا غرباء، ان حالتنا المالية في السوق المصرية حالة منفعلة غير فاعلة وتابعة غير متبوعة لانه ليس لنا فيها راي مسموع ولا فعل ما. فالذعر لحقه ثقة الناس بالبنوك الاجنبية التي هي البنوك الوحيدة في مصر".
وتسطر الشعب: "لو كانت تلك المصارف مصرية لما اقفلت ولما تاخر بعضها عن دفع الاموال الت يهي حق شرعي من حقوق الوطنيين ولو كانت حقيقة مصرية لاستمرت الاعمال في سيرها ولما توقف تيار الحركة كهذه الايام السيئة. لو كان لنا بنك وطني يدير عملة في بناء البلد لكان الآن في بحبوحة من العيش ترفع باسم ذلك المصرف الوطني وتقترض منه في تلك الازمة حتى تنتهي الحرب".
وتبعتها بقية الصحف في ضرورة انشاء بنك وطني لحماية الحياة الاقتصادية والمالية في مصر وقد اخذ طلعت حرب منذ بداية الحرب يدعو وينادي لانشاء بنك وطني وكان قبل الحرب قد اسس شركة التعاون المالي. فلما انعقدت الجمعية العمومية لهذه الشركة في شهر مايو 1915 وقف فيها خطيبا واخذ يتكلم عن شئون البلاد الاقتصادية وما اصابها بسبب اعتمادها على الغير في كل معاملاتها وعدم اعتمادها على نفسها بانشاء المصارف والبيوت المالية واظهر مساوئ البنوك الاجنبية وبين ضرورة مساهمة الرأسمالية المصرية في تاسيس بنك مصري.
اما عن دور السلطة العسكرية بالنسبة للبنوك اثناء الحرب فانها لم تخفف يدها وسلطت سلطتها عليها وتدخلت في امورها. ومن مظاهر هذا التدخل حظرها على هذه البنوك دفع مبالغ مباشرة للاشخاص المعتقلين بمصر الا بتوقيع قومندان المعسكر الذي يكون صاحب (الشيك) معتقلا فيه. وقد حظرت هذه السلطة ايضا على تلك البنوك معاملة الموجودين في بلاد اعدائها بمقتضى منشور اصدرته في 25 يناير 1915.
وقد حددت السلطة بمقتضى اعلان عرفي صادر في 13 يونيه 1916 شكل الاقرار الذي يجب على كل شخص مكلف بدفع الارباح الخاصة بالسندات التي لحاملها او يدفع قيمة السندات المستهلكة ان يطلب تقديمه من المنتفع.
وبالنسبة لمالية الدولة، فقد تاثرت الحكومة بقيام الحرب تاثيرا كبيرا، فالدولة تعتمد على اعتمادا كليا على القطن في اقتصادها، ومنذ ان بدات الحرب هبطت اساعره ونقص محصوله وهو اهم صادرات مصر. وكان من نتيجة ذلك وقوف الحركة التجارية، ومن هنا ضعفت ايرادات الخزانة، وظهر العجز جليا، وابواب هذا العجز كانت متعددة فالرسوم الجمركية هبط دخلها هبوطا كبيرا وكادت تقفل ابوابها بسبب وقوف حركة التجارة والنقل وقطع العلاقات مع اعداء انجلترا. ورسوم الموانئ والمنائر مسها الضرر وذلك لتنقاص عدد السفن التجارية التي تطرق ثغور مصر البحرية. والرسوم القضائية والقيدية التي كان نقصها لقلة المعاملات التي تدعو الى التقاضي وقلة عقود نقل الملكية. هذا بالاضافة الى صدور الامر العالي بتاجيل القضايا وتوقيف الاحكام بالبيع الجبري، واخذت ايضا ابواب ايرادات السكك الحديد تنقص من خمسة عشر الف جنيه الى خمسة آلاف. اذ تاثرت من عجز محصول القطن وجمود حركة المبادلات التجارية. فمنذ الثالث من اغسطس 1914 قررت مصلحة السكك الحديدي ان تنقص عدد قاطرات الركاب والبضائع وقللت سرعتها خشية ان يطول زمن الحرب وينفذ الفحم الذي في مخازنها مع عدم استطاعتها جلب فحم من اوروبا اما لتعذر نقله او لغلاء ثمنه، كذلك اوقفت المصلحة الاعمال الهندسية فيها وذهبت الى ابعد من ذلك اذ اغلقت بعض محطاتها، واقتصدت في المواد والادوات التي تصنع منها المركبات لارتفاع اثمانها. ونقصت ايضا ايرادات البريد والتلغراف التي اثر فيها وقوف دولاب الاشغال بوجه عام، ومس النقص ايجار الاملاك الاميرية ومتحصلاتها التي تاثرت من جراء هبوط اسعار القطن.
وارسلت وزارة المالية لجميع المصالح تطلب الاقتصاد الكلي في المصروفات العمومية، واوقفت ايرادات الاعتمادات لكل وزارة وكل مصلحة، وبالتالي بدات الوزارات في الاقتصاد في نفقاتها، فقررة وزارة الاوقاف توقيف جميع اعمال المباني والاكتفاء بعمل الترميمات الجزئية التي تستلزم نفقات كثيرة. وتبعتها بقية الوزارات فاوفقت وزارة الاشغال معظم اعمالها الخاصة بالري، واقفت كل العقود الخاصة بالمصارف والسدود وبالذات في منطقة الوجه البحري وذلك بسبب نقص الايرادات، وذهبت الوزارة الى ابعد من ذلك فوفرت العدد الكثير من المستخدمين وتتصور الحالة التي يصيرون اليها وهم وعائلاتهم في الحال الحاضرة من الضيق والعوز فتدعل عن هذا القرار". وعلى الفور كونت لجان خصصية لدرس احتياجات كل وزارة في هذه الظروف الصعبة.
وفي اول مشروع ميزانية عام 1915 نقصت الايرادات عن العام الذي قبله مبلغ 2.923.000 جنيه، أما المصروفات فقد وفرت المالية 12.000 جنيه من بند الماهيات والاجور والمرتبات بسبب الغاء بعض الوظائف ومنع الترقيات والعلاوات وانخفض معدل اصدار الصحف وعدل عن انشاء المدارس واوقفت البعثات التعليمية والغيت اعانات الطلبة واقفلت المعامل الخاصة بالمصل واقتصد من اغذية المسجونين.
اما عن الزيادة فقد كانت الحربية لها النصيب في ذلك بسبب دخول مصر الحرب وايضا زيد البوليس ومجلس الوزراء والجمعية التشريعية والدواوين.
وهذه الزيادات لم تكن من مصلحة المصريين الذين طردوا من اعمالهم واصبحوا لا متوى لهم.
وفي عام 1916 زات ايرادات الدولة من السكك الحديدية والجمارك والدومين والبريد والارباح الناجمة عن مبيع القطن واصدار البنكنوت وسك نقود فضية، اما المصروفات فقد نقصت حتى انها تركت مجالا لاجراء اقتصاد كلي شمل جميع المصالح الاميرية. فالغيت كثير من الوظائف وكثير من الاعمال اصبحت مربوطة لحساب السلطة العسكرية كمصلحة المساحة والمطبعة الاميرية. وبالرغم من هذا الاقتصاد الا ان وزير المالية كان كثيرا ما يرسل للمصالح والوزارات يطلب المزيد والمزيد.
الخصخصة
وقع الجفاء بين الخديوي ونوبار باشا على إثر موقف الأخير من مسألة رجوع إسماعيل باشا الخديوي الأسبق إلى مصر، فقد ساءت حالته الصحية في أوائل سنة 1895 وأرسل إلى حفيده عباس حلمي لكي يأذن له بالعودة إلى مصر لمراعة صحته وشيخوخته، وكان عباس يميل إلى تحقيق هذه الرغبة، ولكن وزارة نوبار وجدت أن رجوع إسماعيل من منفاه غير مرغوب فيه من جانب الاحتلال، فرفضت الموافقة على عودته بحجة أنها تخلق لمصر عقبات من جانب الدول التي اشتركت في خلعه، فأسرها عباس في نفسه، وأخذ المرض يلح على إسماعيل حتى توفي يوم 2 مارس 1895، وقد رغب عباس في أن يختلص من وزارة نوبار في تلك السنة ولكن نوبار كان مؤيداً من الاحتلال، فلم يفكر في الاستقالة، فأسرها عباس في نفسه مرة أخرى، وأخيراً توصل إلى تنفيذ أمنيته في إقصاء نوبار، بأن أعرب للورد كرومر عن رغبته في إعادة مصطفى فهمي باشا المشهور بولائه للاحتلال إلى رئاسة الوزارة، وكان الخديوي قد أخذ من ذلك الحين يجنح لمسألة الاحتلال ويختم عهد المقاومة والأزمات، فلقيت الفكرة ارتياحاً في نفس اللورد كرومر الذي كان لا يفتأ يترقب الفرص لعودة مصطفى فهمي إلى رئاسة الوزارة، لأن الإنجليز لا ينسون صنائعهم، فلما أحس نوبار بهذا الموقف قدم استقالته يوم 11 نوفمبر سنة 1895، والف مصطفى فهمي الوزارة الجديدة في اليوم التالي، واحتفظ ببقية الوزراء الذين كانوا مع نوبار، وأضاف إليهم محمد العباني باشا وزيراً للحربية، فصارت مؤلفة كما يأتي: مصطفى باشا للرئاسة والداخلية، حسين فخري باشا للأشغال والمعارف، بطرس غالي باشا للخارجية، أحمد مظلوم باشا للمالية، إبراهيم فؤاد باشا للحقانية، محمد العباني باشا للحربية والبحرية، وهي وزارة الاستسلام والولاء المطلق للإنجليز. وقد بقيت في الحكم حتى نوفمبر سنة 1908، أي أنها دامت ثلاثة عشر عاماً، كانت خضوعاً وتسليماً للاحتلال البريطاني.
كان عهد الوزارة حلقات متصلة مترابطة من التسليم في حقوق البلاد ومرافقها. ففي سنة 1897 طلب اللورد كرومر تعيين إنجليزي نائباً عمومياً بدلاً من حمد الله وصارت سلطة النيابة وهيئتها تحت تصرف النائب العمومي الإنجليزي كما كانت وزارة الحقانية تحت سيطرة المستر سكوت المستشار القضائي البريطاني.
- إنشاء البنك الأهلي:
وفي سنة 1898 صدر المرسوم بتأسيس البنك الأهلي وأعطته الحكومة امتياز إصدار أوراق النقد المصري، فصار بمثابة بنك الحكومة، وهو بنك أهلي شكلاً واجنبي فعلاً، ومؤسسوه وحملة أسهمه الأولى هم السير إرنست كاسل المالي الإنجليزي الشهير والمسيو سلفاجو وشركاؤه والخواجة روفائيل سوارس وإخوته.[7]
- بيع البواخر الخديوية:
وفي تلك السنة ذاتها (سنة 1898) عقدت الحكومة صفقة كانت وبالاً وخسراناً على مصر، ونعني بها بيع البواخر الخديوية بأبخس الأثمان إلى شركة ألن وألدرسن الإنجليزية. وبيان ذلك أنه كان للحكومة بواخر تعرف ببواخر البوستة الخديوية عددها إحدى عشر باخرة كبيرة، منها ثلاث بواخر اشترتها الحكومة حديثاً من مصانع إنجلترا وهذه البواخر هي: الشرقية، الفيوم، المحلة، الرحمانية، شبين، توفيق رباني، البرنس عباس، القاهرة، مصر، النجيلة، وهذه البواخر كانت قوام الأسطول الإنجليزي لمصر في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، والبقية الباقية للبحرية المصرية، وكانت تنقل المسافرين والمتاجرين بين مصر وثغور هذين البحرين، حاملة العلم المصير، مؤدية مهمتها في بعث النشاط الاقتصادي التجاري وبسط نفوذ مصر التجاري والبحري في هذين البحرين، ويتبع هذه البواخر حوض الإسكندرية الكبير، وحوض الإسكندرية الصغير، وحوض السويس وهذه الأحواض معدة لإصلاح البواخر، ويتبعها أيضاً مستودعات المصلحة ومخازنها ومعاملها ومحلات الإدارة والزوارق البخارية واللنشات، وقد قدرت قيمة البواخر وهذه الملحقات جميعها بثلاثة ملايين جنيه، فباعت الحكومة جميع هذه المنشآت إلى شركة ألن وألدرسن بثمن بخس، 150.000 جنيه، فكانت صفقة خاسرة من جميع الوجوه، لأنها أضاعت على البلاد ثروة قومية ضخمة ليس من السهل أن تستردها، وانطوت بذلك صفحة البحرية المصرية إلى وقت طويل، وقد تم البيع دون مزايدة أو إشهار، بل حصلت المخابرة بشأنه في الخفاء بين السير إلوين بالمر المستشار البريطاني للحكومة المصرية وشركة الن وألدرسن الإنجليزية، وأقر مجلس الوزراء هذه الصفقة الخاسرة، دون بحث أو تحقيق، واكتفى بالبيانات التي أفضى بها المستشار الملاي، ووقع على العقد أحمد مظلوم باشا وزير المالية، ومما يجدر ملاحظته لتقدير مبلغ الغبن الذي أصاب الحكومة من هذه الصفقة أن ثلاث بواخر من الإحدى عشرة باخرة المبيعة اشترتها الحكومة من مصانع إنجلترة بـ"200.000 جنيه"، أي أن ثمن الصفقة كله اقل من ثمن هذه البواخر الثلاث، وكانت علة الحكومة الظاهرة بي بيع هذه البواخر والمنشآت أن مصروفاتها تزيد على إيراداتها، وفضلاً عن أن هذا ليس مسوغاً لإضاعة ثروة البلاد القومية، فقد ثبت من مراجعة حسابات المصلحة أن صافي إيرادها السنوي بعد جميع المصروفات هو 22.000 جنيه، فإذا لوحظ أن الحكومة تعهدت بأن تعطي الشركة سنويأً ستة آلاف جنيه في السنة فيكون صافي ربح البواخر 28.000 جنيه سنوياً، ويكون البيع قد وقع بقيمة الربح مدة خمس سنوات تقريباً، وهذا أفظع مظهر للغبن الفاحش.
كان في بيع هذه البواخر القضاء على الأسطول التجاري لمصر، بعد القضاء على أسطولها الحربي، وظهر الفرق جلياً بين حالتها في عهد الاحتلال وحالتها في عهد محمد علي حين زارها الكاتب الإيطالي بنديتي سنة 1840، فراعه منظر السفن الحربية مصفوفة على أتم نظام في ميناء الإسكندرية، حيث قال في وصفها:
- بيع أملاك الدائرة السنية:
باعت الحكومة في هذه السنة تفاتيش الدائرة السنية، وكاتن أملاكها الزراعية تبلغ نحو ثلثمائة ألف فدان، يتبعها تسع معامل كبيرة لعصير القصب وصناعة السكر، باعتها إلى شركة سوارس مقابل ثمن قدره ستة ملايين وأربعمائة ألف جنيه، وهو قيمة الدين الذي كان على الدائرة في ذلك الحين، وكانت صفقة خاسرة لما فيها من الغبن الفاحش على الحكومة والربح الهائل للماليين الأجانب.
- الشروع في بيع سكك حديد السودان:
والظاهر أن سنة 1898 كانت بمثابة سنة التصفية، ففضلاً عن إنشاء البنك الأهلي وبيع البواخر الخديوية والدائرة السنية، شرع المستشار المالي البريطاني في بيع سكك حديد الحكومة في السودان إلى شركة إنجليزية، بحجة حاجة الحكومة إلى المال لتدبير نفقات الحملة على السودان، فاعترض الخديوي على هذا البيع، ولما رأى إصرار اللورد كرومر على عقد الصفقة استنجد بتركيا بحجة أن هذه السكك الحديدية هي من أملاك مصر التي نص فرمان توليته على عدم جواز التصرف فيها أو التنازل عنها، وأبرق إلى سلطان تركيا يعرض عليه الأمر ويطلب منه النجدة فجاءه الرد بشكره وإقراره على موقفه باعتبار أن السكك الحديدية أنشئت للجيش وأن بيعها مخالف للسيادة التركية، فتراجع اللورد كرومر وتقرر عدم البيع.
حسين كامل: 1914-1917
اما ميزانية عام 1917 فارتفع فيها رصيد الدولة، واصبح دخل مصر الصافي الذي قدر ب35 ملون جنيه يستغل في قروض حرب الحلفاء. ووضعت السياسة الادارية تحت صرف السلطة التي "ساعدت الانجليز بينما اهملت العناية بالاشغال العامة التي تخص البلاد" وازدادت بعض الايرادات في هذه الميزانية بسبب ارتفاع الاسعار وانصبت على الجمارك والسكك الحديدية والاملاك الاميرية. وبالنسبة للمصروفات فقد ازدادت بفتح اعتمادات اضافية وارتفاع الاجور ومصاريف الاشغال العسكرية للجيش وانشاء فرق جديدة وثكنات.
فؤاد الأول: 1917-1936
وفي ميزانية 1918 ارتفعت المصروفات فيها بسبب اعمال الحرب وتصاعد الاسعار، كما توقفت معظم الاعمال للاقتصاد هذا من ناحية، ومن اخرى فان طلبات السلطة العسكرية للعمال جعلت كثيرا من الاعمال توصد ابوابها، واصبح الفرق واضحا بين سنوات الحرب وسنوات ما قبل الحرب. فايرادات مصر ومصروفاتها ارتفعت في عام 1917/1918 الى 23.166.074 جنيها، و22.296.948 جنيها بينما كانت في عام 1913/1914 هي 17.703.898 جنيها، 17.656.961 جنيها كذلك الاحتياطي فقد وصل في ابريل 1918 ما يبلغ 6.770.179 جنيها بينما كان في ابريل 1914 هو 5.103.549 جنيها.
من المفيد أن نلاحظ أيضاً ما طأ من تغير على معدل تدفق رؤوس الأموال الأجنبية الخاصة إلى مصر في هذه الفترة، إذ قد لا يخلو هذا من مغزى بالنسبة لظروف مصر الراهنة، لما يفصح عنه من تأثر هذا التدفق بالظروف السياسية الداخلية وبتغير الظروف السياسية والاقتصادية خارج مصر. فطوال السنوات العشر التالية لبدء الاحتلال (83-1892) لم تطرأ اية زيادة تذكر على حجم الاستثمارات الأجنبية الخاصة في مصر إذ بقى هذا الحجم ثابتاً تقريباً عند 6 مليون جنيه. والراجح أن الاستثمار الأجنبي الخاص كانت ينتظر تحقق الاستقرار السياسي في مصر بعد ثورة عرابي وعزل الخديوي، كما كان ينتظر إصلاح المالية المصرية، والاطمئنان على قدرة الاقتصاد المصري على توليد فائض من العملات الأجنبية تكفي لخدمة الديون وتحويل الأرباح. فما إن تحقق هذا الاستقرار، واطمأن المستثمرون على استمرار الاحتلال، وزاد تفاؤلهم بإمكانيات زيادة الدخل، حتى قفزت الاستثمارات الأجنبية الخاصة في السنوات الخمس التالية بنحو الضعف (من نحو 6 مليون جنيه في 1892 إلى 11.4 مليون في 1897)، ثم تضاعفت مرة أخرى في السنوات الخمس التالية (إلى 22.1 مليون في 1902). ثم قفز الاستثمار الأجنبي مرة أخرى إلى ما يقرب من ثلاثة أمثاله خلال السنوات الخمس التالية (إلى 60 مليوناً في 1907) بعد أن تم الاتفاق الشهير بين بريطانيا وفرنسا ف 1904، الذي أطلقت بمقتضاه يد السياسة البريطانية في مصر مقابل أن تطلق يد فرنسا في المغرب العربي. تلت ذلك فترة تراخى فيها معدل الاستثمار الأجنبي لم يزد إلا بنسبة 25% خلال السنوات السبع التالية بسبب الأزمة العالمية في 1907، وما ترتب عليها من تضييق سوق الائتمان.
استمرت مصر بعد نشوب الحرب العالمية الأولى في تحقيق فائض في ميزانها التجاري، بل زاد هذا الفائض بشدة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار القطن وصعوبات الاستيراد بسبب ظروف الحرب. فإذا أضفنا إلى ذلك ما انفقته بريطانيا على قواتها المرابطة في مصر، نجد أن مصر استطاعت خلال سنوات الحرب والسنوات التالية مباشرة لها أن تحقق فائضاً متراكماً في ميزان مدفوعاتها يبلغ 139 مليوناً من الجنيهات. ولكن استمرت خدمة الديون تستأثر بنصيب الأسد في استخدامات هذا الفائض، وإذا بهذا الفائض الذي كان يمكن، على حد تعبير مارلو: "أن يحمي مصر من وطأة الكساد العالمي المقبل، وأن يعدها لتحقيق تغير بعيد المدى في جهازها الإنتاجي- تلتهمه أقساط الديون". وهكذا انخفضت مديونية مصر الخارجية في العشرين سنة التالية للحرب الأولى (1914-1934) من 86 مليون جنيه إلى 39 مليوناً، أو ما يمثل 20% من الدخل القومي، بالمقارنة بأكثر من 100% عند بداية الاحتلال الإنجليزي. أي أن مصر دفعت للدائنين الخارجيين خلال هذين العقدين نحو 47 مليوناً من الجنيهات عدا الفوائد. جاءت نقطة التحول الأساسية التالية في تطور ديون مصر الخارجية خلال سنوات الحرب العالمية الثانية، إذ استطاعت مصر خلالها ليس فقط أن تسدد بقية ديونها بل وأن تتحول من دولة مدينة إلى دولة دائنة. ذلك أنه على الرغم من العجز في الميزان التجاري المتولد خلال سنوات الحرب، بسبب انخفاض صادرات القطن، جاء الإنفاق العسكري لقوات الحلفاء في مصر فعوض هذا العجز وزاد عليه، وإذا بمصر تتمكن في 1934 من تحويل ما بقي من ديونها الخارجية إلى دين محلي، الدائنون فيه هم المصريون أو أجانب مقيمون بمصر.
===الملك فاروق: 1936-1952===كانت مصر عندما قامت بتسديد ما بقي من ديونها الخارجية ما زالت ترزح تحت الاحتلال، كما كانت بقيامها بذلك تسدي خدمة أخرى لسلطات الاحتلال التي كانت قد تحولت من دولة تبحث عن مجال لاستثمار فوائض رأس مالها إلى دولة تحتاج إلى استرداد مستحقاتها بل وإلى الاقتراض، فإذا بمصر تنهض بعبء المهمة الثانية كما نهضت بالأولى. كانت بريطانيا قد أنهكتها نفقات الحرب، وبلغت نفقاتها العسكرية في مصر وحدها في سنوات الحرب 314 مليون جنيه، أي نحو ثمانية أمثال إجمالي ديون مصر الخارجية عند بداية الحرب، وكان مما يلائم سلطات الاحتلال إذن أن تسرع مصر بسداد ما بقي من ديونها، التي كان لبريطانيا أكبر نصيب فيها. ووقع عبء هذه المهمة على أمين عثمان وزير المالية في ذلك الوقت، والذي اشتهر بإخلاصه لبريطانيا أكثر مما اشتهر بالوطنية، فقدم مذكرة إلى مجلس الوزراء في سبتمبر 1943 صور فيها "تمصير الدين" على أنه عمل من أعمال الكرامة الوطنية إذ قال: "كان أول ما عنيت به منذ تقلدت وزارة المالية أن أبحث مع الإخصائيين عن خير طريقة لتحويل دين مصر من دين دولي إلى دين داخلي بحت، وبذلك نعدم الدين القديم ونعدم معه ذكرياته السيئة التي جريت على البلاد في الماضي ويلات الاحتلال، وساعدت على تدخل الدول الأجنبية في أخص شئون مصر الداخلية. وفضلاً عما في تحقيق هذا الهدف من إرضاء الكرامة الوطنية، فإنه يرمي إلى تخفيف عبء الدين إلى حد بعيد". وعندما عرض الأمر على مجلس النواب اشتم بعض الأعضاء أن المقصود بقانون التمصير خدمة المصالح البريطانية، وأنه لن يؤدي إلى "تمصير" الدين بالمعنى الحقيقي لهذه الكلمة، ذلك أن القانون المقدم من الحكومة يطرح السندات الجديدة لا على المصريين فقط بل وعلى الأجانب المقيمين بمصر، ومن ثم "فلن تنتج عملية التحويل إلا انتقال هذا الدين من أيدي الأجانب المقيمين في إنجلترا وفرنسا وغيرهما إلى أيدي أجانب مقيمين في مصر، أو أجانب أيضاً مقيمين في الخارج يشترون بواسطة ممثلين في مصر ما يريدونه من سندات هذا القرض عندما يعرض على الاكتتاب العام". ورد أمين عثمان على هذا بقوله:. "إننا لم نلجأ إلى القرض إلا لتتمكن الحكومة من تحويل الدين من قرض دولي إلى قرض مصري، أعني قرضاً بالعملة المصرية يدفع في مصر لا قرضاً لا يكتتب فيه غير المصريين، وإني لأرحب بكل مكتتب في القرض سواء كان مصرياً أم أجنبياً لأني أعتبر الأجنبي مصرياً ما دام يعيش بيننا ويتمتع بخيرات بلادنا، فنحن في هذا السبيل سواء". ووافق المجلس على القانون، وعرضت القروض التي سميت بالقروض الوطنية على الاكتتاب في نوفمبر 1943 وغطيت بكامل قيمتها. وهكذا أسدلت سنوات الحرب العالمية الثانية الستار على مرحلة طويلة كئيبة من تاريخ المديونية المصرية، استغرقت من تاريخ مصر الاقتصادي نمو ثمانين عاماً. فلم يتم سداد الديون الخارجية التي بدأها سعيد باشا في 1862 إلا بقانون تمصير الدين في 1943. وصندوق الدين الذي فرض الرقابة الأوروبية على المالية المصرية في 1876، لم يتم إلغاؤه إلا في 1940. وخرجت مصر من الحرب العالمية الاثنية دائنة لبريطانيا بمبلغ 340 مليوناً من الجنيهات، وعانت مصر الأمرين في استيفاء حقوقها مثلما عانت من قبل في تسديد ديونها. مرة أخرى نلاحظ أن تحول مصر من دولة مكتفية بمواردها إلى دولة مدينة، ثم من دولة مدينة إلى دولة دائنة، لم تحكمه حاجة مصر إلى الاقتراض أو قدرتها على السداد بقدر ما حكمته تقلبات ظروف الاقتصاد الدولي. ففي عصر من الرخاء لم تكن لدى مصر فيه أدنى حاجة إلى الاستدانة لتنمية اقتصادها، أقدمت على التورط في الديون. وفي فترة انكماش وكساد شديد الوطأة في ظل ركود شبه تام في متوسط الدخل، كالذي ساد مصر فيما بين 1913 و1943، قامت مصر بسداد جزء كبير مما سبق لقها اقتراضه.
ثورة يونيو 1952
لقد بين هانسن بدراسته لإحصاءات الدخل القومي المصري خلال الفترة 1913-1956، أن متوسط الدخل القومي عند قيام حرب السويس كان تقريباً عند نفس مستواه عند قيام الحرب العالمية الأولى. فالتقدم الضعيف الذي أحرزته الزراعة المصرية بالإضافة إلى نمو الناتج الصناعي، ضاع أغلبه بسبب اتجاه معدل التبادل الدولي لغير صالح مصر (بانخفاض أسعار القطن بالمقارنة بأسعار الواردات)، والتهمت باقي الزيادة في السكان. فإذا كانت مصر في حاجة ماسة إلى الاقتراض في أية فترة من تاريخها الحديث فقد كانت هي هذه الفترة. ولكن هذه هي بالضبط الفترة التي قامت فيها مصر بسداد ديونها وتحولت فيها إلى دولة دائنة! ذلك أن هذه الفترة كانت هي ايضاً الفترة التي انكمشت فيها بشدة حاجة الاقتصاديات المتقدمة إلى ولوج أبواب الاستثمار الخارجي. فأوروبا كانت مشغولة بالاستعداد أو الإنفاق على الحربين العالميتين، أو بإعادة تعمير ما دمرته الحربان، أو بدفع التعويضات المفروضة على من انهزم في الحرب الأولى، أو بالكساد العالمي الذي حل بها جميعاً في الثلاثينات. والولايات المتحدة كانت منشغلة باستغلال مواردها الاقتصادية الهائلة وسوقها الواسعة. في منتصف الخمسينيات من القرن العشرين، عندما رحل آخر جندي من جنود الاحتلال عن أرض مصر، كان وضع مصر من حيث المديونية الخارجية لا يختلف كثيراً عما كان عليه قبل ذلك بمائة عام. ففي 1956 كانت مصر، كما كانت في منتصف القرن التاسع عشر، غير مدينة للخارج بشيء. ولكن كان على مصر في 1956 الشروع في برنامج طموح للتنمية تدعم به عهد الاستقلال الجديد. في نفس الوقت، كان العالم الصناعي يدخل بدوره عهداً جديداً أهم ما يميزه أن استقطاباً دولياً جديداً، يتمثل في التنافس على مناطق النفوذ بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، قد حل محل النظام الاستعماري القديم الذي تزعمته بريطانيا وفرنسا، فإذا بقصة مديونية مصر الخارجية ابتداءً من ذلك الوقت تعكس ما طرأ على النطاق الاقتصادي والسياسي العالمي من تغيرات، وإذا بنا نقرأ قصة جديدة تمتد من منتصف الخمسينيات إلى منتصف الثمانينيات، لها بالطبع ملامحها الخاصة التي اكتسبتها في الأساس من الملامح الجديدة للنظام العالمي، ولكن لها أيضاً أوجه شبه مذهلة بقصة القرن التاسع عشر.
عهد عبد الناصر
لا يعرف التاريخ الاقتصادي نفس الانكسارات الحادة التي يعرفها التاريخ السياسي، فقد تقوم ثورة تقلب نظام الحكم بين يوم وليلة ويستمر مع ذلك التطور الاقتصادي لمدة سنوات بعدها، بنفس النمط الذي ساد قبلها. وينطبق هذا القول على انفجار ثورة 1952. فتطور مصر الاقتصادي لم يشهد انكساراً في 1952 كالذي شهده النظام السياسي، بل استمر لنحو أربع سنوات (حتى 1956)، بنفس الملامح الأساسية التي اتسم بها التطور الاقتصادي في العقد السابق على الثورة.
كذلك فإن تغير شخصية الحاكم لا ينطبق دائماً مع التغير في النظام الاقتصادي أو السياسة الاقتصادية. كثيراً ما يوقعنا هذا في الخطأ ونحن بصدد تقييم تجربة تاريخية معينة. وقد وقع فيه كثيرون وهم بصدد تقييم التجربة الناصرية، على الأقل فيما يتعلق بأدائها الاقتصادي. ذلك أنه حتى إذا جاز اعتبار الحقبة الناصرية، من الناحية السياسية، هي تلك التي بدأت بقيام ثورة 1952 وانتهت بوفاة عبد الناصر في 1970، فإن النظام الاقتصادي الناصري كان في الواقع أقصر عمراً بكثير. فأهم الملامح المميزة للناصرية من الناحية الاقتصادية لم تسد في الواقع إلا في الفترة الواقعة بين حرب السويس في 1956 وانتهاء الخطة الخمسية الأولى في 1965، أي لفترة لا تزيد على عشر سنوات، سبقتها فترة ليست في الحقيقة إلا امتداداً لسنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية، وأعقبها فترة أصيبت خلالها السياسة الاقتصادية بما يشبه الشلل، واستمرت كذلك حتى إلى ما بعد وفاة عبد الناصر ببضع سنوات. والوضع هنا يشبه إلى حد كبير تجربة النصف الأول من القرن التاسع عشر. فعلى الرغم من أن محمد علي حكم مصر فترة تقرب من نصف قرن (1805-1858) فإن أهم الملامح الاقتصادية المميزة لعهد محمد علي عما سبقه وما لحقه، لم تسد في الواقع أكثر من ربع قرن (1816-1840) وهي الفترة التي بدأت ببداية إصلاحاته لنظام الري وفرض نظام الاحتكار في الصناعة، وانتهت بمعاهدة لندن التي أجربته على التخلي عن نظام الاحتكار. وكما أن محمد علي ظل يعتلي عرش مصر لمدة ثماني سنوات بعد انكسار تجربته، فإن عبد الناصر ظل أيضاً حاكماً لمصر حتى نهاية الستينيات ولكن تجربته الحقيقية كانت قد انتهت قبل ذلك بثلاث أو خمس سنوات على الأقل.
سبق أن رأينا أن سنة 1943 شهدت إسدال الستار على الفصل الأول من قصة مديونية مصر الخارجية، وهو الفصل الذي بدأ في مطلع الستينيات من القرن التاسع عشر وانتهى بتحويل الديون الخارجية إلى دين محلي. استمرت مصر لفترة خمس عشر عاماً أخرى، تشمل السنوات السبع الأولى من الثورة، في غنى عن الديون الخارجية، فحتى نهاية 1958 ظلت مصر غير مدينة للخارج بشيء. لقد تلقت مصر خلال هذه السنوات السبع بعض المنح والقروض الخارجية، ولكنها كانت ضئيلة للغاية ولم يترتب عليها أية التزامات ذات شأن بالدفع بالعملات الأجنبية، فالمساعدات الأمريكية لمصر خلال سنوات الثورة الأولى كانت إما معونات فنية في صورة منح لا ترد (برنامج النقطة الرابعة)، أو معونات غذائية طبقاً للقانون الأمريكي المعروف برقم 480، وهذه كانت تقدم في صورة قروض تسدد بالعملة المصرية، ومن ثم لم يترتب أية التزامات على مصر بالعملات الأجنبية. وعلى أية حال فإن مصر لم تتلق من هذه المعونات الغذائية خلال تلك الفترة إلا ما قيمته 17 مليون دولار، وفي سنة واحدة هي 55/1956، ولم تستأنف بعد ذلك إلى في 58/1959. وفيما عدا هذا وقعت مصر خلال هذه الفترة قرضين مع الاتحاد السوفيتي لتمويل مجمع الحديد والصلب بحلوان، ولتمويل المرحلة الأولى لبناء السد العالي قيمتها 170 و97 مليون دولار على التوالي، واتفاقاً مع ألمانيا الغربية للتعاون الاقتصادي قيمته 124 مليون دولار، ولكن لم تسحب مصر أي مبلغ طبقاً لهذه الاتفاقيات الثلاث حتى آخر 1958.
ليس من الصعب تفسير استغناء مصر عن الاستدانة خلال السنوات السبع الأولى للثورة. فمن ناحية كانت لا تزال لدى مصر أرصدتها الإسترلينية المستحقة على بريطانيا، فضلاً عما كانت قد تلقته مصر منها قبيل الثورة ولم تنفقه فأضافته إلى احتياطياتها. ومن ناحية أخرى كانت جهود التنمية في ذلك الوقت متواضعة للغاية، إذ كانت حكومة الثورة ما زالت منشغلة بتثبيت أسس النظام الجديد وتقليم أظافر القى السياسية القديمة فضلاً عن تحقيق الجلاء، كما كانت لا تزال تؤمن بإمكانية الاعتماد على الاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية، لتحقيق التنمية، فلم يشكل الاستثمار العام عبئاً ملحوظاً على ميزان المدفوعات في الوقت الذي أحجم فيه رأس المال الوطني والأجنبي عن الاستثمار حتى تتبين له اتجاهات السياسة الاقتصادية للنظام الجديد، فلم يشكل الاستثمار الخاص بدوره عبئاً على موارد مصر من العملات الأجنبية. وهكذا نجد أن إجمالي قيمة الواردات السلعية لم تزد خلال هذه الفترة إلا زيادة طفيفة للغاية (بما لا يزيد عن 5% فيما بين 52 و1958) وأن متوسط العجز في ميزان العملات الأجنبية في 57-1958 كان أقل مما كان في 51-1952. على أن صورة ميزان المدفوعات المصرية ومديونية مصر الخارجية تغيرت تغيراً شاملاً خلال السنوات السبع التالية (5-1965).
وهي أكثر سنوات الثورة تمثيلاً للنظام الاقتصادي الناصري. إن أغلب ما يقترن في أذهاننا بالإنجازات الناصرية في المجال الاقتصادي إنما يعود إلى هذه الفترة. فهذه هي سنوات التنمية بالغة الطموح، والارتفاع الملحوظ في معدلات الاستثمار، وفي متوسط الدخل على الرغم من الزيادة السريعة في السكان، والتغير الواضح في هيكل الاقتصاد ومعدل التصنيع. وهي أيضاً الفترة التي شهدت تجربة مصر الوحيدة في التخطيط الشامل وفي التدخل الجدي لإعادة توزيع الدخل. ففي هذه الفترة ارتفع معدل الاستثمار من 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي (59/60) إلى 17.8% (64-1965) ومن ثم حقق الاقتصاد القومي نمواً حقيقياً زاد على 6%، وارتفع مستوى الدخل الحقيقي للفرد بأكثر من 3% سنوياً بعد ركود في متوسط الدخل استمر، كما سبق وأن أشرنا، أكثر من أربعين عاماً. وقد حظيت الصناعة والكهرباء بأكبر نصيب في الاستثمارات (نحو الثلث) فنما الناتج الصناعي بمعدل 8.5% سنوياً والكهرباء بمعدل 19%. وكذلك فاق معدل نمو الزراعة أيضاً (3.3%) بدرجة ملحوظة معدل النمو في السكان (2.8%).
أدى ذلك إلى أن أصبحت صورة الهيكل الاقتصادي في نهاية سنوات الخطة مختلفة بشكل ملحوظ عما كانت في بدايتها، فارتفع نصيب الصناعة والكهرباء في الناتج المحلي الإجمالي من 17% في 1958 إلى 23% في 1965، وزاد نصيب الصناعة في الصادرات من 18% إلى 25%. وإذا كان نصيب الصناعة في إجمالي العملة لم يرتفع بنفس الدرجة، فإن العمالة الصناعية قد زادت خلال هذه الفترة بأكثر من ضعف الزيادة في إجمالي القوة العاملة، وهو ما لم يعرفه الاقتصاد المصري منذ أيام محمد علي. واقترن كل ذلك بتحسن ملحوظ في نمط توزيع الدخل، فارتفع نصيب الأجور الزراعية في إجمالي الدخل الزراعي من 25% في بداية الخطة إلى 32% في نهايتها، ونصيب الأجور الصناعية في إجمالي الدخل الصناعي من 27.5% إلى 33.4%، وزاد متوسط الأجر الحقيقي في الزراعة والصناعة بنسبة 34% و12% على التوالي خلال نفس الفترة.
لم يكن غريباً أن يترتب على كل هذا أن يزيد العبء الملقى على ميزان المدفوعات وأن تظهر الحاجة إلى الاستدانة، بل الغريب أن يكون قد تم إنجاز كل ذلك دون تدهور أكبر بكثير مما حدث بالفعل في ميزان المدفوعات، ودون تورط أكبر بكثير في الديون. وكان من الطبيعي أن تؤدي هذه القفزة الكبيرة في معدل الاستثمار إلى زيادة الواردات من السلع الرأسمالية والوسيطة زيادة كبيرة، وأن تؤدي إعادة توزيع الدخل إلى زيادة كبيرة أيضاً في استيراد السلع الاستهلاكية. فإذا أضفنا إلى ذلك الزيادة الملحوظة في الإنفاق الحكومي، وفي الإنفاق العسكري بوجه خاص لتمويل حرب اليمن، كان علينا أن نتوقع زيادة ملحوظة في عجز ميزان المدفوعات. وبالفعل، بعد ما اتسمت به قيمة الواردات السلعية من ثبات في السنوات السبع الأولى للثورة، قفز المتوسط السنوي لإجمالي الورادات السلعية من 558 مليون دولار في تلك الفترة إلى 824 مليون دولار في الفترة 56-1966، أي بزيادة قدرها 48%. وعلى الرغم من الزيادة الملحوظة في الصادرات السلعية وفي إيرادات مصر من قناة السويس بعد تأميمها، لم تستطع إيرادات مصر من العملات الأجنبية أن تواجه هذه الزيادة الكبيرة في الاستيراد، فزاد عجز ميزان المعاملات الجارية بحيث أصبح (في 59-1966) نحو ثلاثة أمثال ما كان عليه في (52-1958).
كان لا يزال لدى مصر في بداية هذه الفترة من الأرصدة الإسترلينية ما تستطيع استخدامه في مواجهة العجز، إذ كانت بريطانيا لا تزال مدينة لمصر في مطلع 1959 بمبلغ 80 مليون جنيه إسترليني، ولكن هذا كان أقل بكثير مما كانت مصر في حاجة إليه لتمويل استثمارات الخطة والزيادة في الاستهلاك الخاص والحكومي، فضلاً ‘ما كان على مصر مواجهته من أعباء إضافية خلال تلك الفترة أهمها ما كان عليها دفعه من تعويضات لحملة أسهم قناة السويس المؤممة وغيرها من الممتلكات الأجنبية التي جرى تأميمها في أعقاب حرب 1956، فضلاً عن التعويضات المستحقة للسودان بسبب إغراق بعض أراضيها الذي ترتب على بناء السد العالي. هذه التعويضات بلغت نحو 67.5 مليون جنيه إسترليني (27.5 مليون لمساهمي شركة قناة السويس و25 مليون للبريطانيين الذين أممت ممتلكاتهم و15 مليوناً للسودان) وذلك دون حساب ما دفع من تعويض لرعايا اليونان وفرنسا ولبنان وإيطاليا وسويسرا عن ممتلكاتهم المؤممة. فإذا أضفنا إلى هذا المبلغ ما قدمته مصر من قروض ومساعدات لبعض الدول العربية والأفريقية خلال هذه الفترة (منها 10 ملايين جنيه للجزائر و6 ملايين لمالي) نجد أنه لا صحة للقول بأن الأرصدة الأسترالية المتوفرة لمصر خففت عن مصر عبء التنمية بدرجة ملحوظة. فالحقيقة أنها لم تساهم في ذلك إلا مساهمة محدودة للغاية إذا أخذنا في الاعتبار ما كان على مصر دفعه من تعويضات، وأن إجمالي المتوفر منها في بداية الخطة كان أقل من نصف حجم الاستثمارات المنفذة في السنة الأولى وحدها من سنوات الخطة.
لم يكن هناك إذن مفر لمصر من أن تلجأ في هذه الفترة إلى الاقتراض. ويقدر الدكتور الجريتلي ما تلقته مصر بالفعل من مساعدات وقروض خلال الفترة الممتدة من يونيو 1958 إلى يونيه 1965 بما يعادل 800 مليون جنيه مصري، منها 300 مليون قيمة المساعدات الغذائية المقدمة من الولايات المتحدة و500 مليون من الاتحاد السوفيتي وغيرها من دول الكتلة الشرقية وبعض الدول الغربية والمؤسسات الدولية. بمقارنة هذه الأرقام بأرقام الناتج المحلي وأرقام الاستثمار نجد أن ما حصلت عليه مصر من قروض خلال هذه الفترة كان يمثل نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن مصر اعتمدت على الاقتراض في تمويل نحو 30% من إجمالي الاستثمارات. كانت هذه الأرقام تبدو للباحثين في الاقتصاد المصري في منتصف الستينيات أرقاماً مزعجة ومدعاة للقلق، كما تميل كتابات أكثر حداثة إلى الإيحاء بأن مصر قد بدأت تتورط في الديون تورطاً خطيراً منذ سنوات الخطة الأولى. فيقتطف خالد إكرام في كتابه الصادر عن البنك الدولي في 1980 عبارة لهانسن تشير إلى تزايد التجاء مصر منذ 64/1964 إلى الاقتراض قصير الأجل بأسعار فائدة باهظة "كان من شأنها أن تصيب بالدهشة الخديوي إسماعيل نفسه. ولكن الحقيقة تبدو لنا الآن عكس ذلك تماماً. فالذي يبدو لنا الآن، ونحن ننظر إلى تجربة هذه الحقبة بعد مرور أربعين عاماً على انتهائها، هو أن لجوء مصر إلى الاقتراض في ذلك الوقت كان مبرراً تماماً، ولم يخلق لمصر من الأعباء ما كان يصعب عليها النهوض به مع الاستمرار في التنمية، وأن الذي أوقف مسيرة التنمية منذ منتصف الستينيات ليس هو أعباء المرحلة السابقة، سواء كانت أعباء زيادة الاستثمار أو الاستهلاك، ولا حتى أعباء الإنفاق العسكري، بل الذي أوقفها هو ما تعرضت له مصر من ضغوط خارجية بدأت منذ السنة الأخيرة للخطة، وبلغت قيمتها بحرب 1967 وما ترتب عليها من آثار.
ذلك أن معيار الحكم بما إذا كان الاقتراض مبرراً أو غير مبرر، وما إذا كانت درجة الاستدانة خطيرة، لا يختلف كثيراً في حالة الدولة عنه في حالة الفرد. فالعبرة ليست بالضبط بنسبة الاقتراض إلى الدخل، وإنما هي في الأساس بمدى القدرة على الوفاء بالدين، في فترة زمنية معقولة. وهذه القدرة على الوفاء تتوقف بدورها على استخدامات القروض، أي ما أنفقت فيه، وعلى شروط الاقتراض. وتطبيق ذلك على ديون عبد الناصر يجعلنا نميل إلى أن نصدر على تجربة الاقتراض في هذه الفترة التي نحن بصددها، حكماً إيجابياً إلى أبعد الحدود. فمن ناحية استخدامات القروض، لا أظن أن أحداً يمكن أن يجادل في أن قروض عبد الناصر المدنية قد وجهت بكاملها تقريباً لزيادة قدرة مصر الإنتاجية. فقروضه من الكتلة الشرقية ذهبت إما لتمويل مشروعات صناعية أو لتمويل السد العالي. إن الجدل ما زال يحتدم بالطبع عما إذا كان نظام عبد الناصر قد "بدد" جزءاً كبيراً من الموارد الذاتية والخارجية على صناعات قليلة الكفاءة، وعما إذا كان مشروع السد العالي قد ولد من الأعباء ما قلل كثيراً من منافعه الصافية. على أن القضية التي نحن بصددها الآن تختلف عن ذلك. فالقضية التي نواجهها هنا ليست هي ما إذا كانت القروض قد استخدمت أفضل استخدام ممكن، يفرض أن تحقيق ذلك كان متاحاً أصلاً حتى في أحسن الظروف الداخلية والخارجية، وإنما هي ما إذا كان العائد الذي تحقق من القروض يفوق تكاليفها، فإذا طرح الأمر على هذا النحو لبدا لنا من شبه المؤكد أن تجربة عبد الناصر في الالتجاء إلى الاقتراض لتمويل التنمية كانت مبررة تماماً، حتى لو ثبت لدينا أن أخطاء معينة قد ارتكبت في توزيع الاستثمارات. والعبرة على كل حال في تقييم تجربة ما، ليست هي في القدرة على الدفاع عن كل مشروع استثماري على حدة وإثبات كفاءته الاقتصادية، بل هي في النظر إلى توجه الاستثمارات بوجه عام ومدى مساهمتها جملة في زيادة قدرة الدولة الإنتاجية بحيث تتمكن الدولة في فترة زمنية معقولة من سداد ديونها. وقد أشرنا منذ قليل إلى التغير في هيكل الاقتصاد القومي الذي أحرزته التجربة الناصرية في فترة وجيزة نسبياً، سواء كان مقاساً بزيادة نصيب الصناعة في الناتج القومي أو في الصادرات، وهو تغير عجزت مصر عن إحداثه طوال الفترة التالية لعهد محمد علي، وكذلك طوال الفترة التي انقضت منذ انتهاء الخطة الأولى في 1965 وحتى اليوم.
بل ليس من التعسف القول بأنه حتى التجاء عبد الناصر إلى الولايات المتحدة للحصول على معونات غذائية كبيرة كان إلى حد كبير اقتراضاً إنتاجياً وليس اقتراضاً استهلاكياً. فمن المتفق عليه أنه حتى المواد الغذائية يمكن أن تعتبر سلعاً إنتاجية إذا استخدمت لتشغيل أعداد أكبر من العمال في أعمال منتجة ولم تستخدم في مجرد رفع مستوى الاستهلاك للعمال المشتغلين بالفعل. وهذا هو بالضبط ما حدث في الفترة التي نحن بصددها، فقد زاد عدد المشتغلين في هذه الفترة (59-60-64/1965) بمعدل يفوق بنسبة 50% معدل الزيادة في القوى العاملة. وكانت أكبر معدلات النمو في العمالة من نصيب قطاعات التشييد فالكهرباء فالصناعة. أما من حيث شروط الاقتراض فقد كانت في جملتها من أفضل ما حصلت عليه مصر من شروط في تاريخ مديونيتها الخارجية، إن لم تكن أفضلها على الإطلاق. فمن ناحية القيود السياسية المرتبطة بالقروض، كانت هذه الفترة، بما اتسمت به من ظروف توازن القوى بين المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي، هي الفترة الذهبية بالنسبة لمصر والعالم الثالث عموماً، من حيث القدرة على الاقتراض من كلا المعسكرين بأقل قدر من التضحية بحريتها في التصرف. كانت هذه الفترة من الفترات النادرة، التي تذكرنا مرة أخرى بالفترة الذهبية من حكم محمد علي، التي قنعت فيها كل من الدولتين العظمتين بأن تكون الدولة الصغيرة غير خاضعة للقوة العظمى الآخرين دون أن تشترط خضوعها لسيطرتها هي. كان من الممكن إذن لدولة كمصر أن تتلقى معونات اقتصادية كبيرة من كل من المعسكرين بمجرد إثبات استقلالها عن المعسكر الآخر، فتتلقى المعونات الغذائية من الولايات المتحدة وهي في قمة تطبيقها للإجراءات الاشتراكية، وتتلقى معونات الاتحاد السوفيتي لبناء السد العالي والمشروعات الصناعية والماركسيون المصريون قابعون في المعتقلات.
أما الشروط الاقتصادية فكانت بالغة اليسر، سواء من حيث فترة السداد أو سعر الفائدة. فالفروض السوفيتية كانت تقدم لفترة اثنى عشر عاماً، وبسعر فائدة لا يتجاوز 2.5%. ومعونات الغذاء الأمريكية كانت تقدم في صورة قروض مستحقة الوفاء بالعملة المصرية، وعبر فترة ثلاثين عاماً، وبسعر فائدة 4%. أما ما يشير إليه خالد إكرام من أسعار الفائدة الباهظة التي اقترضت بها مصر، فهي لا تتعلق إلا بالسنة الأخيرة من سنوات الخطة (64-1965) والسنوات الثلاثة التالية لها، ولم تضطر مصر إليها إلا بسبب القطع المفاجئ من جانب الولايات المتحدة لمعونتها الغذائية، وفي وقت كانت مصر تعاني فيه من تعاقب موسمين من الإنتاج الزراعي المنخفض.
إن من الممكن بالطبع أن نعتبر أن مجرد التجاء عبد الناصر للاعتماد على المعونات الغذائية الأمريكية كان موقفاً يتسم بقصر النظر والبعد عن الحكمة، على أساس أن هذه المعونات كان لابد من اعتبارها من أول الأمر أمراً غير مضمون الاستمرار ومرهوناً بموقف الولايات المتحدة السياسي من النظام الناصري، وأن من قبيل التهور رسم خطة للتنمية على افتراض استمرار هذه المعونة. هذا النقد، وإن كان لا يخلو من الصحة، فإنه أقرب إلى ذلك النوع من الانتقادات الذي يسهل توجيهه ممن ينظر إلى التجربة برمتها بعد انتهائها، وممن يعرف نهاية القصة، دون أن يقع عليه عبء المرور بالتجربة نفسها. لم يكن من السهل في اعتقادي، أن يتنبأ المرء في 58 أو 1959، حينما كان النظام الناصري يتمتع في الواقع بتأييد الولايات المتحدة، وحينما بدت الظروف الدولية مواتية للغاية لتدشين تجربة طموح في التنمية، بأن توازن القوة الدولية في منتصف الستينيات سوف يؤدي بالولايات المتحدة إلى اتخاذ موقف عدائي تماماً من التجربة الناصرية، ويقترن في نفس الوقت بإحجام الاتحاد السوفيتي عن تقديم يد العون لمصر بالدرجة المطلوبة لتعويضها عن توقف المعونة الأمريكية.
كان من الممكن بالطبع تجنب انتكاس تجربة التنمية، الذي حدث منذ منتصف الستينيات، لو استمع عبد الناصر لرأي فريق من الاقتصاديين المصريين في نهاية الخمسينيات الذين كانوا يعتبرون أهداف الخطة مفرطة في طموحها، فقبل معدلاً للتنمية أكثر تواضعاً وأقل اعتماداً على الموارد الخارجية، أو لو أنه على العكس اختار طريقاً أشد تقشفاً فلم يسمح بزيادة معدل الاستهلاك الفردي والحكومي واعتمد على المدخرات المحلية في تمويل متطلبات الخطة. كان الطريق الثالث الذي اختاره عبد الناصر هو التمسك بمعدل طموح للتنمية مع السماح في نفس الوقت ببعض الزيادة في مستويات الاستهلاك، وهو ما أسماه في ذلك الوقت "بالمعادلة الصعبة"، من حيث أنه لم يكن في الوقع يريد التضحية بشيء: لا بمستوى الاستثمار ولا بمستويات الاستهلاك، لا بالجيل الحاضر ولا بالمستقبل. كان حل المعادلة يكمن فيما توفر لعبد الناصر من موارد خارجية، وهو حل كان لا يخلو بالطبع من مخاطرة، ولكنها مخاطرة بدت وقت اتخاذ القرار مبررة بسبب توفر الظروف الدولية المواتية. إن من السهل علينا الآن أن نقول أنه كان على عبد الناصر أن يكون في نهاية الخمسينيات أقل مغامرة وأقل واقعية، ولكن الواقع هو أننا، على الرغم من كل ما تعرضت له مصر من مصاعب بعد منتصف الستينيات، ما زلنا حتى اليوم نجني بعض ثمرات مغامرة عبد الناصر وجسارته، وأن ما تعرض له الاقتصاد المصري من مصاعب منذ ذلك الوقت لم يكن بالضبط من آثار تلك المغامرة، بل كان من آثار توقفها، وأن هذا التوقف لم يكن في الأساس بسبب قطع المعونات الأمريكية، الذي كان باستطاعة مصر بسهولة التغلب على آثاره، وإنما كان في الأساس بسبب حرب 1967 التي فرضت على مصر فرضاً.
سبق أن ذكرنا أن من الأخطاء التي يمكن أن ترتكب، وترتكب بالفعل، في تقييم السياسية الاقتصادية المصرية منذ ثورة 1952، النظر إلى فترة حكم عبد الناصر، ابتداءً من قيام الثورة وحتى وفاته في 1970، وكأنها فترة متجانسة يمكن أن تتخذ كلها أساساً للحكم بنجاح أو فشل النظام الاشتراكي أو سيطرة القطاع العام والتدخل المركزي في الاقتصاد. ففضلاً عن أن سياسة التدخل الصارم من جانب الدولة في مختلف جوانب الاقتصاد المصري لم تبدأ في الواقع إلا في اعقاب حرب 56، فإن الظروف التي تعرضت لها التجربة الناصرية منذ منتصف الستينيات تجعل من الظلم الصارخ إصدار حكم على الاشتراكية والقطاع العام بناء على أداء الاقتصاد المصري في الستينيات بأكملها.
التراجع الاقتصادي: 1967-1970

لقد تضافرت على الاقتصاد المصري منذ 1965 مجموعة من العوامل الخارجية التي حتمت أداء اقتصادياً باهتاً، ويكاد أن يكون من غير المتصور أن يكون بمقدور أية سياسة اقتصادية مهما كانت براعتها وحكمتها، أن تنقذ الاقتصاد المصري من الانحدار ثم الركود طوال عشر السنوات التالية (65-1975). كان استخدام تعبير "النكسة" لوصف الهزيمة العسكرية في 1967 تعبيراً غير موفق بلا شكن كان المقصود به تخفيف وقع الصدمة على المصريين فلم ينجح في أداء هذه المهمة بل ربما زاد من الشعور بمرارتها. ولكن استخدام تعبير "النكسة" لوصف ما حدث للاقتصاد المصري لم يكن في الواقع بعيداً عن الحقيقة، فقد كان يحمل بالفعل إمكانيات الدخول فيما سمي وقتها بحق "بمرحلة الانطلاق" ثم اندثرت الآمال فجأة ودخل الاقتصاد المصري بدلاً من ذلك في مرحلة من الركود الطويل.
على أن من الخطأ أيضاً الاعتقاد بأن انتكاسة الاقتصاد المصري منذ منتصف الستينيات كانت في الأساس بسبب توقف المعونات الأمريكية وتضاؤل المعونات الغربية بوجه عام. لم يكن هذا التوقف أو التضاؤل في المعونات الخارجية أمراً يستهان به بالطبع، ولكن هناك من الدلائل ما يشير على نحو شبه قاطع بأن التنمية الاقتصادية في مصر كان من الممكن أن تستمر بمعدل مرض، وإن لم يبلغ مثل معدلها في السنوات العشر السابقة على 1965، ودون تضحيات بالغة الشدة في مستوى الاستهلاك، لولا قيام حرب 1967.
كان إجمالي ما حصلت عليه مصر من مساعدات غذائية من الولايات المتحدة خلال الفترة 58-1965 نحو 200 مليون جنيه مصري، فلما أوشك حلول موعد تجديد اتفاقية المعونات الغذائية أبلغ السفير الأمريكي في القاهرة الحكومة المصرية بأن حكومته "ليست على استعداد في الوقت الحاضر للدخول في أي نقاش حول تجديد الاتفاقية لأنها غير راضية عن سياسة الحكومة المصرية. واكتفت الولايات المتحدة بمد الاتفاقية لفترات تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر حتى توقف المساعدات الأمريكية تماماً في فبراير 1967. اقترن ذلك بانخفاض مذهل في المعونات التي كانت مصر تتلقاها من الدول الغربية والمؤسسات الدولية. إذ بينما بلغ المتوسط السنوي لهذه المعونات كلها (بما في ذلك المعونات الغذائية الأمريكية) 200 مليون دولار في 61-1966، انخفض هذا المتوسط إلى 16 مليوناً في 67-1969.
كان المتوسط السنوي للمعونات الغربية خلال سنوات الخطة الأولى يمثل إذن نحو خمس إجمالي الاستثمارات المتحققة خلالها، ومن ثم فإنه في حالة الاستغناء عن هذه المعونات برمتها في السنوات الخمس التالية كان على مصر تخفيض معدل الاستثمار بهذا القدر، بفرض عدم زيادة مصادر المعونة الخارجية الأخرى والاحتفاظ بمستوى الاستهلاك والادخار على ما كانا عليه. ولكن من الممكن أيضاً أن نتصور أنه كان بإمكان النظام الناصري أن يعوض هذا النقص في الموارد الخارجية أو جزءاً منه على الأقل بزيادة الادخار المحلي عن طريق ضغط الاستهلاك العام والخاص، واتباع سياسات في الأجور والإنفاق العام أكثر تقشفاً، الأمر الذي كان من الممكن أن يستجيب له الناس في مواجهة التعنت الخارجي لو لجأ عبد الناصر إلى تحويل قضية وقف المعونات الخارجية إلى قضية وطنية كما فعل من قبل فيما يتعلق بتأميم قناة السويس. إن هناك من الدلائل ما يشير إلى أن عبد الناصر كان يزمع بالفعل اتخاذ هذا المسلك منذ خطبته الشهيرة في بورسعيد في 23 ديسمبر 1964، عندما بدت أولى بوادر عزم الولايات المتحدة على وقف معوناتها، وحينما تحدى عبد الناصر محاولة الولايات المتحدة فرض إرادتها على مصر. على أنه أيضاً كانت قدرة عبد الناصر الحقيقية على النجاح في هذا المسلك فإنه من المؤكد أن العامل الذي حسم الأمر في اتجاه معاكس، وألغى نهائياً احتمال اتباع سياسة اقتصادية أكثر تقشفاً واشد إصراراً على تعبئة الموارد المحلية، هو قيام حرب 1967.
كان هذا الحل مستحيلاً تصوره في اعقاب الهزيمة لأكثر من سبب، فأياً كان استعداد الجماهير لقبول سياسة تقشفية كنوع من التحدي للقوى الخارجية، فإنه كان من الصعب الارتكان إلى هذا في ظل مناخ عام من الإحباط واليأس ولدته الهزيمة، وفي ظل انخفاض شعبية نظام عبد الناصر بسبب أثارته الهزيمة من شعور بتقصير المؤسسة العسكرية، وشك في قدرة النظام على الصمود في مواجهة التحدي الأمريكي والإسرائيلي. كان من شبه المستحيل حينئذ على نظام عبد الناصر أن يضيف إلى العبء النفسي المتولد عن الهزيمة العسكرية أعباء اقتصادية جديدة للاستمرار في التنمية. أضف إلى ذلك ما ترتب على هزيمة 1967 من انخفاض شديد في موارد مصر الذاتية من العملات الأجنبية، الأمر الذي جعل الاستمرار في تحقيق معدل مرتفع للتنمية مع تحمل أعباء الإنفاق العسكري للاستعداد لحرب جديدة أمراً في حكم المستحيل، حتى مع افتراض استعداد الناس لقبول تخفيض كبير في مستوى الاستهلاك. فقد ترتب على الحرب فقد مصر لآبار البترول في سيناء، وتخريب معامل تكرير البترول في السويس، وإغلاق قناة السويس التي كانت تدر لمصر سنوياً 164 مليون دولار في المتوسط خلال السنوات السبع السابقة على إغلاقها في 1967، أي ما يزيد بنحو الثلث على المتوسط السنوي للمعونات الغذائية الأمريكية خلال نفس الفترة، فضلاً عن الإنفاق الذي فرضه تهجير نحو مليون شخص من سكان مدن قناة السويس، والانخفاض الكبير في إيرادات السياحة التي كانت بدورها تدر نحو 100 مليون دولار سنوياً في المتوسط خلال السنوات السبع السابقة على الحرب.
كان أمام عبد الناصر إذن، في مواجهة كل ذا، اختيار واحد من البدائل الثلاثة الآتية: إما أن يضحي بالإنفاق العسكري وأن يقبل الهزيمة والصلح وقبول أي عرض للتسوية يعرض عليه في سبيل الاستمرار في التنمية، أو أن يضحي بكليهما: التنمية والحرب، في سبيل رفع معدلات الاستهلاك، أو أن يضحي بالاستمرار في التنمية وألا يسمح إلا بالحد الأدنى من الزيادة في الاستهلاك في سبيل الاستعداد لمعركة مقبلة. لم يكن هناك في الواقع بديل آخر، إذ لم يكن هناك من الموارد الخارجية من القروض والمعونات ما يسمح بالاستعداد للحرب والاستمرار في التنمية في نفس الوقت. فالدول والمؤسسات الغربية ما كانت لتعود إلى سابق عهدها في مد مصر بالقروض والمعونات ما لم تقبل مصر صلحاً غير مشرف مع إسرائيل، والتخلي عن سياسة حماية الصناعة المصرية وتقييد الواردات. ولم يبد من الاتحاد السوفيتي ودول الكتلة الشرقية الاستعداد لتقديم معونات كافية لتحقق الغرضين معاً وتعويض مصر عما فقدته من المعونات الغربية. فالمتوسط السنوي لمعونات الكتلة الشرقية التي حصلت عليها مصر بالفعل (تمييزاً لها عن إجمالي التعهدات) بلغ خلال الفترة 67-1972 نحو 140 مليون دولار، وهو ما لا يزيد كثيراً عن المتوسط السنوي لهذه المعونات خلال السنوات العشر 54-1964 (116 مليون دولار)، وهي زيادة لم تكن تكفي لتعويض النقص في المعونات الغربية حيث بلغ النقص في المتوسط الشهري لهذه المعونات، كما رأينا، نحو 184 مليون دولار.
كان المصدر الأساسي للمعونات المقدمة إلى مصر في السنوات التالية لحرب 1967 هو البلاد العربية، إذ حصلت مصر بناء على اتفاقية الخرطوم الموقعة في 1968، من المملكة العربية السعودية والكويت وليبيا على منح قدرها في المتوسط 286 مليون دولار في السنة، وهو مبلغ لا يمكن الاستهانة به إذ كان يساوي تقريباً المتوسط السنوي لمعونات الكتلتين الغربية والشرقية معاً في سنوات ما قبل 1968. ولكن معنى ذلك في الواقع أننا، إذا اعتبرنا أن المعونات العربية قد أتت لتعويض النقص في المعونات الخارجية فإنه كان لا يزال على مصر أن تواجه بعد 1967 كل الآثار الاقتصادية المترتبة على إغلاق قناة السويس، وفقدان بترول سيناء، ونقص إيرادات السياحة، ونفقات توطين المهجرين من منطقة القناة، فضلاً عن الإنفاق العسكري الجديد. أضف إلى ذلك ما كان على مصر دفعه لخدمة الديون التي حل موعد استحقاقها في السنوات التالية لحرب 67، إذ بلغت قيمة أقساط الديون المستحقة الدفع خلال الفترة (67-1972) نحو 240 مليون دولار في السنة في المتوسط، وهو ما كان يلتهم وحده الجزء الأكبر من كل ما تلقته مصر من مساعدات وقروض وتسهيلات خارجية خلال هذه الفترة. فكأن مصر في السنوات اللاحقة على حرب 1967 كان عليها، ليس فقط مواجهة ظروف اقتصادية وسياسية جديدة غاية في القسوة، بل وكان عليها ايضاً أن تتحمل جزءاً كبيراً من أعباء التنمية السريعة السابقة على 1967. إن هذا هو الأساس الذي نبني عليه قولنا إنه لم يكن هناك أمام عبد الناصر إلا البدائل الثلاثة المتقدمة، وقد اختار عبد الناصر البديل الثالث، وهو الاختيار الوحيد الذي كان يسمح له بالاستعداد لحرب جديدة، والدخول فيما سمي بحرب الاستنزاف، ولو على حساب التضحية بالتنمية والارتفاع بمستوى الاستهلاك.
دخلت مصر إذن في أعقاب 1967 مرحلة من الركود الاقتصادي استمرت حتى منتصف السبعينيات، وشهدت مصر خلالها فترة من أحلك فترات تاريخها الإجمالي في 64/1965 إلى 11.8% في 69/1970، أي ما لا يكاد يزيد على معدل الادخار المحلي (11.3%)، وبقي الاستهلاك الفردي (أو العائلي) ثابتاً تقريباً كنسبة من الناتج المحلي (65%)، وذلك للسماح بزيادة الاستهلاك العام (أو الحكومي) من 19.7% إلى 24.1%، وعلى الأخص زيادة الإنفاق الحربي الذي ارتفعت نسبته إلى إجمالي الدخل القومي من 9% في 1965 إلى 14% في النصف الثاني من الستينيات.
وقد ترتب على ذلك بالطبع انخفاض شديد في معدل التنمية من نحو 6% سنوياً في السنوات الخمس الاولى من الستينيات، إلى نحو 3% في السنوات الثماني التالية (65-1973)، أي ما لا يكاد يزيد عن معدل نمو السكان. فإذا أخذنا في الاعتبار ما أصاب المرافق العامة والبنية الأساسية من تدهور بسبب ضغط الإنفاق على التجديد والصيانة، تبينا أن مستوى المعيشة قد تعرض بلا شك للانخفاض في تلك الفترة.
من أسوأ سمات هذه الفترة ايضاً توقف الاتجاه إلى تصحيح هيكل الاقتصاد المصري توقفاً تاماً. فبعد النجاح الكبير الذي أحرزته سنوات الخطة الأولى في إحداث تغير جذري في هيكل الجهاز الإنتاجي لصالح الصناعة والكهرباء، بقي نصيب الصناعة والكهرباء في الناتج القومي الإجمالي ثابتاً طوال الفترة 65-1972 بسبب الانخفاض الشديد في معدل الاستثمار. بل أصابت النكسة أيضاً نمط توزيع الدخل فتوقفت الحركة نحو تصحيح توزيع الدخل لصالح فئات الدخل الدنيا توقفاً شبه تام، بسبب تراخي معدلات التصنيع والتشغيل من ناحية، وبسبب القيود السياسية التي فرضتها الهزيمة على حركة عبد الناصر في هذا الاتجاه. من المؤشرات الدالة على ذلك عودة نصيب الأجور الزراعية في إجمالي الدخل الزراعي إلى الانخفاض من 32% إلى 25% فيما بين 1965 و1972، وانخفاض نسيب الأجور الصناعية في الدخل الصناعي من 33% إلى 31% خلال نفس الفترة، بعد زيادة كل منها زيادة ملموسة في السنوات الخمس الأولى من الستينيات.
لم تمنع هذه التضحيات بالتنمية من تدهور ميزان المدفوعات. فقد كان النقص في إيرادات مصر من قناة السويس والسياحة، والانخفاض الشديد في معونات الدول والمؤسسات الغربية، والزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري وفي أقساط تسديد الديون، أكبر من أن تستطيع تعويضه الزيادة الطفيفة في معونات الكتلة الشرقية ومنح الدول العربية وتخفيض الاستثمار. فقد ارتفع المستوى السنوي لعجز ميزان العمليات الجارية بنسبة 86% (من 202 مليون دولار في 59-1966 إلى 375 مليون في 67-1972)، وزاد المدفوع تسديداً لأقساط الديون طويلة ومتوسطة الأجل من 56 مليون دولار إلى 250 مليوناً في السنة، ومن ثم كان على مصر أن تجد مصادر لتمويل عجز إجمالي في العملات الأجنبية قدره 625 مليون دولار في السنة. اعتمدت مصر في تغطية هذا العجز، على المنح المقدمة من بعض الدول العربية طبقاً لاتفاقية الخرطوم (286 مليون دولار) ثم قروض الكتلة السوفيتية (140 مليوناً)، وتمت تغطية الباقي بالسحب من احتياطي العملات الأجنبية (30 مليوناً) وبتسهيلات الموردين من الدول الغربية (133 مليوناً)، وبالاقتراض قصير الأجل من البنوك التجارية (37 مليوناً).
لابد أن نلاحظ إذن أنه على الرغم من الصعوبات التي واجهت الاقتصاد المصري في أعقاب 1967، لم يكن من بين الحلول التي لجأ إليها عبد الناصر إغراق مصر بديون لا تستطيع الوفاء بها. فمع ضخامة الأعباء، والتضاؤل الشديد في الموارد الذاتية، كان سد العجز يتم في الأساس بالمنح التي لا تولد أية أعباء مالية، أو بالقروض من الكتلة الشرقية ذات الشروط بالغة اليسر. ولم يلجأ عبد الناصر إلى الاقتراض باهظ التكلفة (الاقتراض قصير الأجل وتسهيلات الموردين) إلا في حدود لا تتجاوز 27% من إجمالي العجز في العملات الأجنبية. كان الثمن الذي دفعه الاقتصاد المصري لذلك يتمثل في الانخفاض الشديد في معدل التنمية، ولكنه كان في اعتقادنا يمثل اختياراً حكيماً، إذ كان من شأن التورط في الديون في تلك الفترة أن يجبر مصر في وقت لاحق على التخلي عن أية محاولة لمتابعة مسيرة التنمية المستقلة التي بدأها عبد الناصر في نهاية الخمسينيات. كان من شأن هذا الاختيار أن كانت مصر وقت وفاة عبد الناصر لا تحمل إلا عبئاً هيناً نسبياً من الديون، فيقدر خالد إكرام إجمالي ديون مصر المدنية (بما في ذلك كل الديون طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل) في 31 ديسمبر 1971، أي بعد نحو سنة من وفاة عبد الناصر بما لا يزيد على 1300 مليون دولار، لا تزيد نسبتها إلى الناتج القومي الإجمالي على نحو الربع. وبلغت نسبة خدمة الديون كلها، مدنية وعسكرية، وبمختلف أنواعها، طوال السنوات 67-1972 نحو 33% من إجمالي الصادرات من السلع والخدمات.
إن من المفيد تذكر هذه الأرقام حينما نأتي لوصف حالة المديونية الخارجية لمصر في نهاية الثمانينيات، إذ إن ما كان يبدو عبئاً باهظاً في 1970 يبدو الآن عبئاً يسيراً للغاية إذا ما قورن بحجم المديونية وعبء خدمة الديون بعد وفاة عبد الناصر بعشرين عاماً. كما أن من المفيد أن نتذكر الفارق البين بين هيكل المديونية في نهاية حكم عبد الناصر وهيكله في 1990. ففي نهاية 1971 كان إجمالي الديون المستحقة موزعاً بالتساوي بين الكتلتين الشرقية والغربية، فبينما كانت الديون المستحقة للاتحاد السوفيتي ودول أوروبا الشرقية والصين تشكل نحو 43% من إجمالي ديون مصر المدنية، كانت الديون المستحقة للدول والمؤسسات الغربية والبنك الدولي تشكل 46%، والباقي كان ديناً للكويت. وسوف نرى كيف زال هذا التوازن بالتدريج خلال السبعينيات والثمانينيات حتى أصبحت الديون المستحقة للدول والمؤسسات الغربية (مضافاً إليها اليابان) تشكل النسبة العظمى من إجمالي مديونية مصر.
السادات: 1970-1981
من المعروف أنه خلال الأعوام الأحد عشر التي تولى فيها أنور السادات حكم مصر (70-1981) زادت ديون مصر الخارجية زيادة مذهلة. وإنما يثور الخلاف حول الاسباب التي أدت إليها وحول قوة الأعذار التي يمكن أن تقدم لتبريرها. إن من الصعب الوصول إلى مقارنة دقيقة بين حجم الديون في بداية حكم السادات وبينها في نهايتها، بالنظر على تناثر المعلومات في مصادر مختلفة، وتنوع أنواع الديون التي يشير كل من هذه المصادر إلى بعضها دون البعض الآخر، فضلاً عن عدم توفر أرقام دقيقة عن بعض أنواع الديون، خاصة الديون العسكرية. وسوف نحاول هنا أن نقدم للقارئ الأرقام على نحو يسمح بالمقارنة الصحيحة، دون إرهاقه بتفاصيل قد تمنعه من إدراك الأبعاد السياسية لتطور المديونية، ثم نحاول البحث عن الأسباب الحقيقية لزيادتها.
ولنبدأ بأهم أنواع الديون، وهو الدين الخارجي المدني العام، طويل ومتوسط الأجل، ويشمل المبالغ التي اقترضتها الحكومة أو المؤسسات العامة، أو المضمونة من جانب الحكومة ، لغير الأغراض العسكرية. والأرقام التي سنذكرها هنا تشمل المبالغ التي تسلمتها الحكومة (والمؤسسات العامة) بالفعل، تمييزاً لها عن المبالغ المتعاقد عليها دون أن يكون قد تم سحبها في الفترة محل البحث. هذا النوع من الديون زاد من 1.7 بليون دولار في سنة وفاة عبد الناصر (1970) إلى 14.3 بليوناً في سنة مقتل السادات (1981)، أي أنه تضاعف خلال حكم السادات أكثر من ثماني مرات.
ولكن هذا النوع من الديون، وإن كان أهمها، لا يشمل كافة ديون مصر الخارجية. فهناك الديون الحكومية المدنية قصيرة الأجل، الديون العسكرية، ثم ديون القطاع الخاص، وكلها تفرض أعباء على حصيلة البلاد من العملات الأجنبية. ولا تتوفر لدينا إلا أرقام تقريبية عن هذه الأنواع الثلاثة، ولكن بمقدورنا تقديرها بما لا يزيد على ثلاثة بلايين في 1970 وبنحو 15 بليوناً في 1981. معنى ذلك أن إجمالي مديونية مصر الخارجية، بمختلف أنواعها، المدني والعسكري، العام والخاص، وذات الأجل الطويل والمتوسط والقصير، زاد من نحو 5 بلايين دولار في 1970 إلى نحو 30 بلويناً في 1981، أي أنها تضاعفت خلال حكم السادات نحو ست مرات. فكيف يمكننا تفسير ذلك؟
إن التفسيرات المطروحة تتراوح بين رد هذا النمو المذهل في المديونية إلى أخطاء السياسة الاقتصادية خلال السبعينيات، وعلى الأخص تلك المقترنة بسياسة الانفتاح الاقتصادي، وردها إلى ظروف الاقتصاد الدولي التي لم يكن لمصر حيلة معها، أو إلقاء المسئولية على تركة الستينيات وما ورثه أنور السادات من أخطاء السياسة الناصرية. ولكي نستطيع أن نحدد أقرب هذه التفسيرات إلى الصواب، ونصيب كل منها من الصحة، يتعين أن نسير خطة خطوة متتبعين تطور المديونية خلال السبعينيات، حيث إن الظروف التي واجهتها مصر خلال هذه الحقبة لم تكن ظروفاً متجانسة، وتقلبت خلالها موارد مصر من العملات الأجنبية، والظروف الإقليمية والدولية تقلباً شديداً، بحيث إن ما يصلح في تفسير نمو المديونية خلال النصف الأول من السبعينيات قد لا يصلح في تفسير ما حدث بعدها. على أننا قبل أن نبدأ هذه المهمة نريد أن نلاحظ بصفة عامة أن زيادة المديونية الخارجية لأية دولة لابد أن يكون مصدرها المباشر أحد أمرين: إما زيادة العجز في ميزان المعاملات الجارية، الذي يعود بدوره إلى تراخي نمو الصادرات بالنسبة لنمو الواردات، أو إلى انخفاض تدفق رؤوس الاموال إلى الدولة المعنية في صورة استثمارات أجنبية خاصة أو في صورة منح وهبات لا ترد، أو بالطبع إلى مزيد من الأمرين معاً، أي زيادة العجز في ميزان المعاملات التجارية مع انخفاض في تدفق الاستثمارات الخاصة والمنح، بحيث لا يبقى أمام الدولة من سبيل إلى سد العجز إلا الاقتراض من الخارج.
فإذا ركزنا النظر على السنوات الخمس الأولى من حكم السادات (70-1975) نجد أن البذور الأولى للزيادة السريعة في المديونية قد بذرت بالفعل خلال هذه الفترة، إذ زادت الديون الخارجية المدنية العامة (بما في ذلك الديون قصيرة الأجل) من 1.8 بليون دولار إلى 6.3 بليون، أي بنحو 350%. وبينما كان معدل النمو السنوي في الديون الخارجية المدنية طويلة ومتوسطة الأجل 9% طوال الستينيات، قفز هذا المعدل إلى 23% في السنوات الخمس الأولى من السبعينيات. أما الديون الخارجية قصيرة الاجل، فبينما كانت تنمو بمعدل سنوي قدره 25% في الستينيات قفز هذا المعدل إلى 55% فيما بين 70 ونهاية 1975. لا يمكننا تفسير التزايد في المديونية خلال هذه الفترة بالنقص في تدفق الاستثمارات الأجنبية أو في المنح والهبات الخارجية. فالفترة السابقة على حكم السادات لم تشهد استثمارات أجنبية ذات شأن، والمنح التي كانت تحصل عليها مصر قبل حكم السادات كانت تتكون أساساً من المعونات العربية، وهذه لم تستمر فقط خلال سنوات السادات الاولى، بل زادت بشدة عما كانت عليه في عهد عبد الناصر. فبينما بلغ المتوسط السنوي للهبات التي تلقتها مصر خلال الفترة 67-1972 (وكلها من دول النفط العربية) 261 مليون دولار، قفز هذا الرقم إلى 731 مليون في 1973 و1.3 بليون في 1974، و1.1 بليون في 1995. لم تلجأ مصر إذن إلى الاقتراض الخارجي في هذه الفترة لتعويض النقص في المعونات العربية، فهذه المعونات زادت ولم تنقص، بل إن الهبات والتحويلات العربية غطت في هذه الفترة ما يقرب من نصف إجمالي العجز في موارد مصر من العملات الأجنبية.
يتعين إذن البحث عن تفسير لزيادة المديونية فيما طرأ على ميزان المعاملات الجارية، أي في أداء الصادرات والواردات. وهنا بالفعل نجد بداية الإجابة. لقد زادت الصادرات حقاً (من السلع والخدمات) خلال السنوات الخمس الاولى من حكم السادات بنحو 240%، ولكن الواردات من السلع والخدمات زادت بدورها بنسبة أكبر بكثير (350%). قارن ذلك بأداء الصادرات والواردات في السنوات الخمس السابقة (64/65- 69/1970) حيث انخفضت قيمة الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 7%، للأسباب التي سبق لنا ذكرها، ويرتبط معظمها بآثار حرب 1967، لكن انخفضت الواردات بنسبة أكبر (15%) نتيجة لسياسة الانكماش وضغط الاستثمارات التي اتبعها عبد الناصر. من الممكن إذن أن نقدم الإجابة الأولية التالية: إن زيادة تورط مصر في الديون خلال السنوات الخمس الأولى من حكم السادات ترجع إلى الفشل في ضبط الواردات. ولكن هذا بدوره يثير التساؤل عما إذا كانت هذه الزيادة السريعة في الواردات تعود إلى خطأ في الإدارة الاقتصادية أم إلى ظروف خارجية لا سلطان لمصر عليها. والواقع أن المسئولية تقع على العاملين معاً، ولكن الأرقام المتوفرة لا تدفع مجالاً للشك في أن جزءاً كبيراً من المسئولية يقع على أخطاء الإدارة الاقتصادية.
فمن ناحية، عانت مصر خلال هذه الفترة من تدهور حاد في معدل التبادل الدولي بين أهم صادراتها (القطن) وبين أهم وارداتها (القمح)، أي من الانخفاض الشديد في أسعار صادراتها بالنسبة لأسعار ما تستورده، فبينما تضاعف سعر الطن من القمح خلال السنوات الخمس بنحو أربع مرات ونصف (من 25 جنيهاً للطن إلى 112 جنيهاً)، لم يزد سعر الطن من القطن إلا بنحو الضعفين (من 530 جنيهاً إلى 1068 جنيه). وترتب على ذلك أن الطن الواحد من القطن الذي كانت تصدره مصر جلب لها من القمح في 1975 أقل من نصف ما كان يجلبه لها في 1970. ولكن من المهم أن نلاحظ أنه حتى فيما يتعلق بهذا العبء الناتج عن ارتفاع أسعار الواردات، لا يمكن أن نلقي المسئولية بأكملها على الظروف الخارجية، فالاضطرار إلى الاستيراد بأسعار مرتفعة لا يثير فقط مسئولية العوامل الخارجية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار الدولية، وإنما يثير أيضاً المسئولية ذاتها عن العجز عن زيادة الإنتاج الوطني بمعدل كان من شأنه أن يغني بدرجة أو بأخرى عن الاستيراد. وهنا نصادف بالفعل أول مظهر من مظاهر مسئولية السياسية الداخلية عن التورط في الديون. فقد عجز الإنتاج المصري من الحبوب خلال السنوات الخمس الأولى من السبعينيات عجزاً مذهلاً عن مواكبة الزيادة في استهلاكها. إذ بينما ارتفع استهلاك الفرد من الحبوب الغذائية من 258 كيلو جرام في السنة في 70/1971 إلى 286 كيلو جرام في 74/1975 (أي بنسبة 9%) انخفض الإنتاج للفرد الواحد من 196 إلى 187 كيلو جرام أي خلال نفس الفترة (أي بنسبة 5%)، ومن ثم ارتفعت نسبة العجز الذي يتعين تغطيته بالاستيراد من 24% من إجمالي استهلاك الحبوب الغذائية في 70/1971 إلى 35% في 74/1975.
ليس من الإنصاف مع ذلك، أن نرد هذا الفشل في زيادة إنتاج الحبوب خلال النصف الأول من السبعينيات، إلى أخطاء ارتكبتها السبعينيات نفسها. فزيادة الإنتاج الزراعي في فترة ما تحتاج إلى القيام بالاستثمارات وإدخال بعض الإصلاحات على السياسة الزراعية في فترة سابقة. والأقرب إلى الصحة أن هذا الفشل في تحقيق زيادة كافية في إنتاج الحبوب والإنتاج الزراعي بوجه عام في تلك الفترة بالذات (70-1975) إنما يعود في الاساس إلى اضطرار مصر لضغط استثماراتها في النصف الثاني من الستينيات وعلى الأخص في أعقاب حرب 1967. إنما تكمن مسئولية السبعينيات الأساسية عن التورط في الديون خلال الفترة (70-1975) في أمرين: الأول: إطلاق حرية الاستيراد في كثير من السلع الضرورية وغير الضرورية، وعلى الأخص في أعقاب حرب 1973، على نحو لم تكن تسمح به ضآلة موارد مصر من العملات الأجنبية والمعدل المنخفض نسبياً للزيادة في الصادرات. والثاني: الالتجاء المفرط إلى تمويل جزء كبير من العجز في ميزان المعاملات الجارية بالاقتراض قصير الأجل وباهظ التكلفة.
أما عن إطلاق حرية الاستيراد فيجري الدفاع عنه عادة بالقول بأن القطاع الإنتاجي في مصر كان يعاني منذ فترة طويلة، ترجع إلى منتصف الستينيات، من ندرة السلع الرأسمالية والوسيطة، ومن التضاؤل الشديد في حجم المخزون من السلع الوسيطة وبعض السلع الاستراتيجية والغذائية، الأمر الذي كان لابد من تلافيه بإطلاق حرية الاستيراد إذا أريد لعجلة الإنتاج أن تعود إلى الدوران. كما يجري الدفاع عنه أحياناً بالقول بأن حالة المرافق العامة كانت قد بلغت درجة من التدهور خلال الستينيات لم يكن هناك مفر من التصدي لها بزيادة الإنفاق على تجديدها، الأمر الذي كان لابد أن ينعكس بدوره في زيادة الواردات وزيادة العبء على ميزان المدفوعات. ونحن من جانبنا نرى أن كلا القولين يسمان جزءاً فقط من الحقيقة ولا يمكن أن يفسرا وحدهما ما حدث من تدهور في ميزان المدفوعات، ومن ثم لا يصلحان لإعفاء الإدارة الاقتصادية في تلك الفترة من المسئولية عن الزيادة في حجم المديونية الخارجية. ففيما يتعلق بالحاجة إلى إطلاق حرية استيراد السلع الوسيط والرأسمالية، نلاحظ أن الواردات من هذه السلع قد زادت بالفعل بسرعة كبيرة في أعقاب حرب 1973، إذ تضاعفت الواردات من السلع الرأسمالية نحو ثلاث مرات (من 89 مليون جنيه في 1973 إلى 260 مليوناً في 1975)، وتضاعفت الواردات من السلع الوسيطة نحو خمس مرات (من 132 مليون جنيه في 1973 إلى 619 مليوناً في 1975). ولكننا نريد هنا أن نورد ثلاثة تحفظات أساسية:
أولها: أن ما حدث خلال هذه الفترة من تلبية لحاجة المنتجين المشروعة إلى مزيد من الواردات الرأسمالية والوسيطة، يجب ألا يتخذ وسيلة لصرف النظر عما حدث خلال هذه الفترة أيضاً من إطلاق حرية الاستيراد لإشباع حاجات استهلاكية بحتة لم تكن ظروف الاقتصاد المصري وقتها تسمح بها. فخلال السنتين التاليتين لحرب 1973، زادت مثلاً قيمة الواردات من السيارات بأكثر من أربعة أضعاف وزادت الواردات من السلع الاستهلاكية غير المعمرة بأكثر من أربعة أضعاف وزادت الواردات من السلع الاستهلاكية غير المعمرة بأكثر من خمسة أضعاف (من 40 مليون جنيه في 1973 إلى 220 مليوناً في 1975)، ومن ثم أصبحت قيمتها في 1975 لا تقل كثيراً عن قيمة مجموع الواردات من السلع الرأسمالية.
والتحفظ الثاني: هو أن عبارة "السلع الرأسمالية والوساطة" تخفي في طياتها كثيراً من السلع التي لا تساهم مساهمة تذكر في زيادة القدرة الإنتاجية للدولة وأنها قد تضم من السلع ما هو أقرب إلى الاستهلاك منه إلى الاستثمار. من أمثلة ذلك مواد البناء واللوريات وقطع غيار السيارات التي تخدم أنشطة استهلاكية لا إنتاجية. يؤيد هذا التحفظ ما نلاحظه من تدهور بعض أهم الصناعات في مصر خلال النصف الأول من السبعينيات، فبينما لم يزد معدل النمو السنوي في إنتاج المنسوجات عن 2% وفي غزل القطن عن 0.7%، انخفض الإنتاج في صناعات الأسمنت والورق والسكر والسجائر وحديد التسليح وإطارات السيارات والأتوبيسات.. الخ.
التحفظ الثالث: هو أن من المشكوك فيه جداً أنه كان من الحكمة إطلاق حرية الاستيراد في تلك الفترة، حتى فيما يتعلق بالواردات من السلع الإنتاجية، إذا كان تمويل العجز يعتمد أساساً على المزيد من المديونية. فلزيادة المديونية ثمن لابد من دفعه إن آجلاً أو عاجلاً، والاعتماد على الديون لرفع معدل التنمية لابد أن يؤدي في وقت لاحق إلى التضحية بالتنمية من أجل خدمة الديون، ما لم تكن أسعار الفوائد على القروض أقل من معدل العائد على الاستثمارات التي توجه هذه القروض إليها، وهو ما لم يتحقق. أما الدفاع عن التورط في الديون بحجة إصلاح المرافق العامة، فهو دفاع مرفوض لأكثر من سبب، أولها ما ذكرناه حالاً من خطأ الاعتماد على القروض غير الميسرة لتمويل مشروعات لا تساهم مساهمة مباشرة في زيادة الإنتاج، أو تساهم فيها بمعدل يقل عن فوائد القروض. يضاف إلى ذلك ما نلاحظه من أن نصيب المرافق العامة في إجمالي الاستثمارات في الفترة 71-1975 لم يزد عن 4%، الأمر الذي يؤيده أن حالة المرافق العامة في منتصف السبعينيات لم تكن في الواقع أفضل بكثير مما كانت في بدايتها، وأن الجزء الأكبر مما أنفق على المرافق العامة في أعقاب حرب 1973 إنما وجه إلى إعادة تعمير مدن القناة التي فرضتها في الأساس اعتبارات سياسية أو مصالح اقتصادية ضيقة أكثر مما استوجبتها اعتبارات إعادة بناء الجهاز الإنتاجي، وهي على كل حال أقرب إلى الإنفاق الاستهلاكي منها إلى الاستثمار.
ليس من الغريب إذن أن نجد أن زيادة الديون في تلك الفترة (70-1975) لم يصحبها ارتفاع ملحوظ في معدل النمو أو تحسن في هيكل الإنتاج. فمعدل النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي لم يزد عن 4.5%، ولم يزد معدل النمو في الزراعة عن 2.4% وفي الصناعة عن 4.3% وفي الإسكان عن 2%. وإنما كانت أكبر معدلات النمو (فيما عدا الكهرباء 14.9%) من نصيب النقل والمواصلات والتخزين (13.3%) وقطاع التجارة والمال (9.5%). ترتب على هذا أن بدأ اتجاه معاكس للاتجاه الذي ساد في الستينيات نحو تصحيح الهيكل الإنتاجي لصالح القطاعات السلعية. فمع بداية السبعينيات بدأ نصيب القطاعات السلعية في التضاؤل ونصيب الخدمات في التزايد، حتى أصبحت صورة الاقتصاد المصري في منتصف السبعينيات أسوأ مما كانت عليه في نهاية الخمسينيات من حيث التوزيع النسبي للناتج الإجمالي بين القطاعات السلعية وقطاعات الخدمات.
أما الجريرة الثانية للسياسة الاقتصادية في النصف الأول من السبعينيات فتتمثل في زيادة الالتجاء إلى القروض قصيرة الأجل من البنوك التجارية ذات أسعار الفائدة التي تجاوزت في بعض الأحيان 15%. وقد زاد هذا الاعتماد على القروض قصيرة الأجل في أعقاب حرب 1973 حتى بلغت نسبة هذا النوع من القروض، بما في ذلك تسهيلات الموردين، في 1975، نحو 35% من إجمالي ديون مصر المدنية. وقد حمل هذا النوع من القروض ميزان المدفوعات أعباء ثقيلة لا تتمثل فقط في الفوائد الباهظة المستحقة عليها، ولكن أيضاً في المبالغ المستحقة للتأخر في سدادها. وقد كان من الممكن تجنب هذا وذاك لو لجأت الحكومة إلى كبح جماح الاستيراد، بما في ذلك حتى بعض السلع الوسيطة والرأسمالية، في مواجهة الارتفاع المفاجئ في أسعار الواردات الاستهلاكية الضرورية، كالقمح والدقيق. خلاصة تقديرنا إذن للسنوات الخمس الأولى من السبعينيات هي أن الاقتصاد المصري لم يجن كثيراً من الثمار خلالها في مقابل زيادة التورط في المديونية، سواء من حيث رفع معدل النمو، أو تغيير هيكل الاقتصاد، وتكاد تنحصر الثمار الاقتصادية لهذه الفترة في بداية إعادة تعمير مدن قناة السويس وإعادة فتح القناة وتطهيرها، واستكمال النقص في المخزون السلعي من بعض المواد الأولية والوسيطة. أما حرب 1973 فقد اعتمد في تمويلها في الأساس على الهبات والمنح العربية ومن ثم لا يجوز التعلل بها لتبرير زيادة المديونية.
على أنه أياً كانت تحفظاتنا على السياسة الاقتصادية خلال السنوات الخمس الأولى من حكم السادات، فإن الأخطاء التي ارتكبت خلال النصف الثاني من حكمه كانت أخطر شأناً بكثير وأبهظ ثمناً، وهي التي تمثل في رأينا تركة السادات الحقيقية التي ورثها الاقتصاد المصري من بعده.
سياسة الانفتاح: 1975-1981
في 1974 فوجئ السادات، أو هكذا قال، بالوضع الاقتصادي الخطير الذي تمثل في عجزه عن الوفاء بمبالغ من القروض قصيرة الأجل. واستخدم السادات حينئذ في وصف حالة الاقتصاد المصري أنه: "بلغ درجة الصفر". وتعلل بأعذار غريبة منها أن أحداً لم يخبره من قبل بخطورة الأمر، ومنها أن الأرقام التي عرضت عليه كان يظن أنها بالدولارات ثم تبين له فيما بعد أنها بالجنيهات الإسترلينية.
رأينا من قبل، كيف أن الخديوي إسماعيل كان قد اكتشف بدوره قبل ذلك بمائة عام (1876) أن الخزينة المصرية خاوية وأنه عاجز عن الوفاء بديونه التي ورطه فيها الدائون الأوروبيون خلال الثلاثة عشر عاماً السابقة. كما ذكرنا أن تورط الخديوي إسماعيل في الديون لم يكن مصدره بالضبط ميله إلى البذخ والإنفاق وإنما توفر أموال سائلة في المصارف الأوروبية كانت تبحث عن فرص للاستثمار المجزي في الخارج، وأن بذخ إسماعيل وتوسعه في الإنفاق لم يكن السبب بمقدار ما كان نتيجة لما تعرض له من ضغوط وإغراءات من جانب السماسرة والمرابين زينت له مشروعات باهظة التكاليف وقليلة العائد. ولكننا نعرف أيضاً أنه في أعقاب 1973 توفرت للمصارف الأوروبية والأمريكية كميات طائلة من الأموال السائلة نتيجة لما سمي بإعادة تدوير عوائد النفط في أعقاب ارتفاع سعره، وكانت هذه المصارف تبحث بدورها عن مجالات لتوظيف هذه الأموال خارج بلادها. نحن نعرف أيضاً أن مجموع ديون مصر قصيرة الأجل في 1970 لم يكن قد تجاوز 148 مليون دولار فتضاعف نحو ثماني مرات في خمس سنوات ليصل إلى 1168 في 1975. فإذا تذكرنا أيضاً أنه بمجرد انتهاء حرب 1973 زينت للسادات مشروعات إعادة تعمير مدن القناة، وهي ما لم تكن تسمح بالتوسع فيه أحوال مصر الاقتصادية في ذلك الوقت، لضآلة مواردها من الصادرات، وأن اعتراضات بعض المسئولين الاقتصاديين على هذا التوسع في الإنفاق على مشروعات التعمير، خاصة إذا كان يضطر مصر إلى التورط بشدة في القروض التجارية قصيرة الأجل، هذه الاعتراضات التي قوبلت وقتها بالقول بأن الأمر يتعلق "بسياسات عليا" لا يسمح بمناقشتها، إذا تذكرنا كل هذا أصبح من الصعب ألا يثور بقوة احتمال أن يكون التورط في هذا النوع من الديون في عهد السادات قد جاء استجابة لنفس النوع من الضغوط والإغراءات التي تعرض لها الخديوي إسماعيل من قبل.
شهدت تلك السنة (1975) والسنة التي تلتها، جولات متعاقبة للرئيس السادات ولرئيس الوزراء ووزراء المالية والاقتصاد المصريين في دول الخليج يرجون فيه زيادة حجم المعونات العربية المقدمة لمصر، مستخدمين كل ما يمكن استخدامه من حجج، من بطولة الجيش المصري في حرب أكتوبر، إلى ما قدمته مصر من تضحيات للقضية الفلسطينية، إلى ما تؤديه العمالة المصرية من خدمات لتنمية دول الخليج، ولكن دون طائل. فقد كان رد حكومات النفط على الدوام أن: "هذا الذي نقدمه هو أقصى ما نستطيعه، وأنه حتى لو كانت باستطاعتنا تقديم أكثر من ذلك فإنه ليس لدينا ما يضمن أن مصر سوف تحسن استخدام ما نقدمه لها من معونات". كانت هناك أيضاً تلميحات إلى ما يسود تصرفات الإدارة المصرية من فساد وتبديد، وهي أمور كانت حكومات النفط العربية آخر من يحق لها أن يشير إليها. كانت هناك أيضاً ردود تعلمتها حكومات النفط من رجال البنك الدولي والمؤسسات الدولية مثل القول بأن تقديم المساعدات لدعم ميزان المدفوعات يساعد على التبديد، وأن الأفضل هو تقديم مساعدات لتمويل مشروعات بعينها يتفق عليها، ولكن مصر للأسف لا تتوافر لديها كمية كافية من دراسات الجدوى، ومن المشروعات كاملة الإعداد تبرر زيادة حجم المساعدات. هكذا نجد أنه في ظل اشتداد الضائقة الاقتصادية بمصر في 1976، انخفضت المعونات التي قدمتها دول النفط العربية لمصر انخفاضاً ملحوظاً. فانخفض إجمالي المدفوعات الثنائية الميسرة التي دفعتها هذه الدول لمصر من 1873 مليون دولار في 1975 إلى 1028 مليوناً في 1976، أي بنسبة 45%، وانخفضت المدفوعات غير الميسرة لمصر من نفس الدول من 668 مليون دولار إلى 235 مليوناً أي بنحو الثلثين بين هذين العامين. ليس هناك، في رأيي، إلا تفسير واحد مقبول لهذا المواقف التي اتخذته حكومات النفط العربية في هاتين السنتين (75، 1976). لقد كان لدى هذه الحكومات بغير شك ما يكفي من الأموال لانتشال مصر من أزمتها. ففي الوقت الذي كانت تقترض فيه مصر من البنوك التجارية بأسعار فائدة تزيد على 15%، كانت دول النفط تستثمر فوائضها في البنوك الأمريكية والأوروبية والبنك الدولي بأسعار فائدة تقل عن نصف هذا القدر. وفي الوقت الذي كانت حكومات النفط وشركات الاستثمار فيها تتكلف فيه عن ارتفاع المخاطر السياسية للاستثمار في مصر، كانت استثمارات هذه الحكومات والشركات في الدول الغربية تتعرض لمخاطر حقيقية تتمثل في التدهور المستمر في قيمة الدولار وارتفاع معدلات التضخم. لم يكن الأمر إذن في الحقيقة إلا أن حكومات دول النفط لم تكن قد تلقت بعد إيماءة الموافقة من الولايات المتحدة وهيئات المعونات الدولية بزيادة حجم معوناتها لمصر، ولم يكن هذا ليتم إلا إذا أظهرت مصر استعداها نهائياً لقبول توصيات صندوق النقد الدولي، ولاتخاذ خطوة حاسمة في اتجاه عقد اتفاقية سلام مع إسرائيل.
كانت مصر، بنهاية 1967، قد ذهبت بالفعل شوطاً بعيداً نحو قبول كلا المطلبين، ولكن يبدو أن ما تم حتى ذلك الوقت لم يكن كافياً. كانت مصر قد أصدرت بالفعل قوانين تشجيع رأس المال الأجنبي على الاستثمار في مصر، وخفضت بشدة من القيود على الاستيراد، وسمحت للبنوك الأجنبية بفتح فروع لها في مصر، وأقامت مناطق اقتصادية حرة، وضيقت الفجوة بين قيمة الجنيه المصري الرسمية وقيمته السوقية.. إلخ. ومع ذلك كانت ما تزال هناك سياسة الحماية المفروضة لشركات القطاع العام، وما تقدمه الحكومة من دعم لهذه الشركات ولتخفيض أسعار السلع الاستهلاكية، وهو ما كانت الحكومة المصرية تبدي إحجاماً واضحاً عن التخلي عنه. كذلك فيما يتعلق بقضية إسرائيل. كانت مصر بنهاية 1967 قد قطعت أيضاً شوطاً بعيداً في الرضوخ للمطالب الإسرائيلية، ولم يكن ذلك بدوره كافياً. فمنذ حرب أكتوبر 1973، بل وحتى أثناءها، وقبل عبور القوات الإسرائيلية إلى غربي القناة، كانت الحكومة المصرية قد بدأت تعبر عن استعدادها للسلام، ثم عقدت اتفاقيتين لفك الاشتباك، ودخلت في مفاوضات مباشرة وغير مباشرة مع الإسرائيليين. ولكن كانت الحكومة المصرية لا تزال تصر على رفض عقد صلح منفرد مع إسرائيل لا تشترك فيه سوريا والأردن، ويستبعد الفلسطينيين. كان هذا هو الوضع إذن في نهاية 1976، ولكن بعد أقل من سنة كانت الصورة قد اختلفت تماماً. ففي صباح أحد أيام نوفمبر 1977، كان المصريون فيه يحتفلون بعيد الأضحى، استيقظ الناس على خبر زيارة رئيس الجمهورية المصرية للقدس، ورأوا في نفس اليوم على شاشة التلفزيون رئيس جمهوريتهم وهو يستعرض حرس الشرف الإسرائيلي ويضع إكليل الزهر على قبر الجندي الإسرائيلي المجهول.
كانت الحكومة السعودية في مطلع نفس العام قد أعلنت، بعد إحجام، عن قبولها أن تساهم بنسبة 40% في رأس المال "هيئة الخليج لتنمية مصر"، البالغ قدره 2 بليون دولار، وذلك في أعقاب إعلان مصر قبولها لمشروع صندوق النقد الدولي "لترشيد" السياسة الاقتصادية. في يونيو من نفس العام كان قد عقد في باريس أول اجتماع للمجموعة الاستشارية التي تضم جميع الدول والهيئات المهتمة بتقديم المعونة لمصر، واستمع الحاضرون لتقرير وزير التخطيط المصري عن السياسة الاقتصادية المزمع تطبيقها، وهو تقرير كان قد تم إعداده في القاهرة بمساعدة خبراء صندوق النقد الدولي، ومن ثم فقد تلقى التقرير على الفور مباركة دائني مصر المجتمعين في باريس.
لا يعرف أحد على وجه الدقة ماذا حدث بين نهاية 1976 ونوفمبر 1977، ولكن من الصعب أن نتصور أن هذه الفترة لم تكن فترة عصيبة للحكومة المصرية. كانت هناك بالطبع أحداث يناير 1977 التي قام بها الناس يحتجون على زيادة أسعار بعض السلع الضرورية، والتي قد تكون قد ساهمت إلى حد ما في التخفيف من قسوة خبراء صندوق النقد الدولي أو على الأقل أقنعته بضرورة تأجيل بعض التنازلات، ولكن من الصعب تصور أنه لم تتخذ خلال تلك الفترة بعض أساليب الضغط التي لم تعرف أبعادها بعد، والتي كانت الظروف الاقتصادية والديون الخارجية المستحقة الدفع من أهم الوسائل المستخدمة فيها، وربما كان قبول رئيس الجمهورية لزيارة القدس واحداً من الشروط المفروضة عليه من أجل التدخل لإنقاذه. على أية حال فإنه قد يذكر ذلك العام (1977) على أنه العام الذي أجبرت فيه مصر على تقديم أكبر تنازل في المجال السياسي منذ زمن طويل، بينما قد يذكر عام 1987 على أنه العام الذي أجبرت فيه مصر على تقديم أكبر تنازل في الميدان الاقتصادي كما سنبين فيما بعد.
سوف يذكر القارئ ما حدث في مصر قبل ذلك بمائة عام. ففيما بين 1876 و1879 توالت الضغوط على الخديوي إسماعيل ليقبل التدخل المباشر في إدارة الاقتصاد المصري من جانب الدول الأوروبية التي ينتمي إليها الدائنون. وكانت نقطة الضعف لدى الخديوي، كما كانت لدى السادات، هي عجزه عن الوفاء بمستحقات الديون التي تورط فيها دون موجب في السنوات القليلة السابقة. وقد أبدى الخديوي إسماعيل منذ 1876 استعداده لقبول أي إجراء للإصلاح قد تنصح به الحكومتان البريطانية والفرنسية، فقبل تكوين "صندوق الدين العام" وتكوين "لجنة التحقيق" للإشراف على مالية الدولة وحصر مواردها وأوجه إنفاقها، كما قبل السادات توصيات "المجموعة الاستشارية" المجتمع في باريس. ولكن السادات فيما يبدو كان على استعداد إلى أبعد مما ذهب إليه الخديوي إسماعيل. إذ بينما حاول الخديوي مقاومة إشراك ممثل لبريطانيا وآخر لفرنسا كوزيرين في مجلس الوزراء المصري فكلفه ذلك عرشه في 1879، قبل السادات القيام بزيارة القدس في 1977 فاستحق بذلك رضا الأمريكيين والدول الغربية وهيئات المعونات الغربية والدولية.
بقدوم 1977 بدا وكأن عقداً كاملاً من المتاعب الاقتصادية المتراكمة قد أوشك على الانتهاء، وإذا بالاقتصاد المصري يبدأ فترة جديدة من الانتعاش الواضح استمرت حتى نهاية عصر السادات. ففي الخلال السنوات الأربع الأخيرة من عهد السادات (77-1981) بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الثابتة، ما بين 8%، 9% سنوياً، وهو معدل لم يستطع تحقيقه في نفس الفترة إلا عدد محدود للغاية من البلاد، ولم تحقق مصر مثله منذ الحرب العالمية الأولى على الأقل. في هذه السنوات الأربع أيضاً شهدت مصر زيادة لم تعرف لها مثيلاً منذ ذلك الوقت في موارد العملات الأجنبية، فضلاً عن اتجاه معدل التبادل الدولي لصالحها. فقد زادت إيرادات مصر من صادرات البترول، التي لم تتجاوز 162 مليون جنيه في 1977، إلى ما يقرب من عشرة أمثالها، فبلغت 1.5 بليون جنيه في 1981، بفضل الزيادة السريعة في كل من إنتاج وأسعار البترول، بينما زادت إيرادات مصر من الصادرات غير المنظورة من 998 مليون جنيه إلى 4 بليون جنيه في نفس الفترة، وهي زيادة ترجع في الأساس إلى الزيادة السريعة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج. كذلك شهد معدل التبادل الدولي تحولاً لصالح مصر بنسبة 81% فيما بين 77 و1981، حيث فاق الارتفاع في أسعار النفط، بدرجة ملحوظة، الارتفاع في أسعار الواردات من السلع الاستهلاكية والرأسمالية. وهكذا تضاعفت إيرادات مصر الجارية من العملات الأجنبية نحو أربع مرات خلال أربع سنوات.
كانت هذه الظروف المواتية هي بلا شك أنسب الظروف، ليس فقط لوضع حد لتزايد المديونية الخارجية بل ولإحداث تخفيض كبير فيها. ففي الفترة 77-1981 كانت قيمة الزيادة في إجمالي صادرات مصر من السلع والخدمات نحو خمسة بلايين من الجنيهات أو نحو سبعة بلايين من الدولارات، وهو مبلغ يساوي نحو 87% من إجمالي قيمة ديون مصر الخارجية المدنية طويلة ومتوسطة الأجل، في 1977. ولكن الذي حدث هو العكس بالضبط، فإذا مصر تلجأ في فترة رخاء لم تشهد مثلها طوال سبعين عاماً على الأقل، إلى مزيد من الاستدانة، وإذا بنا نجد الديون المدنية طويلة ومتوسطة الأجل التي كانت قد بلغت 4.8 بليون دولار في 1975، وزادت إلى 8.1 بليون دولار في 1977، تزيد بنسبة 76% في السنوات الأربع التالية فتصل إلى 14.2 بليون دولار في 1981. كيف يمكن تفسير ذلك، وأي عذر يمكن أن يقدم لتبريره؟ لقد رأينا حالا أنه لا يمكن تفسير ذلك بضآلة أو تراخي حصيلة الصادرات، فقد شهدت صادراتنا المنظورة وغير المنظورة في تلك الفترة، رواجاً لم يسبق له مثيل. إنما يكن السبب فيما أصاب الواردات من السلع والخدمات من زيادة غير معهودة أيضاً. فخلال السنوات الأربع 77-1981 زادت واردات مصر السلعية ن 1.8 بليون جنيه مصري إلى 6.1 بليون جنيه، أي بنحو اربعة أمثال. وترتب على ذلك أنه، على الرغم من الزيادة الكبيرة في حصيلة الصادرات، زاد العجز في ميزان المعاملات التجارية من 892 مليون جنيه إلى 1.9 بليون، أي بأكثر من الضعف. على أن هذه الإجابة لا تكفي بالطبع، إذ يهمنا أن نعرف معدلات الزيادة في مختلف أنواع الواردات. لقد شاع القول بأن هذه الزيادة في عجز ميزان المعاملات التجارية في تلك الفترة، ومن ثم زيادة الالتجاء إلى الاقتراض، إنما يرجع في الأساس إلى إطلاق حرية استيراد السلع الكمالية. وهذا القول، وإن كان يشير إلى جزء من الحقيقة، فإنه لا يشير إلى السبب الأساسي لزيادة العجز والمديونية. ذلك أننا إذا نظرنا إلى توزيع الواردات بين مختلف البنود، وجدنا أن ثلاثة ارباع الزيادة فيها، خلال هذه السنوات الأربع، يرجع إلى زيادة الواردات السلعية، وربعها يرجع إلى الزيادة في الواردات من الخدمات. أما زيادة الواردات السلعية، وقدرها 4.3 بليون جنيه، فيرجع 18% منها إلى الزيادة في واردات القمح والذرة والدقيق. و23% للزيادة في السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة عدا القمح والذرة والدقيق، ويرجع الباقي، وقدره 59% إلى الزيادة في واردات السلع الوسيطة والرأسمالية. أما الزيادة في واردات الخدمات فيرجع نحو ثلثها إلى فوائد الديون، ويوصف الجزء الأكبر من الباقي في إحصاءات ميزان المدفوعات التي ينشرها البنك الأهلي بأنه: "نفقات أخرى"، فلا يعلم أين ذهب هذا الجزء إلا الله.
نستخلص من ذلك أن زيادة العجز والمديونية خلال السنوات الأربع الأخيرة من عهد السادات، وإن كان من الممكن إلقاء جزء من المسئولية عنها على زيادة الاستهلاك فإن الجزء الأكبر يرجع إلى زيادة استيراد السلع الوسيطة والرأسمالية، وهو ما يعكس ارتفاع معدل الاستثمار إلى نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي. ولقد كان من الممكن أن يتخذ هذا عذراً للإدارة الاقتصادية في ذلك الوقت لو كانت أوجه الاستثمار التي وجهت إليها الأموال المقترضة من النوع الذي يولد عائداً يزيد على تكلفة الاقتراض. ولكن العكس تماماً كان هو الصحيح، فقد وجه الجزء الأكبر من الاستثمارات في تلك الفترة إلى فروع قليلة الإنتاجية وضعيفة العائد، كالمرافق العامة والخدمات التجارية والمالية، مما يجعل مصر تواجه السنوات التالية بعبء ثقيل من المديونية دون أن يكون في قدرتها توليد الدخل الكافي للقيام بهذا العبء. ففي خلال السنوات 77-81/1982، كانت القطاعات التي أحرزت أعلى معدلات النمو (فيما عدا قطاع البترول وقناة السويس) هي قطاعات التجارة والمال (12.5% سنوياً)، والبناء والتشييد (11.3%) والخدمات الحكومية (10.6%) والنقل والمواصلات والتخزين (8.3%) بينما لن تنم الصناعة والتعدين (بعد استبعاد البترول) بأكثر من 6%، وتراخى معدل نمو الزراعة (2.3%) عن معدل النمو في السكان.
لم تقترن إذن تلك الزيادة المذهلة في المديونية، خلال عهد السادات، بأي تصحيح لهيكل الاقتصاد المصري، بل صاحبتها زيادة كبيرة في درجة الاختلال، سواء في هيكل الانتاج أو في هيكل العمالة. فانخفض نصيب الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي من 25% في بداية عهده إلى 17% في نهايته، بينما ارتفع نصيب الخدمات من 45% إلى 48% ونصيب البترول الخام من أقل من 1% إلى 18%. كذلك زاد الاختلال في هيكل العمالة لصالح قطاع الخدمات الذي يضم أكبر نسبة من البطالة المقنعة. إذ بينما ظل نصيب الصناعة التحويلية في إجمالي القوة العاملة ثابتاً تقريباً عند 12% طوال عهد السادات، كان الانخفاض في نصيب الزراعة في القوة العاملة مساوياً تقريباً للزيادة في نصيب الخدمات، حيث زاد هذا الأخير بنحو 50% (من 30% من إجمالي القوة العاملة إلى 45%). ولم يقترن توقيع اتفاقية السلام في 1979 بتخفيض الإنفاق العسكري، بل على العكس زاد هذا الإنفاق بشدة في أعقابها، وزاد الالتجاء في تمويله إلى القروض الخارجية أيضاً، التي ساهمت فيها الولايات المتحدة بأكبر نصيب، وبأسعار الفائدة التجارية التي كانت بالغة الارتفاع في ذلك الوقت. ويذكر تقرير لصندوق النقد الدولي صادر في 1984 أن الإنفاق العسكري زاد بنسبة تتجاوز 20% سنوياً في أعقاب 1979، وبلغت نسبة الزيادة فيه في عام مقتل السادات 32%.
لا يسع المرء من جديد إلا أن يلاحظ شبهاً آخر بين تجربة الاقتصاد المصري في عهد السادات وبينها في عهد الخديوي إسماعيل. ففي الحالتين اقترنت الزيادة الكبيرة في المديونية بمعدل نمو بالغ الارتفاع في الدخل القومي، وبازدهار واضح في مصادر النقد الأجنبي، فلم يمنع الرخاء من التورط في مزيد من الديون في الوقت الذي كان يجب أن تستخدم الموارد الذاتية الجديدة في تسديد الديون السابقة. وفي الحالتين، وعلى الأخص في عصر السادات، استخدم جزء كبير من هذه القروض في تمويل مشروعات لا تضيف إضافة ملحوظة إلى الإنتاج، بما في ذلك شراء السلاح، الأمر الذي لابد أن يثير التساؤل مرة أخرى عن نوع النصائح (أو الضغوط) التي كان يتعرض لها الحاكم في الحالين، وعن المصالح الخارجية والداخلية التي كانت تجد مصلحها في تشجيع الاتجاه نحو الاستدانة، إما تسهيلاً لفرض الإرادة في المستقبل، أو تصريفاً لمنتجات لا تجد من يشتريها.
حسني مبارك: 1981-2011
مع تغير القيادة السياسية في 1981 ظهرت فرصة أخرى لإنهاء حالة الارتباك والفوضى في السياسة الاقتصادية وللمواجهة الجديدة لمشكلة الديون الخارجية. سبق أن ذكرنا أنه ليس من السهل رسم صورة دقيقة لتركة الديون التي ورثها أنور السادات لمصر في 1981 ولكننا نستطيع أ، نستخلص، من بين متاهات الأراقم المتشعبة والمتضاربة، الصورة التالية التي يمكن أن نعتبرها قريبة جداً من الحقيقة.
كان إجمالي ديون مصر الخارجية، العامة المدنية، طويلة ومتوسطة الأجل، عند وفاة السادات 14.3 بليون دولار، وهي الديون المستحقة على الحكومة المصرية أو المضمونة من جانبها والمسحوبة بالفعل. وكانت الديون العامة المدنية قصيرة الأجل 6.8 بليون دولار، وديون القطاع الخاص نحو نصف بليون دولار. كانت الحكومة مدينة أيضاً بديون عسكرية تبلغ نحو خمسة بلايين دولار للولايات المتحدة وسائر دول العالم الغربي، ونحو ثلاثة بلايين للاتحاد السوفيتي وبقية الكتلة الشرقية. كان إجمالي ديون مصر إذن عند وفاة السادات المدنية والعسكرية، العامة والخاصة، طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل، نحو ثلاثين بليوناً من الدولارات. كان هذا المبلغ يمثل نحو 141% من الناتج المحلي الإجمالي في 1981 بالمقارنة بنسبة 43% عند بداية تولي السادات الحكم. وكان على مصر في 1981 أن تدفع لخدمة ديونها المدنية وحدها 2.9 بليون دولار (1.3 بليون كأقساط و1.6 بليون كفوائد) أو ما يمثل 28% من جملة إيراداتها من العملات الأجنبية، وهو ما يساوي تقريباً معدل خدمة الديون عند بداية عهد السادات، مع هذا الفارق الهام: وهو أن مصر في 1981 كانت تتدفق عليها من الإيرادات من العملات الأجنبية ما لم تكن تحلم به في 1970، إذ كان مجموع قيمة إيراداتها من صادرات السلع والخدمات في 1981 أكثر من عشرة أمثال ما كنت عليه في 1970.
كان الشعور في أعقاب مقتل السادات، عاماً وملحاً بالحاجة إلى إعادة النظر في السياسة الاقتصادية برمتها، وإلى إدخال إصلاحات جوهرية عليها، ولكن كان من المقدر لأية محاولة للإصلاح أن تجري في ظروف خارجية غاية في الصعوبة. فقد اقترنت نهاية عصر السادات بظروف جديدة بدا فيها أن فترة الرخاء القائم على تدفق إيرادات البترول وتزايد تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس والسياحة قد ولت. ففي السنوات الأربع التالية لمقتل السادات (81/82- 85/1986) انخفضت إيرادات البترول بنسبة 36%، وأصاب الركود مصادر الدخل الثلاثة الأخرى، التي تعتمد بدورها، بدرجات متفاوتة، على أسعار البترول، بينما ظل معدل تدفق الاستثمارات الأجنبية الخاصة ثابتاً تقريباً عند زهاء بليون دولار سنوياً. في نفس الوقت لم يسمح استمرار الركود في أسواق التصدير الرئيسية بحدوث زيادة ملموسة في الصادرات المصرية من السلع التقليدية، ومن ثم لم تزد قيمة الصادرات من السلع الأولية (عدا البترول) بأكثر من 4% سنوياً، ولم تزد صادرات غزل القطن والمنسوجات التي تمثل أهم بند في صادرات مصر المصنعة، وإن كانت لا تشكل إلا نسبة ضئيلة للغاية من الصادرات الكلية، بأكثر من 8% سنوياً، ومن ثم انخفضت القيمة الكلية لصادرات السلع والخدمات في 85/1986 بنسبة 11% بالمقارنة بقيمتها في 81/1982. في نفس الوقت كان على مصر بالطبع أن تستمر في دفع فوائد متزايدة على ديونها السابقة، حيث ارتفعت قيمة الفوائد السنوية المستحقة الدفع من 1.4 بليون دولار في 81/1982 إلى 1.7 بليوناً في 85/1986.
كان قد ولى أيضاً عهد الهبات والمنح القادمة من الدول العربية التي توقفت معونتها بتوقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل في 1979. ولم تكن الهبات والمنح تشكل نسبة كبيرة من معونات الدول الغربية، ولم تطرأ عليها زيادة تذكر خلال الثمانينيات اللهم إلا بتحويل المعونات العسكرية الأمريكية إلى هبات لا ترد ابتداء من 1985، دون أن ينطبق ذلك على القروض العسكرية المعقودة قبل 1985.
كان من الواضح أن الاختيارات السهلة نسبياً، التي كانت متاحة في السنوات الخمس الأخيرة من عهد السادات، حينما كان تتدفق العملات الأجنبية على مصر بلا حساب، لم تعد متاحة في بداية عهد مبارك، وأن محاولة إجراء تخفيض كبير في المديونية، أو على الأقل عدم التورط في مزيد منها، كان يتطلب تخفيضاً كبيراً في الواردات، حتى من بعض السلع الأقل كمالية، وبما في ذلك الواردات من السلع الرأسمالية والوسيطة، مما يتطلب بدوره التضحية بارتفاع معدل النمو، فضلاً عن تخفيض حجم الإنفاق العسكري بما يخفف من عبء ميزان المدفوعات، مع إمكانية تعويض كل ذلك بإجراءات جادة لإعادة توزيع الدخل وترشيد توزيع الاستثمارات. كان هذا الحل، حتى مع ما يتسم به من بعض القسوة، يمثل في رأيي الحل الحكيم الوحيد، إذ كان البديل لذلك لا يعني إلا تأجيل المتاعب إلى فترة لاحقة، بل وزيادة الأعباء في المستقبل، متمثلة في خدمة ما يعقد من قروض جديدة. كان هذا أيضاً هو الحل الذي اتجهت إلى الأخذ به صفوة الاقتصاديين المصريين في المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس مبارك في فبراير 1982، عقب توليه الرئاسة بشهور قليلة، وكان هو الذي يتردد في مؤتمرات الاقتصاديين المصريين السنوية في أواخر عهد السادات وأوائل عهد مبارك.
ولكن الذي حدث هو أن الإدارة الاقتصادية تبنت الاختيار الآخر الأكثر سهولة في المدى القصير، والمؤذن بمتاعب لا حد لها في المدى الطويل، والذي يعتبر في سماته الأساسية، استمراراً للسياسة الاقتصادية السابقة على 1981، وهو تبني معدل مرتفع للاستثمارات، خاصة في المرافق العامة، وعدم إخضاع الواردات أو الإنفاق العسكري لدرجة عالية من التقييد، مع الاستمرار في الاعتماد على القروض الخارجية في تمويل العجز بين الموارد والإنفاق.
كان من الواضح منذ تدشين ما سمي بالخطة الخمسية الأولى (82/83-86-1987) أن ليس من بين أولياتها تخفيض الاعتماد على التمويل الخارجي. فعلى الرغم من تبني الخطة في مقدمتها شعار "الاعتماد على الذات"، استهدفت الخطة أيضاً زيادة المديونية الخارجية المدنية من 13 بليون جنيه في 81/1982، طبقاً لأرقامها، إلى 16.2 بليون في 86-1987، أي زيادة المديونية المدنية بنحو الربع في خمس سنوات، وذلك من أجل تمويل استثمارات مستهدفة تبلغ 25% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقق معدل نمو 8.1% سنوياً. لم يكن يتوقع بالطبع في مطلع 1982، أن تنخفض أسعار البترول، ويصيب الركود تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات السياحة وقناة السويس على النحو الذي حدث منذ السنة الثانية للخطة، ولكن كان يكفي في اعتقادنا ما وصلت إليه حال المديونية في 1981، وما بدأت تلقيه من أعباء ثقيلة على ميزان المدفوعات، لأن يتبنى المخطط معدلاً للنمو أقل طموحاً، ومعدلات أقل للاستثمار، بما يتطلبه ذلك من تخفيض الواردات، بغية التخلص التدريجي من المديونية، وتعويض هذا الانخفاض في معدل النمو بالتركيز على ترشيد الاستثمار وإعادة توزيع الدخل. بل إن الذي حدث هو أن واضعي السياسة الاقتصادية لم يستجيبوا استجابة كافية للتغيرات التي بدأت تطرأ على موارد مصر من العملات الأجنبية مع توالي سنوات الخطة. فعلى الرغم مما تم بالفعل من تخفيض معدل الزيادة في الواردات السلعية تخفيضاً كبيراً عما كان عليه في عهد السادات، عجز هذا التخفيض عن ملاحقة الانخفاض في الصادرات، ومن ثم استمر العجز في ميزان المعاملات التجارية في الزيادة، فارتفع من 1.7 بليون دولار في 81/82 إلى 2.5 بليون في 85/86، الأمر الذي حتم، مع ضآلة الهبات والمنح وثبات حجم الاستثمارات الأجنبية الخاصة، الالتجاء إلى مزيد من الاستدانة، وإذا بالاقتصاد المصري في منتصف 1986، بعد أربع سنوات من بداية الخطة، ينوء بعبء من المديونية الخارجية أثقل بكثير مما تركه السادات، ومما تصوره واضعو الخطة في 1982.
ففي 30 يونيو 1986، بلغت قيمة الديون الخارجية العامة المدنية، طويلة ومتوسطة الأجل، 24.3 بليون دولار، بزيادة قدرها عشرة بلايين (أو 70%) عما كانت في 30 يونيو 1918، كما ارتفعت ديون القطاع الخاص بنحو خمسة أمثال (من نحو نصف بليون دولار في 81 إلى 2.7 بليون في 1986). خلال هذه الفترة مالت الديون المدنية العامة قصيرة الأجل إلى الانخفاض (من 6.8 بليون دولار في 81 على نحو 6 بليون في 1986) وبقيت الديون العسكرية المستحقة للاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية ثابتة عند ثلاثة بلايين دولار، ولكن زادت الديون العسكرية للولايات المتحدة وبقية الدول الغربية من نحو خمسة بلايين دولار في 1981 إلى ما بين 8-9 بلايين دولار في 1986. طبقاً لهذه التقديرات يكون إجمالي ديون مصر الخارجية، المدنية والعسكرية، قد زاد من نحو 30 بليون دولار في منتصف 1981 إلى نحو 45 بليون دولار في منتصف 1986 أي بزيادة قدرها 50% في خمس سنوات أو ضعف النسبة التي استهدفتها الخطة، مع مراعاة أن هذا الرقم الأخير (45 بليون) لا يشمل تسهيلات الموردين التي قدرتها بعض المصادر بنحو ثمانية بلايين دولار في منتصف 1986.
إن هناك الكثير من الأعذار التي يمكن أن تقدم، وتقدم بالفعل، لتبرير زيادة بهذا الحجم في المديونية خلال الثمانينيات. فمن الممكن أولاً المقارنة بين تطور المديونية في السنوات الخمس الأولى من الثمانينيات، وتطورها في السنوات الأخيرة من حكم السادات على نحو يظهر الثمانينيات في ثوب ناصع للغاية. إذ فلنقارن زيادة بنسبة 44% خلال السنوات الخمس (81-1986) في إجمالي المديونية الخارجية المدنية (من 21.2 بليون دولار إلى 30.3 بليون) بتضاعف ديون السادات المدنية أكثر من ثلاث مرات في ست السنوات الأخيرة من حكمه (من 6.3 بليون دولار في 1975 إلى 21.1 بليون في 1981). وهناك ثانياً اختلاف الظروف الخارجية اختلافاً شاسعاً، حيث تضاعفت ديون السادات بهذا القدر في سنوات بالغة الرخاء، بينما استدانت مصر في الثمانينيات في ظل انخفاض أسعار البترول، وركود المصادر الأساسية الأخرى للنقد الأجنبي. بل إن من الصحيح أيضاً أن جزءاً لا يستهان به من القروض التي سحبتها مصر خلال الثمانينيات كان قد تم التعاقد عليه بالفعل أيام السادات. وقد قدر وزير التخطيط هذا الجزء بنحو ثلثي الزيادة في ديون مصر الخارجية المدنية خلال الفترة (81-1986). يمكننا أيضاً أن نضيف أن الاعتذار الذي تعودنا سماعه لتبرير ديون السبعينيات، وهو حاجة المرافق العامة لمبالغ طائلة للنهوض بها مما تردت إليه، إنما يصلح لتبرير قروض الثمانينيات بدرجة أكبر بكثير مما يصلح لتبرير قروض السادات. فالتحسن الملحوظ في حالة المرافق العامة، وخاصة في قطاع النقل والمواصلات، وفي مياه الشرب والصرف الصحي، إنما يرجع في الاساس إلى قروض تم سحبها في الثمانينيات وليس قبل ذلك.
كل هذا صحيح، وإنما يكمن اعتراضنا الأساسي على السياسة الاقتصادية لهذه الفترة في أمرين:
الاعتراض الأول: هو أن التورط في الاقتراض لتمويل مشروعات المرافق العامة في ظل إهمال واضح للقطاعات السلعية التي يمكنها وحدها أن تولد القدرة على خدمة هذه القروض في المستقبل، كان يعكس استمراراً لنفس سياسة السبعينيات التي تقوم على تبني أسهل الحلول في المدى القصير مع تجاهل أثرها المدمر على الاقتصاد في المدى الطويل. كانت هذه السياسة تعكس توجهاً آخر أكثر عمقاً للسياسة الاقتصادية في الثمانينيات والسبعينيات معاً، ويتعلق بموقفها من دور كل من القطاع العام والقطاع الخاص. فقد قامت فلسفة الانفتاح الاقتصادي منذ تدشينها في 1974، وما زالت مستمرة دون انقطاع حتى اليوم، على تقليص مسئولية القطاع العام وتركيز توسعاته على مشروعات المرافق العامة، على افتراض أن يقوم القطاع الخاص بنصيب متزايد من استثمارات الزراعة والصناعة. هذه النظرة إلى توزيع مسئوليات التنمية ما كانت لتحدث بالضرورة ضرراً لمعدلات التنمية في المدى الطويل، لو كان القطاع الخاص قد قام فعلاً بالدور المنوط به في تنمية القطاعات السلعية. ولكن هذا لم يحدث خلال السبعينيات، وتفاقم الاختلال لصالح قطاعات الخدمات وعلى حساب الزراعة والصناعة، كما سبق أن رأينا، سواء من حيث نصيب هذه القطاعات في الناتج القومي أو في خلق فرص العمالة. وقد اعترفت وثيقة خطة التنمية (82/83- 86-1987) بهذا صراحة، وجعلت من بين أهدافها تصحيحه.
ولكن نفس النمط من التنمية استمر خلال سنوات الخطة. ففي الوقت الذي أقبلت فيه الحكومة على الاقتراض لتمويل مشروعات المرافق العامة، تراخت جهود القطاع الخاص، المحلي والأجنبي، في الاستثمار في القطاعات السلعية، وأقبلت بدورها على الاستثمار في قطاعات التجارة والمال والإسكان، وفي مشروعات ضئيلة الأثر في زيادة القدرة على التصدير، وشديدة الاعتماد على الاستيراد. بل إن مقارنة توزيع الاستثمارات المنفذة بالفعل خلال السنوات الثلاث الأولى من سنوات الخطة (82/83- 86-1987)، بتوزيع الاستثمارات في السنوات الخمس السابقة عليها (77-81/1982) لا تظهر أي تقدم في هذا الصدد، إذ بلغ نصيب القطاعات السلعية في إجمالي الاستثمارات المنفذة 49% في ثلاث السنوات المذكورة. و49.3% في السنوات الخمس السابقة عليها، ترتب على ذلك بالطبع استمرار الاختلال في الجهاز الإنتاجي لصالح قطاعات الخدمات وهو ما يحمل مغزى هاماً فيما يتعلق بمشكلة المديونية الخارجية. إذ بينما انهمكت الحكومة في الاقتراض لتمويل مشروعات ليس من شأنها توليد عائد كاف من العملات الأجنبية يمكنها به خدمة قروضها، لم يعوض القطاع الخاص هذا العجز بتوليد دخل كاف من الصادرات، بل شكلت الاستثمارات الأجنبية الخاصة عبئاً متزايداً على ميزان المعاملات التجارية، بما تولده من طلب على الواردات، وما تحوله من أرباح للخارج، وأهم من ذلك ما تسرب من خلال فروع البنوك الأجنبية من مدخرات المصريين بالعملات الأجنبية.
لقد وصفنا هذا التوجه العام نحو تركيز الحكومة على الاستثمارات في مشروعات المرافق العامة بالاعتماد على القروض الأجنبية، وصفناه بأنه كان أسهل الحلول في المدى القصير لأنه كان في الواقع يعفي الحكومة من الأعباء السياسية التي يفرضها الحل البديل وهو تعبئة أقصى قدر من الموارد الذاتية من القادرين على الدفع، ولأنه كان يعفيها كذلك من محاولة مقاومة الإغراء الذي يمارسه المقرضون لتمويل مشروعات بعينها، قد لا تحتل أولوية خاصة في نظر المخطط ولكنها تجلب للمقرض نفسه مغانم محققة. هذه المغانم لا تتمثل فقط، ولا أساساً، في خدمة القروض بل فيما تتيحه القروض للمقرض من تصريف منتجات يعجز عن تصريفها بعائد عجز. بل إن هذا التوجه كان يعفي الحكومة ايضاً من محاولة مقاومة الضغوط التي تمارسها الدول المقرضة نفسها في سبيل استمرار سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تترك مشروعات الاستثمار، خارج نطاق المرافق العامة، مفتوحة للاستثمار الخاص.
إن القول بأن جزءاً لا يستهان به مما اقترضته مصر خلال السبعينيات والثمانينيات كان بضغط وإغراء المقرضين وتحقيقاً لمصلحتهم، لا هو من قبيل التخيل ولا هو يصف ظاهرة جديدة لم تعهدها مصر من قبل. فقد سبق أن رأينا كيف كان الجزء الأكبر من ديون إسماعيل، من هذا النوع، والمسئولون الرسميون أنفسهم يضطرون في بعض الأحيان للاعتراف به صراحة. ففي حديث لوزير التخطيط، الذي تسلم مسئولية التخطيط في مصر في بداية الثمانينيات، تحدث الوزير عما تعرضت له مصر في السبعينيات من "إغراء وتوجيه للاستدانة" من جانب الدول الصناعية بسبب "زيادة الفائض المالي لديها". ولا نرى من جانبنا سبباً للاعتقاد بأن نفس "الإغراء والتوجيه للاستدانة" اللذين مورسا في السبعينيات لم يمارسا أيضاً خلال النصف الأول من الثمانينيات. قد لا يكون الأمر قد اختلف بالفعل عما كان عليه في السبعينيات من حيث مدى توفر الأموال السائلة لدى الدول المقرضة، ولكن المصالح الأخرى التي يحققها الإقراض للمقرض استمرت قائمة بطبيعة الحال، خاصة مع استمرار الكساد الاقتصادي في الدول الصناعية، وهي المصالح المتمثلة في تصريف سلع وخدمات يصعب تصريفها بعائد مجز. من الأمثلة الصارخة لذلك ما يذكره تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر عن مشروع الصرف الصحي لمدينة الإسكندرية، ومشروع تطوير ميناء السويس اللذين مولا بقروض أمريكية، وذهب 59.5% من حصيلة القرض الأول و43.3% من حصيلة القرض الثاني مقابل أتعاب المكاتب الاستشارية الأجنبية التي قامت بإعداد الدراسات الخاصة بالمشروعين، وما يذكره نفس التقرير من أن نفقات شحن بعض السلع التي تشتريها مصر من الولايات المتحدة بحصيلة بعض القروض الأمريكية، وتشترط اتفاقية القرض شحنها على سفن أمريكية، تبلغ في بعض الأحيان أربعة أضعاف الأسعار السائدة للشحن، وأن وزارة الصناعة المصرية أخطرت الجهاز المركزي للمحاسبات بخطاب مؤرخ 12/2/1985، بأن أسعار بعض السلع الأمريكية التي تمولها قروض أمريكية تبلغ في بعض الأحيان ضعفي الأسعار المتاحة لمصر من دول أخرى.
على أن أكبر مغنم يتحقق للمقرضين، هو بالطبع الذي يأتي من الإقراض العسكري، وهذا يقودنا إلى الوجه الثاني للاعتراض على توجه السياسة العامة في النصف الأول من الثمانينيات. إن ديون مصر العسكرية قد زادت، كما رأينا، بنحو 80% في خمس سنوات (من نحو خمسة ملايين في 1981 إل 8-9 بلايين في 1986). وقد بدأت الزيادة الكبيرة في الديون العسكرية في 1979، مع بداية الاقتراض لأغراض عسكرية من الولايات المتحدة في أعقاب اتفاقية "السلام" بقرض قدره 1.5 بليون دولار. ثم تزايد الاقتراض العسكري باطراد حتى بلغت ديوننا العسكرية للولايات المتحدة 4.5 بليون دولار في مطلع 1985، حينما أصبحت المعونات العسكرية الأمريكية منذ ذلك الوقت منحاً لا ترد. ولكن ما كان قد تم اقتراضه اقترن بشروط بالغة القسوة استمرت في إرهاق كاهل ميزان المدفوعات المصري. فقد بلغ سعر الفائدة الذي قدمت هذه القروض العسكرية بمقتضاه 12% في المتوسط، الأمر الذي كلف ميزان المدفوعات في 81/1982، كفوائد على الديون العسكرية وحدها، 173 مليون دولار، ارتفعت إلى 463 مليوناً في 84/1985 أو ما يمثل 13% من إجمالي خدمة الديون الخارجية في تلك السنة. اقترنت هذه القروض العسكرية أيضاً بعقوبات على التأخير في سدادها تتمثل في إضافة أربع نقاط مئوية إلى سعر الفائدة المتفق عليها (فيصبح سعر الفائدة 16% بدلاً من 12%) على كل مبلغ يتأخر سداده لمدة ستين يوماً أو أكثر. وقد بدأت مصر بالفعل في التأخر في سداد هذه الديون في 1984، ثم لم تستطع أن تدفع في السنة التالية أكثر من 38% من المستحق دفعه منها. ود قدر بنك التمويل الفيدرالي (الأمريكي) حجم المتأخرات من هذه الديون في يوليو 1986 بمبلغ 527 مليون دولار.
لقد ذكرنا وجنين أساسيين للاعتراض على سياسة الاقتراض في الثمانينيات، يشترك في تحمل المسئولية عنهما المقرض والمقترض معاً. فكل من الإغراء والضغط يحتاج إلى طرفين، ذلك الذي يمارس الإغراء أو الضغط وذلك الذي يخضع لهما. إن من الممكن بالطبع القول بأنه لم يكن هناك مفر أمام الطرف الأضعف من الخضوع وقبول ما يفرض عليه من شروط، ولكن الحكم فيما إذا كان هذا من شأنه أن يعفي الطرف الأضعف من المسئولية يثير من القضايا الأساسية والأخلاقية ما يخرج عن نطاق بحثنا.
يهمنا هنا أن نبين ما آل إليه هيك المديونية الخارجية لمصر في منتصف 1986، وما اتسم به من اختلال واضح لصالح الكتلة الغربية، بعد أن كان هذا الهيكل يتسم بدرجة عالية من التوازن بين الكتلتين في 1970. ففي آخر يونيو 1986 كان التوزيع النسبي لإجمالي قروض مصر العامة المدنية، الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأجل (30 بليون دولار) على النحو التالي: 25% للولايات المتحدة، 33.3% لبقية الدول الغربية واليابان وأستراليا، 9.5% لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، 21% لدول ومؤسسات عربية، 3% للكتلة الشرقية. وهكذا اقترن التحول في السياسة الاقتصادية والخارجية لمصر منذ بداية السبعينيات، بارتفاع نصيب الدول والمؤسسات الغربية والمنظمات الدولية السائرة في ركابها من 46% من ديون مصر المدنية في نهاية 1971 إلى 68% في منتصف 1986، وارتفع نصيب البلاد العربية من نحو 11% إلى 21%، بينما انخفض نصيب الكتلة الشرقية من 43% إلى 3% خلال نفس الفترة.
| الاحتياطي النقدي السائل في مصر في 1990. |
صدمة منتصف الثمانينيات
في 1986 تعرض الاقتصاد المصري لصدمة عنيفة أظهرت بجلاء جوانب الضعف في بنيان مصر الاقتصادي برمته، وألقت مزيداً من الضوء على أخطاء تراكمت خلال أكثر من عقد كامل، وكأن مصر قد طولبت فجأت بأن تسدد حساباً دأبت على تأجيل دفعه عاماً بعد عام. هذه الصدمة كانت بالطبع هي الانخفاض الحاد في أسعار البترول. كان العجز المزمن في ميزان المعاملات التجارية قد أخذ في التزايد بسرعة منذ بداية سنوات الخطة (82/1983)، ولكن مع الهبوط الشديد في أسعار البترول في أوائل 1986 أصبح من المؤكد أن هذا العجز خلال السنة الأخيرة من الخطة (86/1987) سوف يصل إلى أبعاد خطيرة من شأنها أن تفرض أعباء اقتصادية لم تواجهها مصر منذ عشرة أعوام على الاقل، أي منذ أن أعيد فتح قناة السويس وبدأ تدفق إيرادات البترول، وينتكس معها معدل النمو أياً كانت السياسة الاقتصادية التي يمكن أن تتبع. لقد أصبح من المؤكد أن إيرادات البترول سوف تنخفض بما لا يقل عن 50% خلال العام، وأن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سوف تنخفض بدورها نتيجة الانخفاض الشديد في إيرادات دول البترول المضيفة، وأن الاتجاه الذي كان قد بدأ بالفعل لعودة أعداد لا يستهان بها من المصريين العاملين في هذه الدول سوف يزداد بقوة، الأمر الذي يخلق تهديداً جديداً لسوق العمالة في مصر التي كانت عاجزة، حتى قبل ذلك، عن توفير فرص العمالة بالمعدل المطلوب. أما المصدران الهامان الآخران للنقد الأجنبي، وهما قناة السويس والسياحة، فقد أصابهما الضعف بدورهما، الأول بسبب كساد سوق البترول نفسه، والثانية بسبب ما اقترنت به 1986 والسنة السابقة عليها من أحداث سياسية عنيفة أثرت على معدل تدفق السياحة في مصر.
زاد الطين بلة أن سنة 85/1986 اقترنت أيضاً بحلول موعد سداد بعض الأقساط لديون سابقة، زادت بشدة من عبء خدمة الدين في تلك السنة عن السنوات السابقة عليها. فطبقاً لتقدير صندوق النقد الدولي، كان المستحق على مصر دفعه في تلك السنة لخدم الديون لا يقل عن 5.5 بليون دولار (2.9 بليون سداداً لأصل الدين و2.6 بليون فوائد)، وهو ما لا يقل كثيراً عن ضعفي خدمة الديون في 1981، ويمثل أكثر من 50% من كل إيرادات مصر من العملات الأجنبية من صادرات السلع والخدمات في تلك السنة، أي أنه يلتهم وحده كل إيرادات مصر من البترول وقناة السويس والسياحة معاً، بالإضافة إلى نحو ثلث تحويلات المصريين العاملين بالخارج. بينما كان ما على مصر دفعه في تلك السنة من الفوائد وحدها يفوق كل ما تلقته خلالها من الولايات المتحدة من قروض ومنح، مدنية وعسكرية. لم تكن مصر قادرة بالطبع على الوفاء بهذا المبلغ. كانت مصر قد توقفت بالفعل منذ عدة سنوات عن الوفاء ببعض التزاماتها لدائنيها. ففي أعقاب مؤتمر بغداد في مارس 1979، الذي شجب اتفاقية كامب دافيد، أصدرت الحكومة المصرية قراراً بالتوقف عن خدمة ديونها المستحقة للدول المشاركة في ذلك المؤتمر، وكان هذا القرار يتعلق بديون قيمتها نحو أربعة بلايين دولار، وترتب عليه أن توقفت مصر منذ ذلك الوقت عن خدمة ديونها للبلاد العربية بما في ذلك ديونها لما سمي بـ"هيئة الخليج لتنمية مصر" التي تكونت في 1976. كذلك توقفت مصر عن خدمة ديونها العسكرية للاتحاد السوفيتي في 1980 بعد إدانة السوفييت لاتفاقية كامب دافيد، ولم تكن تقوم بخدمة ديونها المستحقة لإيران. بالإضافة إلى ذلك بدأت مصر في التأخر في خدمة ديونها لعدد من الدول العربية حتى بلغ حجم المتأخرات في السداد أكثر من بليون دولار في 84/1985 ويقدر البعض أن هذه المتأخرات قد وصلت إلى 2 بليون في 85/1986.
من الممكن النظر إلى حالة المديونية الخارجية لمصر كما بدت في 1986، وما آل إليه الوضع الاقتصادي بوجه عام في ذلك الوقت، من أكثر من زاوية، كلها صحيح. فمن الممكن القول، من ناحية، بأن التركة الثقيلة التي خلفها السادات للاقتصاد المصري في 1981، وتتمثل أساساً في أعباء ثقيلة من الديون في بنيان اقتصادي شديد الاختلال بدرجة يعجز معها عن خدمتها، لم يكن من الممكن التخفيف منها خلال السنوات الخمس الأولى من عهد الرئيس مبارك، بسبب تضافر مجموعة من العوامل الخارجية غير المواتية وانقضاء الرواج الذي اتسمت به سنوات السادات الأخيرة، وذلك حتى لو كانت الإدارة الاقتصادية قد أدخلت إصلاحات جذرية على السياسة الاقتصادية المتبعة، إذ أن هذه الإصلاحات، حتى ولو كانت قد طبقت بالفعل، ما كانت لتحدث أثرها بسرعة، ومن ثم ما كانت لتنقذ مصر مما آلت إليه في 1986. ومن الممكن القول، من ناحية أخرى، بان الوضع الذي آل إليه الاقتصاد المصري في 1986، كان في الأساس نتيجة لفشل وأخطاء السياسة الاقتصادية المطبقة منذ 1974، والتي استمرت ملامحها الرئيسية كما هي حتى 1986. إن من الممكن إطلاق وصف "الانفتاح الاقتصادي" للدلالة على الملامح الرئيسية لهذه السياسة، ولكن هذا وحده لا يكفي للدلالة على كل أوجه القصور التي اتسمت بها، والتي ترتبت عليها الأزمة الاقتصادية في منتصف الثمانينيات. إن من المؤكد في رأينا، أن سياسة الحرية الاقتصادية التي دشنت في 1974، بما عنته من إطلاق حرية الاستيراد، وفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية الخاصة دون تمييز كاف بينها حسب مدى مساهمتها في زيادة الصادرات، وأمام فروع البنوك الأجنبية دون رقابة كافية على ما تقوم به من تحويل مدخرات المصريين إلى الخارج، من المؤكد أن هذا وحده كان كفيلاً بزيادة عجز ميزان المدفوعات وزيادة المديونية الخارجية. ولكن الذي زاد الأمر سوءاً أن سياسة الانفتاح، كما طبقت بالفعل، كانت تتسم، بالإضافة إلى ذلك، بدرجة عالية من التخبط وعدم الاتساق حرمت الاقتصاد المصري حتى من بعض المزايا التي كان يمكن أن تترتب على إطلاق الحرية لقوى السوق وتشجيع الحافز الفردي. إن المعنى الذي نريد أن نؤكده هنا هو أنه، حتى إذا طرحنا الاعتبارات الاجتماعية والأيديولجية جانباً، وافترضنا أن سياسة الحرية الاقتصادية كانت هي السياسة الأفضل في ظروف مصر في السبعينيات والثمانينيات من حيث رفع معدل النمو وتصحيح الاختلال في البنيان الاقتصادي، وتجاهلنا أثرها على توزيع الدخل على افتراض أنه سوف يصحح تلقائياً مع استمرار معدل النمو في الارتفاع، حتى إذا افترضنا كل ذلك (مع أننا لا نميل إلى قبوله) فإن هذه السياسة ما كان من المحتمل أن تصادف النجاح المفترض إلا إذا كان قد توفر لها حد أدنى من الاتساق والانسجام بين عناصرها الأساسية. فليس هناك أسوأ، فيما يبدو لنا، من سياسة اقتصادية تحاول أن تحقق أهدافاً اقتصادية متعارضة في آن واحد، كالتي تحاول توزيعاً أفضل للدخل مع اجتذاب أكبر حجم ممكن من الاستثمارات الخاصة، أو التي تحاول أن تحمي القطاع العام في نفس الوقت الذي تحاول فيه تشجيع الاستثمارات الأجنبية، أو التي تحاول توفير الضرورات الغذائية بأسعار متدنية في نفس الوقت الذي تريد فيه تشجيع الصادرات الزراعية.. إلخ.
والواقع أن نجاح تجربة التنمية في مصر في الفترة (56-1965)، التي حقق الاقتصاد المصري خلالها معدلاً عالياً للنمو وتغييراً ملحوظاً، في نفس الوقت، في الهيكل الاقتصادي، مع تحقيق مستوى معقول من الاكتفاء الذاتي في الغذاء ودون أن تتحمل البلاد عبئاً ثقيلاً من المديونية الخارجية، هذا النجاح يرجع إلى حد كبير إلى ما اتسمت به السياسة الاقتصادية في تلك الفترة من درجة عالية من الاتساق والانسجام بين مختلف أدوات السياسة الاقتصادية، حيث تدخلت الحكومة في أدق تفاصيل النشاط الاقتصادي، وطبق نظام التخطيط بدرجة من الجدية لم تعرف مصر مثلها قبل تلك الفترة أو بعدها، وخضعت الأسعار للسيطرة الإدارية، وخفض الاستثمار الأجنبي الخاص إلى الحد الأدنى، وكاد يقتصر الاستثمار الوطني بأكمله على القطاع العام. على العكس من ذلك اتسمت سياسة الانفتاح الاقتصادي منذ 1974 وحتى 1986، بدرجة عالية من التردد وعدم الاتساق في تطبيق مبدأ الحرية الاقتصادية، وكانت كما يقول التعبير الشعبي "كمن رقص على منتصف السلم"، أو كما سقط بين مقعدين، فلا هي طبقت سياسة الحرية الاقتصادية بحذافيرها، ولا هي تبنت سياسة التدخل الحكومي الصارم بمختلف متطلباتها، ومن ثم لم تحرز مزايا هذه ولا تلك، بل عانت من نقائص كليهما. مثال ذلك ميل عجز الموازنة العامة إلى التزايد عاماً بعد آخر، إذ في الوقت الذي استمرت فيه الدولة في سياسة دعم السلع الضرورية (بل وبعض السلع الكمالية أيضاً) وفي الالتزام بتعيين الخريجين، بما يخلقه كلاهما من عبء في جانب الإنفاق الحكومي، لم تلجأ الدولة إلى تعويض ذلك بزيادة الإيرادات الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي. وقل مثل ذلك عن أثر تضارب أدوات السياسة الاقتصادية على توزيع الاستثمارات، إذ بينما استمرت سياسة التحديد الإداري لأسعار بعض المنتجات الزراعية والصناعية، على نفس النمط الذي كان سائداً قبل الانفتاح، الأمر الذي لم يكن من شأنه تشجيع الاستثمار الخاص على ولوج بعض أوجه الاستثمار في هذين القطاعين، تراخى معدل الاستثمار العام في كل منهما ولم تستخدم وسائل التدخل الإداري بكبح جماح الاستثمار الخاص في القطاعات قليلة الإنتاجية. يذكر الدكتور عبد الجليل مثالاً آخر هاماً لنفس الخطأ في مجال التعليم إذ يقول: "كيف نعلل قرار الحكومة بالتزامها بإيجاد عمل لكل من ليس له عمل، وهو المتبع في البلاد الاشتراكية، وفي نفس الوقت لا تتبع السياسة التي يستلزمها هذا (الالتزام بالتعيين) من حيث مراقبة توجيه من يدخل المدارس الثانوية العامة وعدد من يدخل المدارس الفنية، وبالتالي نحد من الالتحاق بالجامعات وكلياتها بحيث لا يتخرج إلا الأعداد المطلوبة من خريجي الجامعات، وهو النظام المتبع بدقة في البلاد الاشتراكية؟". نلاحظ ايضاً أثر هذا التضارب وعدم الاتساق على معدل الزيادة في الواردات بالمقارنة بالصادرات. فهنا أيضاً نجد أن الاعتماد على قوى السوق في تخفيض معدل النمو في الواردات وتشجيع الصادرات كتخفيض سعر الصرف، ك ن دائماً جزئياً وناقصاً، إذ ظلت الفجوة واسعة دائماً بين سعر الصرف الرسمي وسعره في السوق الحرة، ولم يقترن هذا بسياسات أخرى يتطلبها منطق الحرية الاقتصادية نفسه، كالتخفيف من القيود الإدارية على الصادرات وتبسيط إجراءات التصدير، في الوقت الذي أحجمت فيه الدولة عن التدخل الجدي في حرية الاستيراد، وإذا بالاستيراد لا يكبح جماحه لا قوى السوق الحرة ولا التدخل الحكومي المباشر، فيزداد ميزان المعاملات التجارية عجزاً وتزداد الحاجة إلى الاقتراض. ولكن هناك زاوية ثالثة يمكن النظر منها إلى ما آل إليه الاقتصاد المصري والمديونية الخارجية في 1986، حيث تظهر أزمة الاقتصاد كانعكاس لطبيعة العلاقات الاقتصادية الدولية. ذلك أنه من الممكن النظر إلى أخطاء السياسة الاقتصادية منذ أوائل السبعينيات وما اتسمت به من تحول غير مبرر في توجهها العام، ومن مظاهر التضارب وعدم الاتساق بين عناصرها المختلفة، على أنها كانت في الأساس استجابة لضغوط خارجية لم يكن من السهل مقاومتها. لقد سبق أن أشرنا إلى أن التورط غير المبرر في الديون في النصف الأول من السبعينيات كان، جزئياً على الاقل، استجابة لتوفر السيولة في أيدي المصارف الغربية ومؤسسات التمويل التي كانت تبحث عن فرص الاستثمار المجزي خارج حدودها، وأن أزمة السيولة التي عانت منها مصر في منتصف السبعينيات كانت من الوسائل التي استخدمت لفرض تسوية مع إسرائيل ربما لم تكن مصر لتقبلها في ظروف اقتصادية مختلفة. كذلك فإن من الممكن النظر إلى الإمعان في التورط في الديون في السنوات الخمس الأخيرة من عهد السادات، رغم كل ما تدفق على مصر خلالها من نقد أجنبي، على أنه كان بدوره، ولو جزئياً أيضاً، استجابة لضغوط وإغراءات الدول والمؤسسات المقرضة التي كانت تحقق نفعاً محققاً من الاقتراض، يتمثل في تصريف سلع وخدمات يصعب تصريفها بغير ذلك، وكوسيلة أكيدة تمكن الدول المقرضة من فرض إرادتها السياسية في أيام مقبلة. من الممكن أيضاً أن ننظر إلى السنوات الخمس التي أعقبت مقتل السادات من نفس المنظور، حيث زاد توريط مصر في الديون المدنية والعسكرية تحقيقاً لنفس الأغراض.
ليس المقصود بذلك أن نعفي أحداً من المسئولية، وأن نتعلل بمسئولية العوامل الخارجية لراحة ضمائرنا. فكا سبق أن قلنا: إن التورط في الديون يحتاج إلى طرفين لا يمكن أن يعفى أحد منهما من المسئولية عنه. وإنما المقصود أن نشير إلى أن تجنب الخطأ في اتخاذ القرارات الاقتصادية لا يتطلب فقط حداً أدنى من المعرفة والحكمة، وإنما يتطلب أيضاً حداً أدنى من حرية الإرادة وإصراراً على استخدام القدر المتاح منها. وقد كانت مصر دائماً، وبدرجة أكبر من دول كثيرة أخرى، معرضة لفقدان هذه الحرية. ولكن هذا لا ينفي أيضاً أن الرجال ليسوا سواء في مدى استعدادهم لتولي المسئولية في ظل ظروف لا يمارسون فيها حريتهم في التصرف، كما أنهم ليسوا سواء في حرصهم على استخدام القدر المتاح من هذه الحرية لأبعد مدى ممكن. يهمنا هنا أيضاً أن نلاحظ أوجه شبه أخرى بين تجربة مصر في المديونية الخارجية في السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين، وما مرت به في السبعينيات من القرن التاسع عشر والعقود الثلاث الأخيرة التي تلت الاحتلال الإنجليزي لمصر.
سبق أن رأينا كيف أن تورط مصر في الديون في عهد الخديوي إسماعيل اقترن بفترة من الرخاء سال لها لعاب المقرضين والمرابين الأوروبيين، وأنه ما إن وصلت الديون حداً لم تعد موارد مصر تسمح معه بخدمة ديونها، حتى انقض الدائنون عليها مطالبين بالسداد، وفرضوا على مصر السياسات التي تهيء لهم استرداد أموالهم وفوائدها، متسلحين بما وفرته لهم قوات الاحتلال الإنجليزي من سيطرة. وقد ترتب على ذلك أن أنفقت مصر العقود الثلاثة التالية للاحتلال في تنمية مواردها الزراعية لتستخدم الفائض الناجم عنها في خدمة ديونها. ولكننا نلاحظ أيضاً أنه في فترة ما بين الحربين العالميتين، التي فرضت خلالها الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر أعباء اقتصادية ثقيلة، استمرت مصر في خدمة ديونها إلى أن سددتها جميعاً، وهي أقل ما تكون قدرة على تحمل أعبائها وأشد ما تكون حاجة إلى الاقتراض بدلاً من تسديد الديون القديمة. ولكن الأزمة العالمية لم تكن شراً محضاً على مصر (إذ أن قليلاً من الأمور هو شر محض)، فقد اضطرت مصر خلالها إلى تطوير هيكلها الاقتصادي، حيث قامت الصناعات الوطنية الناشئة لتلبي حاجات كانت مصر تلبيها من قبل عن طريق الاستيراد ثم امتنع عليها ذلك بسبب ضآلة مواردها من النقد الأجنبي. وكان استحكام الأزمة نفسه في عقد الثلاثينيات، هو الذي فرض على مصر تنويع جهازها الإنتاجي، حينما عجزت مواردها الزراعية وحدها عن القيام بعبء خدمة الديون وتلبية حاجات الاستهلاك في نفس الوقت، فإلى أي حد تكرر هذا الأثر الطيب خلال العقدين التاليين لأزمة 1986؟
الانكماش الاقتصادي: 1986-2004
كان من المحتم أن تزيد ديون مصر الخارجية بعد 1986، بسرعة أكبر مما كانت تزيد به في السنوات الخمس السابقة، ومع ذلك فإن معدل النمو في هذه الديون لم يبلغ قط معدل نموها خلال السبعينيات. فقد زادت هذه الديون بنسبة 21% خلال ثلاث سنوات التالية لصدمة انخفاض أسعار البترول في 1986، فبلغت 45.7 بليون دولار في يونيو 1989. وقد بلغ حجم الفوائد المدفوع بالفعل أكثر من 50% من إجمالي حصيلة الصادرات السلعية. صحيح أن المصادر الأساسية الثلاثة للعملات الأجنبية، عدا البترول، وهي تحويلات العاملين بالخارج وقناة السويس والسياحة، قد جلبت معاً لمصر خلال 89/1990 ما يعادل تقريباً ضعفي مجموع ما جلبته كل الصادرات السلعية، ولكن ظلت مصر تحقق عجزاً في حساب العمليات الجارية قدره (باستبعاد التحويلات الرسمية) 2284 مليون دولار، أي أكثر من خمس قيمة كل الواردات السلعية. فإذا أدخلنا في حسابنا التحويلات الرسمية لتلك السنة، ينخفض العجز في حساب العمليات الجارية إلى نحو النصف، ومع هذا يظل هناك عجز قدره 1214 مليون دولار في وقت كانت مصر تتخلف فيه عن الوفاء بأكثر من ثلث الفوائد المستحقة عليها. كان وضع المديونية إذن قاتماً إلى حد كبير عشية تفجر أزمة الخليج في أغسطس 1990. ففي ذلك الوقت كان إجمالي الديون الخارجية قد بلغ 47.6 بليون دولار أي أكثر من 150% من الناتج المحلي الإجمالي، مما جعل عبء الدين الخارجي لمصر من أعلى أعباء الديون في العالم، إذا قيس بنسبته للناتج المحلي، وأعلى كذلك من عبء الدين الخارجي الثقيل الذي كانت تحمله مصر قبل قرن من الزمان (نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي)، والذي أدى إلى عزل الخديوي إسماعيل عن عرشه واحتلال بريطانيا لمصر. في 1990 كان مبلغ خدمة الديون المستحقة على مصر قد ارتفع إلى 6 بليون دولار (أي ما يمثل 54% من قيمة جميع صادرات مصر من السلع والخدمات)، وضاقت بشدة فرص الاقتراض التجاري أو الرسمي المتاحة لمصر، وبدأت الحكومة تواجه صعوبات شديدة في تمويل بعض الورادات الأساسية من المواد الغذائية. كما هذا هو الوقت الملائم بالضبط لأن يقتطع شيلوك (الدائن) رطل اللحم من جسم أنطونيو (المدين). كان رطل اللحم المطلوب في هذه الحالة هو وقوف مصر للاشتراك إلى جانب القوات الأمريكية، عجز قدره 1214 مليون دولار في وقت كانت مصر تتخلف فيه عن الوفاء بأكثر من ثلث الفوائد المستحقة عليها.
كان وضع الميزانية إذن قاتماً إلى حد كبير عشية تفجر أزمة الخليج في أغسطس 1990. ففي ذلك الوقت كان إجمالي الديون الخارجية قد بلغ 47.6 بليون دولار أي أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي، مما جعل عبء الدين الخارجي لمصر من أعلى أعباء الديون في العالم، إذا قيس بنسبته للناتج المحلي، وأعلى كذلك من عبء الدين الخارجي الثقيل الذي كانت تحمله مصر قبل قرن من الزمان (نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي)، والذي أدى إلى عزل الخديوي إسماعيل عن عرشه واحتلال بريطانيا لمصر. في 1990 كان مبلغ خدمة الديون المستحق على مصر قد ارتفع إلى 6 بليون دولار (أي ما يمثل 54% من قيمة جميع صادرات مصر من السلع والخدمات)، وضاقت بشدة فرص الاقتراض التجاري أو الرسمي المتاحة لمصر، وقد بدأت الحكومة تواجه صعوبات شديدة في تمويل بعض الواردات الأساسية من المواد الغذائية. كان هذا هو الوقت الملائم بالضبط لأن يقتطع شيلوك (الدائن) رطل اللحم من جسم أنطونيو (المدين). كان رطل اللحم المطلوب في هذه الحالة هو وقوف مصر إلى جانب الولايات المتحدة ضد صدام حسين، إلى حد إرسال قوات مصرية للاشتراك في الحرب إلى جانب القوات الأمريكية، وذلك كطريقة للوفاء بديون لم يكن لدى مصر أي موارد لتسديدها. ومن الطريف أن نلاحظ أنه خلال ستة الأشهر التالية لبدء أزمة الخليج، حصلت مصر على تعهدات بمساندات مالية بلغت 4726 مليون دولار من بعض الدول العربية، أهمها المملكة العربية السعودية والكويت ودولة الإمارات، وهي نفس الدول التي كانت خاصمت مصر وأدارت ظهرها لها منذ عشر سنوات بسبب توقعيها اتفاقية السلام مع إسرائيل. ولكن الأهم من ذلك ما حصلت عليه مصر من إعفاءات كبيرة من ديونها. أعفيت مصر أولاً، من جانب الولايات المتحدة ودول الخليج، من ديون قدرها 13.7 بليون دولار. ثم دعيت مصر إلى عقد اتفاقية في مايو 1991 مع الدول المكونة لنادي باريس، أسفر عن إعفاء مصر من 50% من ديون أخرى، على مراحل، مع الاشتراط بأن يكون حصول مصر على الإعفاء على المرحلتين الأخيرتين (1992 و1994) متوقفاً على تنفيذ مصر لتوصيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فيما سمي بـ"برنامج الإصلاح الاقتصادي". ترتب على هذا أن انخفضت ديون مصر الخارجية من 47.6 بليون دولار في يونيو 1990 إلى 34 بليوناً في فبراير 1991 ثم إلى 24 بليون دولار في منتصف 1994، أي نصف ما كانت عليه في منتصف 1990.
مما يلفت النظر ما حدث لديون مصر الخارجية من ثبات نسبي في السنوات العشر التالية (1994-2004) بالمقارنة بزيادتها بمقدار ستة أضعاف في السنوات العشر التي حكم فيها السادات، وزيادتها بمقدار 60% في السنوات العشر الأولى من حكم مبارك. ففي الفترة (1994-2004) لم تزد ديون مصر الخارجية إلا بمقدار 5.4 بليون دولار (فوصلت إلى 29.4 بليون)، أي بنحو 22% في عشر سنوات. كيف نفسر هذا الثبات النسبي في ديون مصر الخارجية بعد ربع قرن من الزيادة السريعة؟
من الممكن أولاً أن نقول أنه لا يمكن لأي دولة أن تستمر في الاقتراض والتورط في الديون إلى مالا نهاية، إذ لابد أن يأتي الوقت الذي يظهر فيه عجز الدولة عن خدمة ديونها ويبدأ الدائنون في القلق على أموالهم فتدخل الدولة في فترة جديدة تتسم بتسديد الديون السابقة أكثر ما تتسم بعقد قروض جديدة. بعبارة أخرى، لابد أن تدخل الدولة المقترضة في دورة من ازدياد المديونية ثم انحسارها: تزداد ديونها، ليس عندما تشتد بها الضائقة الاقتصادية، بل على العكس عندما تتدفق عليها الأموال فتزداد ثقة الدائنين بقدرتها على السداد، ثم تتوقف عن الاقتراض ويطالبه الدائنون بسداد الديون السابقة عندما يفقدون الثقة في مستقبلها الاقتصادي. لقد حدث هذا كما رأينا مع الخديوي إسماعيل، إذ انهال عليه المقرضون عندما كانت أسعار القطن مرتفعة بسبب الحرب الأهلية الأمريكية، وبدئوا يضيقون عليه الخناق عندما زال عهد الرواج. ثم حدث مرة أخرى مع السادات، عندما انهال عليه المقرضون الذين أسال لعابهم ارتفاع أسعار النفط وتحويلات المهاجرين المصريين إلى الخليج، ثم ضيقوا الخناق على مبارك عندما انخفضت أسعار النفط وبدأ المهاجرون المصريون يعودون إلى مصر. من المكن أيضاً أن نفسر هذا الثبات النسبي في الديون المصرية ابتداءً من أوائل السبعينيات وحتى الآن، بما أصاب الاقتصاد المصري من تدهور في معدل النمو منذ ذلك الوقت، ومن ثم تباطؤ الزيادة في الواردات. ترتب على هذا تحسن في ميزان المدفوعات أغنى مصر عن الالتجاء إلى المزيد من القروض، ولكنه تحسن لا يعكس زيادة القدرة على التصدير بل يعكس انخفاض القدرة على الاستيراد، (فضلاً عن تخلص مصر من جزء كبير من عبء خدمة الديون بما حصلت عليه من إعفاءات لأسباب سياسية).
على أي حال، وأياً كان السبب، فالديون الخارجية، بعد ربع قرن من تولي مبارك لحكم مصر لم تعد مشكلة ملحة، أو حتى مشكلة مطروحة على الإطلاق، مثلما كانت في بداية عهده. فحجم الدين الخارجي في سنة 2004 لم يكن يمثل أكثر من 31.2% من الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة بـ141% في بداية عهد مبارك. ولم يمثل عبء خدمة الديون في سنة 2004 أكثر من 10% من مجموع قيمة صادرات مصر من السلع والخدمات بالمقارنة بـ28% في 1981. يبدو إذن أن "الهم" الذي تجلبه الديون باليل قد زال (أو كاد يزول)، ولكن المدهش أن "الذل بالنهار"، أصبح أشد مما كان. فقد استمرت مصر تابعاً ذليلاً للولايات المتحدة تفعل ما تؤمر به، وتمتنع عما تنهى عنه، بل هناك ما يدل على أن هذا الخضوع قد أصبح أشد مما كان عليه في بداية عهد مبارك. من الممكن تفسير استمرار الخضوع على هذا النحو بعدة أمور. فالديون وإن كانت وسيلة فعالة لإخضاعك، فإنها ليست الوسيلة الوحيدة. فهناك مثلاً الخوف من الفضيحة، إذا كان ممارس القهر يعرف لك زلة تخاف أن تعلن علن الملأ. وهناك اعتماد على سلام يملكنه الغير ولا تستطيع حماية نفسك بغيره. ولكن هناك فوق كل شيء مجرد "الإدمان". فإذا كنت قد اعتدت نمطاً من الحياة بسبب ديونك السابقة، وأصبح من الصعب عليك أن تتخلى عنه، فإن من السهل إملاء الإرادة عليك من جانب من يمكنك من ممارسة هذا النمط من الحياة. إن التاجر قد يستدرجك إلى متجره بتشجيعك على الشراء مع تأجيل الدفع، حتى تتمكن منك الرغبة في الحصول بأي ثمن على ما يبيعه من سلع، هنا لا حاجة بالبائع إلى تأجيل دفع الثمن (أي لا حاجة للإقراض) إذ أن خضوعك لإرادته قد أصبح مضموناً.
حدث شيء كهذا لمصر بين منتصف السبعينيات ونهاية الثمانينيات، إذ أدى الانفتاح الاقتصادي بلا حدود إلى اعتياد (أو إدمان) الشرائح العليا من المجتمع المصري نمطاً جديداً من الحياة. بل وحدث أيضاً خلال هذه الفترة التحول من تسليح الجيش بأسلحة سوفيتية إلى تسليحه بأسلحة أمريكية، وهذا التحول في الحالين يصعب جداً الرجوع عنه. ومن ثم فقد حققت الديون هدفها وأدت وظيفتها، ولم يعد هناك ضرورة لزيادتها، ولو إلى حين.
كانت البداية الحقيقية لعهد مبارك، فيما يتعلق بالاقتصاد، في منتصف الثمانينيات، وليس في بدايتها عندما تولى الريس مبارك الحكم. فقد استمر الاقتصاد في السنوات الخمس الأولى (81-1985) ينمو بمعدل مرتفع وإن كان أقل مما كان في عهد السادات، واستمر الاخلال المألوف في الجهاز الإنتاجي، واستمرت سياسة الانفتاح بلا ضابط، واستمر معدل التضخم مرتفعاً، وكذلك معدل هجرة المصريين إلى دول البترول، ونفس النمط في توزيع الدخل: اتساع في الفجوة بين الدخول ولكن الهجرة تخلق متنفساً لمحدودي الدخل ولخريجي المعاهد والجامعات بتقديم فرص كبيرة للعمل المجزي في الخارج. ثم انخفضت بشدة أسعار البترول في 1986، فانخفضت بسبب ذلك إيرادات الحكومة المصرية من البترول، كما انخفض معدل الهجرة تبعاً لانخفاض إيرادات دول الخليج، فزادت البطالة للسببين: الحكومة تنفق أقل لانخفاض إيراداتها، ودول البترول تطلب عمالة مصرية أقل لانخفاض إيراداتها ايضاً. ثم زاد الطين بلة تدخل صندوق النقد الدولي في 1987 لفرض سياسة سميت بالتصحيح أحياناً والتثبيت والتكيف الهيكلي أحياناً أخرى، إذ وجدها الصندوق فرصة سانحة للتدخل بفرض شروطه عندما ظهر عجز الحكومة المصرية عن خدمة ديونها. والصندوق يطلب عادة، في سبيل إعادة جدولة الديون، أي تقسيطها ومد آجال السداد، أن تتبع الدولة المدينة سياسة انكماشية، أي أن تلتزم الحكومة بتخفيض إنفاقها، (وعلى الأخص تخفيض الدعم الممنوح للسلع والخدمات الضرورية)، وهذا من شأنه تخفيض معدل التضخم، ولكنه يخفض أيضاً من معدل نمو الناتج القومي ويزيد البطالة فتزداد أعباء الفقراء.
هذا هو ما حدث بالضبط في العقدين التاليين (1986-2004): معدل النمو في الناتج القومي لا يزيد في المتوسط، عن 4% سنوياً، أي زيادة في متوسط الدخل الحقيقي أقل من 2% وهو أقل بدرجة ملحوظة مما تحقق في عهد السادات وعبد الناصر على السواء (باستثناء تلك السنوات الثماني الكئيبة التي انقضت بين هزيمة 1967 وبداية عهد الانفتاح في 1974. وهي فترة لم نر من الملائم اعتبارها ممثلة لعهد عبد الناصر ولا لعهد السادات). انخفض معدل التضخم في هذين العقدين (1986-2004) عما كان في عهد السادات بسبب السياسة الانكماشية، ولكن بشدة معدل البطالة وتدهور توزيع الدخل فزادت الفجوة بين الدخول. حدث بعض التحسن في الهيكل الإنتاجي لصالح الصناعة التحويلية ولكن علينا أن نتناول الأرقام الدالة على ذلك ببعض الحذر. ذلك أن أداء الصناعة في عهد الرئيس مبارك كان مختلفاً بين فترة وأخرى. ففي السنوات العشر الأولى من حكمه (1981-1990) كان أداؤها قريباً مما كان في عصر السادات ولكنه تدهور بشدة في الخمسة عشر عاماً التالية، فأصبح معدل نمو الصناعة التحويلية في النصف الأول من التسعينيات نحو نصف معدله في النصف الثاني من الثمانينيات (5% و10% على التوالي) ثم استمر التدهور بعد ذلك حتى تراوح هذا المعدل بين 3% و4% في السنوات الأولى من القرن الجديد. على الرغم من هذا المعدل المتواضع لنمو الصناعة في عهد مبارك يلاحظ أن نصيب الصناعة التحويلية في الاقتصاد القومي في سنة 2005، أكبر منه في نهاية عهد السادات. فنصيبها في الناتج المحلي الإجمالي هو 20% (بالمقارنة بـ13.5% في 1981)، ونصيبها في العمالة 14% (بالمقارنة بــ12.5%)، ونصيبها في الصادرات السلعية 45% (بالمقارنة بـ9%). ولكن يقلل من أهمية هذا التقدم أنه خلال العشرين عاماً (1986-2005) تدهور بشدة معدل نمو الناتج القومي، كما تدهورت أسعار النفط، بالمقارنة بما كان عليه معدل نمول الناتج القومي ومستوى أسعار النفط في نهاية عصر السادات، فارتفع نصيب الصناعة التحويلية النسبي دون أن تحدث نهضة صناعية حقيقية.
بالإضافة إلى ضعف النمو الصناعي، تميز تطور الصناعة في مصر في الخمس عشر سنة الأخيرة من عهد مبارك بالاتجاه المتزايد إلى بيعها. كانت سياسة التصنيع في الستينيات مزيجاً من إنشاء شيء من العدم، ونقل ما كان مملوكاً ملكية خاصة، لأجانب أو مصريين، إلى الملكية العامة. ثم بدأ الحديث عن الخصخصة على استحياء في السبعينيات، ولكن ظلت الخصخصة، في السبعينيات والثمانينيات، تواجه بمقاومة شديدة من الاقتصاديين وعمال الصناعة على السواء. إلى أن جاءت التسعينيات فاكتسب دعاة الخصخصة جرأة، وزادت ضغوط صندوق النقد الدولي والإدارة الأمريكية بعد توقيع مصر لاتفاقها مع الصندوق في مايو 1991، ومع البنك الدولي في نوفمبر 1991. ويبدو أن الصندوق والإدارة الأمريكية رأيا، في سنة 2004، أن الخصخصة لابد أن تسير بسرعة أكبر بكثير مما أدى إلى أن وصلت في الحكم حكومة من نوع جديد، أبرز وزرائها من أكبر المتحمسين لبيع القطاع العام.
الاستثمارات الأجنبية والأزمة العالمية: 2004-2009
طوال العشرين عاماً (1986-2004) ظل حجم الاستثمارات الأجنبية الخاصة في مصر ضئيلاً للغاية، بالرغم من كل ما اتخذته الحكومة لتشجيع هذه الاستثمارات، وتعليقها الآمال عليها باعتبارها الحل السحري لمشكلة التنمية. وقد كان كل من تولى رئاسة الحكومة خلال هذه الفترة (عاطف صدقي- الجنزوري- عاطف عبيد) من المؤمنين بأهمية الاستثمار الأجنبي الخاص، ولا يألون جهداً في محاولة اجتذابه. نعم كان المستثمرون الأجنب المحتملون، وكذلك المؤسسات الدولية، دائمي الشكوى من العقبات التي تفرضها البيروقراطية المصرية، من بطء اتخاذ القرارات الحكومية وتعقيداته، واضطرار المستثمر الأجنبي لدفع رشاوي لتسهيل مهمته، ولكني لا أميل إلى رد ضآلة حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال هذه الفترة إلى مثل هذه العوامل، ولا حتى إلى تباطؤ الحكومة المصرية في تخفيض سعر الجنيه المصري. فعندما ارتفع فجأة حجم الاستثمارات الاجنبية في مصر ابتداءً من 2005، لم يكن شيء مهم قد تغير في كل هذه العوامل، فضلاً عن أنه عندما تكون الرغبة الحقيقية لدى الشركات الأجنبية والمؤسسات الدولية في زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي في مصر زيادة كبيرة، لا أظن أن هذه أو تلك ستعجز عن إيجاد السبل الكفيلة بتسهيل هذا التدفق بممارسة الضغط الكافي على الحكومة، بل وتغييرها في بعض الأحيان إذا لزم الأمر. يبدو أن الأسباب الحقيقية لتعطيل هذا التدفق طوال هذه الفترة تتعلق بالمناخ السياسي السائد في المنطقة العربية.
يؤيد هذه النظرة ما حدث فجأة في صيف 2004، أي بعد عام من احتلال الولايات المتحدة للعراق، ووسط كلام كثير عن مشروعات لإقامة "الشرق الأوسط الجديد". ففي صيف 2004، حدث تغير مهم ومفاجئ في الحكومة المصرية. فقد تسلم رئاسة الحكومة د. أحمد نظيف بدلاً من د. عاطف عبيد، دون أن يقدم أحد أي تفسير لهذا التغيير. لم تكن هذه بالطبع أول مرة يحدث فيها أن يأتي وجه جديد تماماً إلى رئاسة الحكومة، فمنذ قيام ثورة 1952 اعتاد المصريون على أن يسقط رئيس للوزراء فجأة، لغير سبب معروف، ويأتي رئيس آخر للوزراء دون أن يكون هناك سبب واضح لماذا اختير دون غيره. استمرت هذه الظاهرة منذ 1952، ثم أضيف إليها بعد سقوط فؤاد محيي الدين كرئيس للوزراء في أوائل الثمانينيات، ظاهرة اختيار رئيس للوزراء لم يعرف عنه اهتمام كبير بالسياسة، ناهيك عن الانتماء لفكر سياسي معين. كان هذا شأن كمال حسن علي، ثم علي لطفي، ثم عاطف صدقي، ثم كمال الجنزوري، ثم عاطف عبيد. ولكن أحمد نظيف لم يكن حتى يتظاهر بالاهتمام بالسياسة. كان في الحكومة السابقة وزيراً للاتصالات، معروفاً بالنزاهة والاخلاص في عمله، ولكنه لم يظهر أي اهتمام بالقضايا السياسية. ربما كان هذا أحد أسباب اختياره لرئاسة الحكومة في 2004، إذ إنه جاء ومعه مجموعة من الوزراء الجدد تولوا الوزارات المتعلقة بشئون الاقتصاد، وعرفوا بتغليب اعتبارات الكفاءة الاقتصادية على أي اعتبار آخر، سواء كان سياسياً أو اجتماعياً. ولم يمض وقت طويل حتى اتضح أن الحكومة الجديدة قد جاءت لتنفيذ جدول أعمال معد سلفاً يتفق تماماً مع فلسفة" الليبراليين الجدد" في الولايات المتحدة، وفي نفس الوقت السير بسرعة أكبر في تحقيق مصالح خارجية طالب التباطؤ في تنفيذها. في ديسمبر 2004 مثلاً ظهر أن مصر قد خارت قواتها إلى حد أنها أصبحت مستعدة لاتخاذ هذه الخطوة الخطيرة: وهي التوقيع على اتفاقية الكويز مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، التي تسمح لبعض الصناعات المصرية (التي توصف "بالمؤهلة) بدخول السوق الأمريكية دون ضريبة جمركية، بشرط أن تحتوي منتجاتها على جزء من إنتاج إسرائيلي. وهكذا وضعت الصناعات المصرية تحت رحمة إسرائيل التي يمكن لها الآن تقرير أي الصناعات سوف تنمو وتزدهر وأيها سوف يتقلص ويندثر.
في سنة 2005، قفزت الاستثمارات الأجنبية الخاصة في مصر إلى ضعف ما كانت عليه في العام السابق، ثم تضاعفت مرة أخرى في السنتين التاليتين. وعندما رأى المستثمرون العرب ذلك فهموا معنى ما يحدث، فتسابقوا على الاستثمار وشراء الأراضي في مصر، وإذا بالحكومة المصرية تعلن فجأة أن الحقبة المظلمة قد انتهت، وأن عهد التنمية السريعة والمستمرة قد بدأ، وأن السبب بالطبع هو الحكمة التي تتسم بها الحكومة الجديدة بعكس كل الحكومات السابقة. وكأن كل معاناة الشعب المصري طوال العشرين سنة السابقة كانت نتيجة مجرد خطأ بسيط في اختيار شخصية رئيس الحكومة. أصبح من الواضح بعد شهور قليلة من مجيء الحكومة الجديدة أنها تتبنى في شئون الاقتصاد المبادئ الأربعة الآتية:
1- المشكلة الاقتصادية الأساسية في مصر هي انخفاض معدل نمو الناتج القومي. هذه المشكلة في نظر الحكومة الجديدة، أهم من مشكلة البطالة أو سوء توزيع الدخل، وهاتان المشكلتان سوف يتم حلهما، على أي حال، إذا نجحنا في رفع معدل النمو.
2- أفضل وسيلة للارتفاع بمعدل نمو الناتج القومي، هي تشجيع الاستثمارات الأجنبية الخاصة على المجيء إلى مصر، بالمقارنة باستثمار رؤوس الأموال المحلية، سواء كان استثماراً خاصاً أو عاماً.
3- الخصخصة، أي تحويل الملكية العامة للمشروعات القائمة إلى ملكية خاصة، سياسة ضرورية للنهوض بحالة الاقتصاد المصري، وكلما زادت الخصخصة كان هذا أفضل، بما في ذلك خصخصة المرافق العامة.
4- السبب الأساسي لسوء أداء الاقتصاد المصري خلال الخمسين عاماً الماضية هي تدخل الحكومة في الاقتصاد أكثر من اللازم، فبهذا يمكن تفسير انخفاض معدل نمو الناتج القومي، وانخفاض معدل الدخل ومعدل الاستثمار، وكذلك ارتفاع معدل البطالة. وبناء على ذلك فإنه كلما قل تدخل الدولة في الاقتصاد كان هذا أفضل.
كانت التصريحات الحكومية (وكذلك ما تتخذه من إجراءات) يعبر عن هذه المبادئ الأربعة صراحة أحياناً، وفيما بين السطور أحياناً أخرى. وبعد مرور أربعة أعوام على مجيء الحكومة الجديدة، أي قبيل مجيء خريف 2008، أخذت الحكومة تكرر توجيه التهنئة لنفسها على تحقيق الإنجازات التالية:
1- ارتفع معدل نمو الناتج القومي الحقيقي في السنتين الأخيرتين (أي في 2006/2007-2007-2008) إلى أكثر من 7% سنوياً، بعد أن كان متوسط المعدل طوال العشرين سنة السابقة نحو 4% سنوياً.
2- ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية الخاصة في السنة الأخيرة (2007-2008) إلى 11 بليون دولار بالمقارنة بـ9.3 بليون دولار عندما استلمت الحكومة الجديدة المسئولية، أي أن هذه الاستثمارات تضاعفت نحو ثلاث مرات في أربع سنوات.
3- تسارع معدل الخصخصة في السنوات الأربع السابقة، حتى جلب 8.2 بليون دولار في السنة الأخيرة.
لم يكن من الصعب على من يشك في ملاءمة سياسة الليبرالية الجديدة لمصرن خاصة في هذه المرحلة من تطورها الاقتصادي، أن يثير الشكوك في أهمية هذه الإنجازات: ففيما يتعلق بمعدل نمو الناتج القومي، لم يكن هناك أي دليل على أن ارتفاع هذا المعدل قد صاحبه أي تقدم في حل المشكلة الاقتصادية الأساسية في مصر وهي المعدل المرتفع للبطالة. لقد روجت الحكومة لنتائج مسح لسوق العمل أجري في آخر أكتوبر 2006، زعم أن حالة البطالة في مصر، وإن كانت قد تدهورت بشدة فيما بين 1988 و1998، قد أظهرت تحسناً في السنوات الثماني التالية (1998-2006). ولكن هناك أسباباً قوية تشكك في صحة هذا الزعم. فالسنة التي تقارن بها حالة البطالة في 2006، وهي سنة 1998، هي السنة التالية مباشرة لحادث الأقصر "الإرهابي" الذي أثر تأثيراً كبيراً على حالة العمالة في قطاع السياحة. والتحسن المذكور لا يشمل القاهرة الكبرى، ومن ثم قد يكون التحسن في أرقام البطالة في الريف المصري ناتجاً عن الهجرة إلى القاهرة الكبرى بحثاً عن عمل دون العثور عليه. والانخفاض المذكور في حالة البطالة من (11.7%) في 1998 إلى (8.3%) في 2006، قد يرجع جزء كبير منه إلى اختلاف طريقة جمع الإحصاءات وتفسيرها بين 1998 و2006. والأهم من ذلك أن ظاهرة البطالة في حالة بلد فقير كمصر يجب ألا يقتصر تعريفها على البطالة السافرة التي تتمثل في حال الباحثين عن عمل دون أن يكون لهم عمل على الإطلاق، بل يجب أن تشمل حالة المشتغلين الذين يعتبرون وظائفهم وأعمالهم أقل بكثير من طاقتهم أو مؤهلاتهم، والذين لم يقبوا الاشتغال بالأعمال التي يشتغلون بها بالفعل إلا بسبب اليأس من العثور على ما يليق بقدراتهم أو بمؤهلاتهم، بعد استمرار البطالة فترة طويلة.
إن أصحاب فلسفة الليبرالية الجديدة، يستندون في إهمال مشكلة البطالة إلى اعتقادهم في صحة النظرية القديمة التي تعود إلى أيام الاقتصاديين التقليديين الإنجليز، والمسماة بنظرية "التساقط (Trickle Down)، والتي تثق في حل مشكلة البطالة في المدى الطويل، طالما استمرت زيادة استثمارات وارتفاع معدل نمو الناتج القومي، على أساس أن مصير العمالة منوط بالطلب عليها من جانب المستثمرين. ولكن هذه الثقة في أن تؤدي زيادة الاستثمار وارتفاع معدل النمو إلى اختفاء البطالة تفقد جزءاً كبيراً من قوتها في ظل ظروف (كظروف مصر الحالية) يتسم فيها الاستثمار بدرجة عالية من كثافة رأس المال (أي بطلب منخفض نسبياً على الأيدي العاملة)، وبتفضيل مجالات الإنتاج من أجل التصدير على مجالات الإنتاج للسوق المحلي (وهذه الاخيرة أكثر مساهمة في تشغيل العمال)، فضلاً عن ارتفاع نسبة الواردات في إنفاق المشروعات التي تمول بالاستثمارات الأجنبية، مما يوجه جزءاً كبيراً من الطلب إلى السلع والعمالة الأجنبية بالمقارنة بالطلب على السلع وأيدي العمل المحلية.
أضف إلى ذلك أن هناك من الأسباب ما يجعل المرء يشك بشدة في إمكانية استمرار هذا المعدل المرتفع لنمو الناتج القومي (7%). بعض هذه الأسباب سياسي وبعضها اقتصادي. أما الأسباب السياسية فتتعلق بانتماء المجموعة الجديدة من واضعي السياسة الاقتصادية إلى نفس النظام السياسي الذي أدى أداء اقتصادياً بائساً للغاية في العشرين سنة السابقة. ولم يظهر ما يدل على حدوث أي تغيير في طريقة اتخاذ القرارات أو في طبيعة الممسكين بالسلطة وتطلعاتهم الطبقية ومدى استعدادهم للخضوع للمساءلة.
وأما الأسباب الاقتصادية للشك في إمكانية استمرار هذا المعدل المرتفع للنمو، فتتعلق بمصادر هذا النمو، أي توزيعه على القطاعات الإنتاجية المختلفة. فيلاحظ أن القطاعين الأساسيين اللذين يمكن التعويل عليهما في استمرار النمو المرتفع في المستقبل، وهما الصناعة التحويلية والزراعة، لم يساهما خلال الفترة (2005-2007) إلا بنسبة 27.6% من الزيادة في الناتج القومي، أي بأكثر قليلاً من الربع (كان معدل النمو 3.7% في قطاع الزراعة و7.3% في قطاع الصناعة التحويلية) بينما حدثت الزيادة الكبيرة في القطاعات الأكثر تعرضاً للتقلب والأقل مدعاة للثقة باستمرار نموها في المستقبل (كالسياحة التي ساهمت وحدها بـ13.2% من الزيادة في الناتج الإجمالي، وقناة السويس 14.9%، وقطاع التشييد والبناء (خاصة بناء المساكن) 15.8%. إن هذا التوزيع النسبي لمصادر النمو في الفترة (2005-2007)، لابد أن يذكر المرء بما حدث في الفترة (75-1982). ففي هذه الفترة أيضاً زاد الناتج الإجمالي بمعدل مرتفع (8.9% سنوياً) ولكن لم تساهم الصناعة التحويلية إلا بـ1.3% من هذا المعدل (أي بنسبة 14.6%) والزراعة بـ0.7% (أي بنسبة 7%). أي أن القطاعين الرئيسيين (الصناعة التحويلية والزراعة)، لم يساهما في تلك الفترة إلا بأقل من ربع الزيادة في الناتج الإجمالي، وهي نسبة قريبة جداً من نسبة مساهمتهما في الفترة (2005-2007). كان النمو المرتفع في الفترة السابقة (75-1982) ناتجاً أياً من قطاعات غير مضمونة، كالبترول وقناة السويس والسياحة والتشييد والتجارة. لا عجب أن معدل النمو المرتفع في الناتج الإجمالي لم يمنع من دخول الاقتصاد المصري في فترة طويلة من الانكماش، استمرت نحو عقدين، (1986-2004)، وكذلك ليس من الممكن الاطمئنان إلى أن يؤدي ارتفاع معدل نمو الناتج الإجمالي في الفترة 2005-2007 إلى استمرار النمو بعد ذلك.
أما الزيادة الكبيرة في تدفق الاستثمارات الأجنبية الخاصة، فيلاحظ عليها أيضاً أن القطاعين الأساسيين (الزراعة والصناعة التحويلية) من حيث توليد فرص العمالة، وتحفيز مزيد من النمو في المستقبل، لم يحظيا بأكثر من عشر إجمالي الاستثمارات الأجنبية الخاصة (2006/2007) إذ ذهبت 27% من هذه الاستثمارات إلى قطاع البترول، و17% لقطاع الاتصالات، بينما كانت 25% منها حصيلة "خصخصة" أي بيع أصول قائمة بالفعل دون إضافة أصول جديدة. كما يلاحظ أن الاستثمارات المتجهة إلى قطاع البترول هي استثمارات تستهدف استغلال أصول آيلة إلى النضوب، وأن جزءاً من الاستثمارات في قطاع الاتصالات اتخذ صورة قيام بعض شركات التليفون المحمول بشراء رخصة تسمح لها بالعمل في مصر، وهو "استثمار" ليس من طبيعته التكرار. أما فيما يتعلق بما أنجزته الحكومة في مجال الخصخصة، فمن الشيق أن نقارن بين ما حدث في هذه الفترة الأخيرة (2005-2007) من حيث مصادر تمويل التنمية، وما حدث في الفترة (75-1981). ففي فترة السبعينيات كانت مشروعات التنمية تعتمد اعتماداً كبيراً على القروض الأجنبية بمعدلات فائدة مرتفعة، بينما اعتمدت الفترة (2005-2007) اعتماداً كبيراً على الاستثمارات الأجنبية الخاصة، بما في ذلك بيع أصول إنتاجية قائمة بالفعل. ولكل من المصدرين حدود لا يمكن تجاوزها. فعندما تراخى الإقراض التجاري وانخفض حجمه ابتداءً من منتصف الثمانينيات، أصيبت التنمية بصدمة ونكسة شديدتين. كذلك لابد أن يكون لعملية الخصخصة نهاية، ببيع كل ما يمكن بيعه من مشروعات القطاع العام، ومن ثم من الخطأ تعليق آمال التنمية على ما يجلبه هذا البيع من موارد.
الشيء الوحيد الذي لم تفاخر به الحكومة بل حاولت أن تنفذه في صمت، آملة في ألا تلتفت إليه الأنظار أكثر من اللازم، هو تقليص ما تقدمه الحكومة من دعم للفقراء في صورة تخفيض أسعار بعض السلع الغذائية والبترول وأسعار بعض الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة. كان مبدأ الحكومة هنا، هو المبدأ الذي يعتنقه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بأن هذه الصورة المختلفة من الدعم تشوه هيكل الأسعار ومن ثم تؤدي إلى تبديد كبير للموارد وبالتالي تعطيل التنمية. ولكن هذا المبدأ يرجع إلى ما قاله الاقتصاديون التقليديون، والتقليديون المحدثون، منذ أكثر من قرن ونصف، وهؤلاء كانوا يستبعدون من المناقشة أثر هيكل الأسعار على توزيع الدخل يخضع لقرارات سياسية ليس من شأنهم هم (أي المشتغلين بالاقتصاد البحث)، الخوض فيها. فإذا افترضنا أن راسمي السياسة سوف يتخذون بالفعل القرارات الحكيمة فيما يتعلق بتوزيع الدخل، فلا شك أن ترك الأسعار حرة موقف حكيم بسبب تقليله من تبديد الموارد. بعبارة أخرى، إن ترك الأسعار حرة يكون موقفاً حكيماً في ظل نظام حكيم لتوزيع الدخل، أما إذا كان الحال غير ذلك، كما هو الحال في مصر منذ فترة طويلة، فإن ترك الأسعار حرة وإن كان يقلل من تبديد الموارد المادية فهو يزيد بشدة من تبديد الموارد البشرية، أي أنه نظام جيد للسلع ولكنه سيئ للبشر. كان الزهو بهذه الإنجازات الثلاثة (ارتفاع معدل النمو، وارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية، والإسراع بعملية الخصخصة) هو الاتجاه السائد في حديث المسئولين عن حالة الاقتصاد المصري، عند وقوع الأزمة المالية العالمية في سبتمبر 2008. بل زاد من زهو الحكومة أن السنة المالية السابقة مباشرة على الأزمة (2007/2008) شهدت استمرار معدل نمو مرتفع للناتج القومي (يزيد أيضاً عن 7%)، واستمرار الزيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية الخاصة (فبلغ 13 بليون دولار في تلك السنة) واستمرار "الإصلاح الاقتصادي"، وبالذات عملية الخصخصة، إذ قامت الحكومة ببيع شركة أو شركتين كبيرتين في كل عام من الأعوام الأربعة منذ استلامها المسئولية في 2004.
وقعت الأزمة المالية العالمية وقع الصدمة الكبيرة على الحكومة المصرية، وعلى الأخص على المسئولين فيها عن الاقتصاد. فهؤلاء كانوا يرجعون الأوجه المختلفة لنجاح سياستهم إلى جانب أو آخر من جوانب "الاندماج في الاقتصاد العالمي"، ولكن ها هو الاقتصاد العالمي يصاب بأزمة شديدة لا يعرف أحد مداها، ولا يستطيع أحد التنبؤ بموعد انتهائها. والعالم الآن، بما في ذلك العالم الرأسمالي نفسه، أصبح يتكلم بلغة هي العكس بالضبط مما كان يقولوه راسموا السياسة الاقتصادية في مصر: إذ يتكرر اللوم على الإفراط في تطبيق سياسة الحرية الاقتصادية وفي الاعتماد على قوانين السوق، ويتكرر القول بضرورة تدخل حاسم من جانب الحكومة. وزاد عدد من يتوقعون انكماشاً عاماً وتراجعاً في مسيرة العولمة، ودرجة أكبر من الاعتماد على النفس، أي الاعتماد على السوق المحلي أكثر من التصدير، وعلى الادخار المحلي بدلاً من القروض أو المعونات أو الاستثمارات الأجنبية الخاصة، وكلها اتجاهات في عكس الاتجاه التي كانت تتبناه السياسة الاقتصادية في مصر وتبشر به.
كان لابد أن نتوقع أن تؤدي الأزمة المالية إلى انخفاض في حجم الاستثمارات الأجنبية الخاصة الواردة إلى مصر، وانخفاض في قيمة وحجم الصادرات السلعية، بما في ذلك البترولية، والصادرات غير السلعية، بما في ذلك إيرادات السياحة وقناة السويس، وفي حجم تحويلات المصريين الآتية من الخارج، وكان هذا ما حدث بالفعل في نهاية السنة المالية 2008/2009 بالمقارنة بالسنة المالية السابقة. فقد انخفضت قيمة صادرات مصر من البترول بنحو 3 بليون دولار، والصادرات غير البترولية وإيرادات السياحة بنحو بليون لكل منهما، وإيرادات قناة السويس بنحو 400 مليون، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج بـ600 مليون، كما انخفضت الاستثمارات الأجنبية بنحو 3.5 بليون دولار أي بنحو الثلث. كان النقص في مجموع إيرادات مصر من النقد الأجنبي في العام الأول من الأزمة نحو 10 بليون دولار، ولكن النقص الصافي في إيرادات النقد الأجنبي (بعد خصم النقص في قيمة الواردات وهو أكثر من 3 بليون دولار) كان نحو 6 بليون دولار. كان لا بد إذن من انخفاض معدل نمو الناتج الإجمالي، وقد قدرت الحكومة هذا المعدل بـ4.8% خلال 2008/2009 بالمقارنة بـ7.2% في العام السابق بينما قدر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي هذا المعدل بـ3.6% فقط، أي بنحو نصف ما كان عليه في العام السابق.
هذه الانتكاسة في معدل نمو الناتج الإجمالي لا بد بالطبع ان تدعو للأسف، ولكننا لا يجب أن نبالغ في تعليق الأهمية على هذا المعدل، إذ إن الخلل الأساسي كان قائماً حتى في ظل معدل النمو المرتفع، ولم ينجح المعدل المرتفع (7.2%) في التخفيف منه، وهو الاختلال في الهيكل الاقتصادي وفي انخفاض نصيب القطاعات الأكثر ضماناً لاستمرار النمو، والأكثر مساهمة في حل مشكلة البطالة، في إجمالي الاستثمارات. كان لا بد أن يؤدي هذا الانخفاض في معدل النمو إلى ارتفاع معدل البطالة، ولكن ليس من الضروري أن يظهر ذلك بوضوح (أو حتى أن يظهر على الإطلاق) في الإحصاءات الرسمية، التي تعتبر أن الاشتغال بأي عمل، مهما كان منخفض الإنتاجية وحتى لو لم يتناسب البتة مع مؤهلات صاحبه وقدراته، يؤهل صاحبه لأن يندرج في عداد "العاملين".
كان لا بد للأزمة العالمية إذن أن تنبه من جديد إلى خطورة الاعتماد المبالغ فيه على "الاندماج في الاقتصاد العالمي"، وإلى أن الانفتاح على العالم، وإن كان مطلوباً لشحذ الهمة، والإفادة من مزايا التنافس، واستكمال النقص في الخبرة والتكنلوجيا، وأحياناً أيضاً لتكوين رأس المال، فإن هذا الانفتاح وهذا الاندماج في الاقتصاد العالمي لا بد أن يكون له حدود، ولابد أن يخضع لقيود واستثناءات، كلما ظهر أنه يضر بالمصلة الوطنية.
انظر أيضاً
المصادر
- ^ الهيئة العامة للإستعلامات
- ^ مصر الخالدة
- ^ الرافعي, عبد الرحمن (2009). عصر محمد علي. القاهرة، مصر: دار المعارف.
{{cite book}}: Cite has empty unknown parameter:|coauthors=(help) - ^ جلال أمين (2012). قصة الاقتصاد المصري.
{{cite book}}: Cite has empty unknown parameter:|coauthors=(help) - ^ الحكومة الفرنسية (1876-05-02). "نص قرار إنشاء صندوق الدين العام لمصر Décret d'institution de la caisse de la dette publique d'Egypte". الحكومة الفرنسية.
- ^ Text in League of Nations Treaty Series, vol. 202, pp. 98-105.
- ^ عبد الرحمن الرافعي (1939). مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية.
{{cite book}}: Cite has empty unknown parameter:|coauthors=(help)